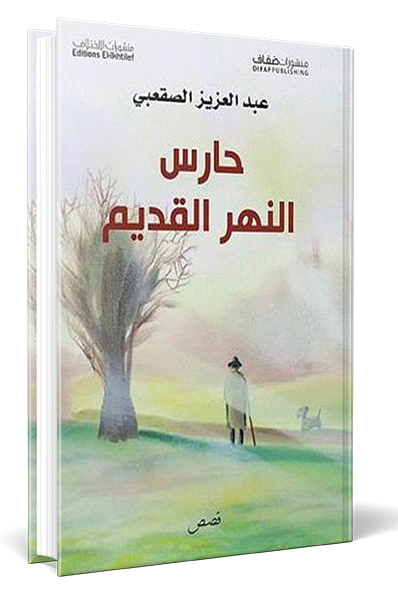بواسطة رسول محمد رسول - ناقد عراقي | مارس 1, 2020 | كتب
في سنة 1957م صدر في باريس كتاب جورج بتاي «الأدب والشر»، وهو كتاب سجالي نقدي يتناول، عبر مدخل وثمانية فصول، ثماني شخصيات أدبية غربية ساهمت بصناعة المشهد الأدبي والفكري هي: إيميلي جين برونتي (بريطانية)، وشارل بودلير (فرنسي)، وجول ميشله (فرنسي)، ووليم بليك (إنجليزي)، وماركيز دي ساد (فرنسي)، ومارسيل بروست (فرنسي)، وفرانس كافكا (تشيكي)، وجان جينيه (فرنسي). تجدر الإشارة إلى أن «الأدب والشر»، ترجمهُ إلى لغة الضاد حسين عجّة (2019م) في طبعته الثانية، وصدر في بغداد عن دار سطور بواقع 224 من القطع المتوسِّط.
وإذ يعود كتاب جورج بتاي (1897 – 1962م) إلى خمسينيات القرن العشرين فإنما يعلّمنا الكيفية الحرة التي يصطفي بها كاتب ما مثل بتاي موضوعة حيوية كالشر ليستعرض معطياتها لدى عدد من الكتاب الكبار الذين نقرأ لهم في حياتنا، استعراض الخبير الذي يلج النصوص بجرأة نافرة تعوّدنا صوتها النقدي عند جورج بتاي في غير كتاب له وجد طريقه إلى العربية، ولا سيما خلال السنوات الخمس الماضية منها، كتاب «الإيروسية» وكتاب «التجربة الداخلية».
في هذا الكتاب أفنى الأستاذ حسين عجّة وقته بترجمته عبر لغة رشيقة رغم عسر معجمية جورج بتاي عندما يكتب، لكن من الواضح أن عجّة بذل جهدًا رائعًا في نقل هذا الأثر النقدي السجالي إلى لغة الضاد. يعترف بتاي في «المدخل» بأن هذه الدراسات التي يضمها هذا الكتاب «فرضت عليه تماسكها وهي مكتوبة من جانب رجل بالغ»، لكنه يستأنف فيقول: «إنها ترجع إلى صخب الشباب؛ بل هي الصدى الصامت لتلك الفتوة». وفي هذا السياق، يعترف بتاي بأن «الأدب هو الجوهري» وكذلك هو «التواصل»؛ بل أكثر من ذلك يعتقد أن «الأدب ليس بريئًا، بل هو مذنب»؛ فهل يحق للأدب بوصفه مذنبًا الدفاع عن نفسه؟
كم ترانا بعيدين عن إيميلي جين برونتي التي ولدت في 30 يوليو 1818م وتوفيت 18 ديسمبر 1848م، وعاشت عمرًا قصيرًا لم يتجاوز ثلاثين سنة لكنها قالت خطابها بما راق لبتاي الذي وجد أن «أخلاقها النقية لا تشوبها شائبة»؛ بل إن خطاب برونتي «ينطوي على تجربة عميقة إزاء الشر»، فلم «يكن في ذهن برونتي عالمًا مستقرًّا». ويقف بتاي عند المعنى الأخلاقي للتمرّد «تمرّد الشر ضد الخير»، ويميل بتاي إلى إرساء مفهوم التراجيديا في قراءته لبرونتي؛ «فلا يمكننا الحصول على بهجة الحياة إلا عبر رؤيته التراجيدية».
أزهار الشر
إلى شارل بودلير، وتحديدًا إلى تجربته في ديوان «أزهار الشر» هذه التجربة التي حملته إلى المحاكم؛ إذ يعتقد بتاي أن «عنصر الشر واضح تمامًا في أعمال بودلير»، ويجادل بتاي جان بول سارتر الذي كان تناول بودلير في كتاب له، ولا سيما أن الفيلسوف الوجودي «يربط من دون قصدية المشكلة الأخلاقية بمشكلة الشعر»، وبودلير – بحسب تعبير بتاي – هو «الإنسان الذي لا ينسى نفسه»، يأتي ذلك في ظل نقد حاد يكيله بتاي إلى قراءة سارتر الذي «يخطئ في التأويل الملتبس الذي يقدّمه عن تجربة بودلير»، لكن بتاي يعترف بأن ديوان «أزهار الشر» «ينطوي على ما يبرر تأويل سارتر الذي قال: إن بودلير كان مهمومًا في أن تكون حياته سوى الماضي»، ولا سيما أن هذا الشاعر وعندما كان طفلًا تراه «مشدودًا جسدًا وقلبًا إلى أمه».
إلى ذلك، يربط بتاي تجربة الشر لدى بودلير بالعالم التاريخاني الذي يحيطه: فلا «يعبّر التوتر الذي لا مثيل له لبودلير عن ضرورة فردية وحسب، وإنما نتيجة لتوتر مادي مُعطى تاريخيًا من الخارج» ما يعني أن تجربة «أزهار الشر» تتجاوز «اللحظة الفردية» التي لا يغادرها الشر ولا التعبير عنه. ولنا نحن أن نتأمل متسائلين: هل للشر أزهار؟ كم مرّة علينا قراءة هذا الديوان؟
وبعد ذاك يأخذنا بتاي إلى ميشله وكتابه «الساحرة» الذي جعل ميشله ذاته من الذين «يتكلمون بطريقة إنسانية للغاية عن الشر»؛ بل بطريقة إن هي إلا فرصة لبتاي نفسه لكي «يطرح مشكلة الشر عقلانيًّا»، وميشله كان قد «منح العالم الذي تصوّره أكثر من خاصية التمرد».
وليم بليك
الشاعر وليم بليك «لم يكن مجنونًا، كان يقف عند حدود الجنون»، لكن بتاي يستأنف فيقول: «إن الإنسان الحقيقي، أي: العبقرية الشعرية، هو المنبع». وما هو لافت، يقول بتاي: «عن الدِّين ما هو إلا نتاج للعبقرية الشعرية، ولا يوجد شيء في الدِّين لا ينطوي عليه الشعر»، ويؤكّد بتاي أن «فضيلة بليك تكمن في تعريته للشكل الفردي للدِّين والشعر، وفي ذلك منحهما من جديد ذلك الوضوح الذي سينعم بفضله الدِّين بحرية الشعر، والشعر بالقوة السياسية للدِّين». ويستعين بتاي بكارل يونغ في تحليلاته السيكولوجية عندما يتحدّث عن الميثولوجيا التي اشتغل عليها بليك؛ إذ يعتقد بتاي أن الشعر في أصله «تنهد القيود»، وهذا ما يقودنا إلى «التمرّد» في العالم الذي نعيش، وتكمن قراءة الأمل لدى بليك في «عدم اختزال العالم»، وهو ما يتطلّب «اليقظة الأبديّة» التي تنتج متعة أبدية، لهذا يقول بتاي: إن «غبطة الحواس تشكّل حجر الزاوية في حياة بليك».
العنصر الملعون
إلى الماركيز دي ساد يأخذنا بتاي عبر نخبة من كتّاب ونقاد مروا على تجربته الأدبية والجمالية من دون إغفال «الطابع التحريضي» الذي تتسم به حياة ساد وأعماله الذي «تكمن جوهر أعماله في رغبته في التدمير»؛ بل إن «العنصر الملعون هو في الواقع ما كانت تبحث عنه أعماله»! ومعروف عن ساد أنه ما كانت لديه أيّة تحفظات ولا صرامة قد تسمح باختزال حياته إلى «مصاف مبدأ ما». وكنا قرأنا من ذي قبل كتابة بتاي عن ساد في الكتاب الأول عن الإيروسية وعلى نحو مستفيض لكننا ههنا نقرأ عن لعبة الشر التي تقبع في ساد وانفرط عقدها في كتاباته التي ظلّت تحتفي بما يسميه بتاي «الهيجان» أو «الألم المنشود» أو «الهتك» أو «التحريض» أو «الخلاعة والعري» أو «الرذيلة» أو «مستنقع البهيمية» أو «العربدة» أو عمومًا ذلك «الدافع الإيروسي بوصفه انهدادًا أو انحطاطًا أو تعذيبًا أو تدميرًا».
بروست وكافكا
ليس بعيدًا من ماركيز دي ساد نذهب مع بتاي إلى عوالم مارسيل بروست وفكرة «الفحولة» التي أوصلها لنا بوصفها «تجربة حياة إيروسية» منحها بروست «هيئة مفهومية» عبر مفهومات عدّة منها: «الشعور بالتدنيس»، و«تدنيس الأم»، و«الأمهات المدنّسات». وفي هذا السياق يؤكّد بتاي أنه «مثلما يكون الهلع معيارًا للحب يكون العطش للشر معيارًا للخير»؛ بل يؤكِّد أنه «ومثلما كان أكثر حذاقة من ساد كان بروست المتلهف للمتعة قد ترك لنزعة الشر ذات اللون الكريه للإثم ونفس إدانة الفضيلة».
ولا ينتهي الشر في الأدب عند هذه التجربة، إنما نجده عند العبقري كافكا، لكن بتاي يركّز قراءته في الجانب الطفولي لدى كافكا، ويميز بتاي بين كل من الجانب الاجتماعي والجانب العائلي، وكذلك الجانب الجنسي والجانب الديني في كتابته عن كافكا.
يعود بتاي، مرّة أخرى، إلى جان بول سارتر ليضفي على فصول كتابه هذا قدرًا من السجال عندما يتحدّث عن جان جينيه، لكنه وبصدد كتاب سارتر عن جينيه يقول: «يكرّس سارتر لشخص ومؤلف كتاب «يوميات لص» – وهو نص جينيه – يكرس عملًا طويلًا» تحت مسمى «القديس جينيه» ولا سيما أن هذا العمل يعد «واحدًا من الأعمال النادرة والجديرة بالاهتمام» وسط اعتقاد سارتر بأن هذا الكتاب إنما «يعبر فيه جينيه عن نفسه»، ذلك أن ثمّة كرامة في الأمر، والكرامة المقصودة لدى جينيه هي «المطالبة بالشر»، قال سارتر: «إن تجربة الشر هي كوجيتو باذخ يُظهر للشعور تفرّده بإزاء الكينونة». وتراني ههنا أعتقد أن عبارة مثل هذه هي التي خلبت لب بتاي وهو يهم بالكتابة عن جينيه ليتحدّث عن السيادة وقدسية الشر، وكذلك عن الانزلاق نحو الخيانة والشر المنفر، ومن ثم مأزق الخرق اللامحدود، كذلك عن التواصل المستحيل، وتاليًا عن إخفاق جينيه، والحرية والشر. يبدو هذا الفصل الذي يختم به بتاي كتابه هو الأكبر والأكثر سلاسة.
أخيرًا، وأنا أقرأ فصول هذا الكتاب، وجدت نفسي أشعر بلذة القراءة، والأكثر من ذلك أهمية هذا الكتاب وهو يلامس مشكلة الشر لدى هذه النخبة الرفيعة من المبدعين. ولعل الأجمل في هذا الكتاب سلاسة الترجمة التي يقدّمها لنا «حسين عجّة» خبيرًا متمرسًا، فطوبى لك مترجمًا وأنت تقدّم متن هكذا كتاب إلى القارئ العربي.

بواسطة رسول محمد رسول - ناقد عراقي | يوليو 1, 2019 | كتب
لعلّه من حُسن طالعي أنني توافرت في هذا العام (2019م) على قراءة مؤلَّفين غير شعريين للشاعر الفرنسي شارل بودلير (1821 – 1867م) وقد ترجما للعربية، هما كتاب «الفراديس المصطنعة» وهو نص يعود إلى سنة 1851/ 1860م، وكتاب «ما بعد الرومنطيقية» الذي يعود نشر بعض فصوله إلى سنة 1863م، ومن ثم جُمعت فصوله تحت عنوان «الفن الرومنطيقي»، ونُشرت سنة 1868م بعد وفاة بودلير بسنة واحدة، ومن ثم نُشرت سنة 1885م أيضًا، وترجمها إلى العربية الدكتور كاظم جهاد تحت عنون: «ما وراء الرومنطيقية.. كتابات في الفن» لتصدر هذا العام 2019م عن مشروع كلمة للترجمة.
ولعلّ ما هو رائق في فصول هذا الكتاب الأخير، ولا سيما القسم الثاني الذي جاء بعنوان «رسّام الحياة الحديثة»، وتحديدًا في المقال الرابع فيه نقرأ عنوان «الحداثة»، كان بودلير نشر مفاصله في شهري نوفمبر – ديسمبر 1963م، وتبقى له أهمية كبيرة في تأريخ فلسفة الحداثة أقول: «فلسفة الحداثة»؛ لأن بودلير الشاعر يكتب عن الفن، هذه المرّة، وهل يوجد إطار أجمل من الفلسفة يجد فيه الفن شأنه ومتعته؟
الرسّام «ك. غ»
لكننا، ولأجل فهم الأرضيّة التي يسوق فيها بودلير فهمه للحداثة والحداثي، لا بد أن نعود إلى القسم الثالث الذي جاء بعنوان «الفنان بصفته إنسانًا في العالم وفي الحشود وطفلًا»؛ ففيه يبلور بودلير- الشاعر رؤيته لشخص الفنان الحداثي وللحداثة عبر نماذج من الفنانين التشكيليين أو الرسّامين والنحاتين، ومنهم أحد الفنانين المعاصرين لبودلير وهو كونستانتان غي (1802– 1892م) الذي يصفه بودلير بأنه «العاشق الكبير للحشود وللوجود الغفل»، ذاك الذي «يدفع فرادته إلى حدِّ التواضع» (ص 187)، فهذا الفنان كان قد قام هو ذاته «بتربيته الشخصية بلا ناصح»، وصار «على شاكلته الخاصّة مُعلمًا قديرًا» (ص 188)، ومن جهة كان «كثير الأسفار وله طبع رحالة»، وعندما اهتديتُ إلى مقابلته، يقول بودلير: رأيتُ، أول الأمر، أنني لم أكن أمام فنان؛ بل أمام ابن للعالَم» (ص 189)، بالمعنى الإنسي أو بدلالة مواطن المعمورة بكاملها، ولا سيما أن «كل أعماله إنما هي ممهورة بروحه الساطعة» (ص 186)، ولذلك يصرّ بودلير أن يصف كونستانتان بأنه «مواطن المعمورة الذكي» (ص 189). وكان هذا الفنان بين الحشود والناس ما يعني أن «حب الاستطلاع يمكن اعتباره نقطة انطلاق عبقريّته» (ص 189). ومثل هذا الشخص يبدو «الفضول عنده شغفًا محتومًا ولا يُقاوَم»، ويبدو أيضًا أن هذا «يمثل مفتاحًا لشخصية السيد غي» (ص 190). وإذا كان بودلير مهتمًّا في كتابه «الفراديس المصطنعة» بملفوظ «الطفل العبقري» وملفوظ «أشجان الطفولة»، فإننا نراه وهو بصدد تحديد ملامح الفنان الحداثي يتكلم عن العبقرية بوصفها «الطفولة المستعادة عن إرادة»، وهنا يتساءل: «هل من حاجة للقول: إن هذا الطفل (غ) هو اليوم رسّام شهير؟»، ليرجونا أن نعدّ السيد (غ) «رجلًا – طفلًا أو رجلًا يمتلك في كل دقيقة عبقرية الطفولة، أي: عبقرية لم يخبُ في نظرها وهج أي من مظاهر الحياة» (ص 191).
غندور أخلاقي
كان القديس أوغسطين (354 – 430 م) يقول: «أنا أُحبُّ أن أُحب». أما السيد (غ) فيمكنه حقًّا أن يقول: «إنني بالشغف لمشغوف»، وبذلك فإن هذا الفنان الحداثي أو الغندور الأخلاقي يمتلك «فن أن يكون صادقًا بلا إضحاك»، هذا الفنان كاد بودلير أن يطلق عليه وصف «فيلسوف» لولا «محبته المفرطة للمرئيات والملموسات المكثفة في حالتها التشكيلية تلهمه نفورًا نسبيًّا من كل ما يصنع العالم غير الملموس للمفكّر الميتافيزيقي؛ فلنختزل إذن السيد (غ) في فئة مصوِّر أخلاقي خالص» (ص 192)، ولكن من دون أن نحسبه فيلسوفًا يحتفل بالمُجرّدات العقلية فقط وهو الغارق في غنائه بالمرئيات والمحسوسات اللونية.
مع الفنان الحداثي تعد «الحشود وسطه الطبيعي كما أن الهواء هو وسط البلبل والماء وسط الأسماك» (ص 192). لكننا لا ينبغي لنا فهم «الحشد» ههنا بمعناه التابعي الأيديولوجي الرعاعي، إنما الأفقي المتعلّق بالوسط الإنساني النظير أو «الاقتران بالحشود» من دون توظيف أيديولوجي، ولذلك يقول بودلير: إن الفنان الحداثي بوصفه متسكعًا مكتملًا يجد «متعة هائلة في الإقامة وسط الكثير والمتموّج والمتحرّك والعابر واللامتناهي» (ص 192) ليبحث عن سره الإنساني وعبقريته الجمالية.
الشعري في التاريخي
هكذا هو الفنان الحداثي، إنه «يمضي، يعدو، يبحث، ويا ترى عمَّ يبحث؟». يتساءل بودلير ويرد في الآن ذاته قائلًا: «لا شك أن هذا الإنسان، كما وصفتُه، هذا المتوحِّد الذي يتمتّع بمخيلة فعالة، المسافر دومًا في صحراء الرجال الكبيرة، إنما يملك هدفًا أسمى من ذاك الذي يمكن أن يمتلكه متسكِّع محض، هدفًا أكثر شمولًا، ولا جامع يجمعه بالمتعة العابرة للظرف. إنه يبحث عن الحداثة la modernité. وما يهم هذا الإنسان هو أن يستخلص من الموضة la mode الجانب الشعري de poétique الذي يمكن أن تنطوي عليه داخل التاريخي l’historique، وأن ينتزع الأبدي من المؤقت» (ص 196).
في ضوء ذلك، ورغم التخصيص الذي اختاره بودلير لبيان فهمه للحداثة الفنية عبر أنموذج الفنان (غ)، وهو فنان تشكيلي، نراه يعتقد أن «الحداثة هي المؤقت والعابر والعَرضي، إنها نصف الفن الذي يتمثل نصفه الآخر في الأبدي والثابت. لقد كان لكل رسّام قديم حداثة» (ص 196). وهكذا تُزاوج الرؤية البودليرية بين النسبي والمطلق أو الأبدي والثابت، فلا يستطيع تجاوز الثابت؛ إذ «لكل حقبة زيها ونظرتها وابتسامتها» وهو ما يشكِّل «كُلًّا كامل الحيوية» (ص 196)، وهذا هو المطلق الذي يعنيه بودلير ولكن ليس بدلالة المطلق الميتافيزيقي أو الماورائي صاحب السطوة والهيمنة الذي لا يمكن أن نعطيه أهمية من دون التاريخي أو «هذا العنصر الانتقالي والعابر ذا التحوّلات الشديدة التواتر» (ص 196)، وهو ما يُبحر فيه الفنان الحداثي ليحقق المعادلة بين ما يراه ويلمسه ويشمه على نحو نسبي وما يتأمله عبر طاقته التجريدية على نحو مطلق ولكن غير المنفصم عن المحايث.
إن الفنان الحداثي يبحث عن البصمة «بصمته» وعن الدمغة «دمغته»، وينبغي له «استخلاص الجمال الغامض الذي تبثه الحياة الإنسانية على نحو غير إرادي» (ص 197). وإن فرادة الفنان الحداثي إنما تأتي من «الدمغة التي يطبعها الزمن على أحاسيسنا» (ص 199). لكل إنسان دمغة في وجوده يطيعها على جبين الحياة ويمضى.

بواسطة رسول محمد رسول - ناقد عراقي | يناير 28, 2018 | كاتب وكتاب, كتب

إيريك إيمانويل شميث
اختار الروائي والكاتب المسرحي الفرنسي من أصول بلجيكية «إيريك إيمانويل شميت» في مسرحيته «خيانة آينشتاين» لتناول حياة عالِم الفيزياء الألماني الأصل الأميركي والسويسري الجنسية ألبرت آينشتاين (1879 – 1955م)، الذي هرب من جحيم النازية إلى فضاء الحرية الأميركية لكنه صار تحت سطوة عين الرقيب المخابراتي الأميركي الذي وضع آينشتاين ككينونة مُهاجرة غير مريحة في وقت كانت المؤسسات المخابراتية الأميركية على إدراك عال لأهمية هذا الفيزيائي العِلمية التي قد يستغلها الروس لصالحهم ويستخدمون خبراته ضد المعسكر الأميركي الرأسمالي، وكانت تلك الشكوك الفاسدة موضع إزعاج لآينشتاين ذاته لكنه أمسى ذاك الذي لا حول ولا قوة له فهو المهاجر الذي استبدل الرمضاء بالنار رغم أن آينشتاين كان في سنة 1921م قد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء، لكن هذا المنجز العِلمي لم يشفع له أمام العين المخابراتية الأميركية التي كانت تلاحقه في مرحلة حرجة قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية بقسوة رغم أنه أبدى إخلاصه العلمي لوطنه البديل.
تتضمن المسرحية ثمانية مشاهد يشترك فيها «آينشتاين» نفسه، وشخص أميركي أسود «المشرَّد»، ومخبر من (FBI) اسمه «أونيل»، وامرأة تدعى «هيلين دوكاس» لم تظهر إلّا في آخر المشهد الختامي بطريقة فجائية غامضة، وتدور أحداثها قبل الحرب العالمية الثانية نحو سنة (1934م) لتستمر بعدها بسنوات في مدينة «نيوجرسي» بالولايات المتحدة الأميركية التي كان يقطنها آينشتاين.
أميركا الرمضاء
قدم «شميت» بطل مسرحيته آينشتاين على أنه ذلك العالِم الألماني القادم إلى الولايات المتحدة الأميركية هربًا من نازية هتلر، آينشتاين اليهودي الأشكنازي أُمًّا عن جد، لكن شميت لم يركِّز على ذلك الأصل العرقي كثيرًا إنما ظل، وفي أثناء المشاهد الثمانية، يحرص على بيان شخصية آينشتاين بوصفها هدفًا تحت رقابة الاستخبارات السرية الأميركية (FBI)، وجعل من شخصية «أونيل» الشخصية التي تضطلع بالمراقبة ليس بعيدًا من شخصية «المتشرِّد» الذي كان يواجه أسئلة من مثل: «هل انتقد آينشتاين الولايات المتحدة؟ هل تحدَّث حديثًا شيوعيًّا؟»، ومن ثم كان الرقيب يخبر المتشرِّد «أن آينشتاين يريد تلويث الولايات المتحدة بنقلهِ سُمّ الشيوعيَّة. إنه خائن يخدم الحمر»، وكذلك يقول له عن الألمان: «إن يهوديتهم تخفي طبيعتهم»، ومن ثم يقول للمتشرِّد: إن آينشتاين «ألماني، والألماني يبقى ألمانيًّا» كما أن ارتباطه «بالولايات المتحدة غير واضح، فهو لم يعلن حبه لوطننا قط». لعلَّ هذه التوضيحات التي ينقلها أونيل إلى المتشرِّد كفيلة بجعل آينشتاين في مراصد دوائر المخابرات الأميركية السرية له وهو الشخص غير العادي من حيث مكانته العلمية ولا سيما نيله لجائزة نوبل، وهو ما يكشف مستوى الرذيلة التي تمارسها هذه الدوائر المخابراتية بإزاء إنسان لاجئ هرب من جحيم النازية العنصرية إلى فضاء بلد يُعرف بالحرية، لكن «شميت»، وفي هذه المسرحية، يسلِّط الأضواء ساطعةً على زيف هذه الحرية التي يُحاصَر فيها العُلماء والمبدعون والمثقفون من دوائر مخابراتية. في أثناء هذه المسرحية يسعى «شميت» إلى استجلاء طبيعة خطاب آينشتاين المفكِّر والعالِم والإنسان، فهذا الأخير يقول للمتشرِّد: «لا ينبغي للرجال أنْ يقتل بعضهم بعضًا»، و«لا أريدُ أن تقع حرب»، وقوله: «أنا أفضِّل المفاوضات والسمو الأخلاقي على الحرب»، وفي معرض حديث المتشرِّد عن إحراق كتب آينشتاين وسط ساحة عامة في وطنه ألمانيا، كان جوابه: «هتلر لن يتمكَّن من إحراق الفكرة؛ لأن الفكرة هي النار نفسها».
لقد كانت هذه هي مبادئ آينشتاين قبل أن يتورَّط ويقترح معرفته النووية على «فرانكلين روزفلت» لصناعة القنبلة الذريَّة، أما بعد انفلاق القنبلة الأميركية الصنع على مدينة «هيروشيما» اليابانية، أخذ يعبِّر عن ندمه، ويبث إلى المتشرِّد شكواه وأفكاره الأخلاقية في لحظة حرجة لم يمر بها في حياته، فهو يعترف له بأن «أميركا ربحت الحرب لكن الإنسانيَّة خسرت السلام، فيا لها من خيانة! أعْددنا القنبلة لمقاومة الألمان وها هو ترومان يلقيها على اليابانيين»؛ ولذلك «تسبب هاري ترومان في أكبر مجزرة في التاريخ» -عندما أمرَ بإلقاء القنبلة الذرية في أغسطس 1945م على مدينة هيروشيما- ويدافع عن نفسه قائلًا للمتشرِّد: «لم أخترع القنبلة النووية، ولم ألهمها؛ لم تكن معادلاتي تقصد الكارثة، كانت أبحاثي نظرياتٍ خالصةً، أعمالًا فيزيائيةً قاعديةً».
وفي الوقت الذي اقترح فيه آينشتاين على «روزفلت» أن هتلر سينتج قنبلة نووية، نراه يندم على ذلك حتى يقول: «أنا لا أحمِّل نفسي شيئًا واحدًا، إني راسلت روزفلت؛ لأني علمتُ أخيرًا أن الألمان لم يكونوا متفوِّقين كما كنّا نعتقد. ولو كنتُ أعلم أن النازيين سيخفقون في صناعة القنبلة النووية، ما كنت لأتكلَّم، كنتُ أجهل أن هتلر ثبط العُلماء متخلِّيًا عن البحث النووي». وفي لحظة ندمٍ يداهم آينشتاين البكاء، فيقول: «لم أفعل شيئًا لكن لن أسامح نفسي». وصار يعتقد، كما قال سابقًا بأن «لغز البشر دنيء»، ليكرر قوله: إن «الشر بشري وليس إلهيًّا. ومن الآن فصاعدًا أصبحت للإنسان الوسائل ليدمِّر نفسه ويفني كُل مظاهر الحياة»، ولاحَ تشاؤمه أكثر عندما قال: «أصبحت نهاية الثقافات المتعدِّدة حروبًا عالميَّة، ومعسكرات للاعتقال، وقنابل نووية وهيدروجينية لم تصْنَع غير الموت». ويعترف للمتشرِّد بأنه أصبح له ضحايا بمئات الآلاف بل الملايين في الغد القادم، ستفوح منها رائحة الجثث المتحلِّلة. وأخذ يجلد نفسه ندمًا بقوله: «أنا أَحَد أكبر المنتجين للنفايات على هذه الأرض»، ولهذا كان يحلُم بذلك اليوم الذي «تتخلَّص فيه البشرية من العنف والخوف.. ويجب تجريد العقول من أسلحتها قبل أن نجرد الجنود من أسلحتهم». لينتهي إلى وصف نفسه بأنه «ملاك طوعي وشيطان على الرغم منه».
غريب الدار
في خضم ذلك، راح يدعو إلى توقيع «نداء للسلام»، وهو ما كان يثير دوائر المخابرات الأميركية حتى إن «أونيل» أوصى إدارته بضرورة الاستمرار في مراقبة هذا النزيل الألماني في الدِّيار الأميركية، وأوصى بأن «يخضع إلى مراقبة عالية، يخضع كُل شيء؛ بريده، نفاياته، مُكالماته، زواره، لا نترك أيَّة تفاصيل جانبًا. لقد بدا هذا الفيزيائي الألماني غريب الدار في نيوجرسي، بدا مهاجرًا يعيش ألم الخديعة التي كرهها؛ بل الغباء الذي تجنبه في حياته فسقط في حبائله حتى إن المتشرِّد صار يقارن نفسه به لينتهي إلى نتيجة مُعاكسة عندما قال لآينشتاين: «في الواقع أنتَ المتشرِّد، وبلا جذور، وبلا هويَّة، والغريب من كُل مكان». لقد اعترف آينشتاين بالخيانة، خيانته للإنسان والإنسانية لا خيانته لألمانيا أو أوربا أو أميركا؛ فقد كان في موضع المغدور به عندما استمع إلى زملائه العُلماء بأن يقترح على سياسيي أميركا وعسكرييها بضرورة صنع قنبلة ذريَّة قبل أن يحوزها هتلر، لكنه لم يكن يعْلم أن هتلر عزف عن صناعة القنبلة، فصار الأمر إلى أميركا التي استخدمتها لا لقتل ألمان هتلر، كما ظن هو غباءً، إنما لقتل اليابانيين ليؤكِّد قوله: «إن أميركا ربحت الحرب لكن الإنسانية خسرت السلام، يا لها من خيانة! أعددنا القنبلة لمقاومة الألمان وها هو ترومان يلقيها على اليابانيين!». لقد صدرت رواية «خيانة آينشتاين» بالفرنسية عام 2014م، ووجدتْ طريقها إلى العربية مؤخرًا بترجمة «سعيد بوكرامي» لتصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «سلسلة المسرح العالمي/ العدد 388» بالكويت، بمراجعة الدكتورة نادية كامل، وتقديم الدكتور محمد شيحة.
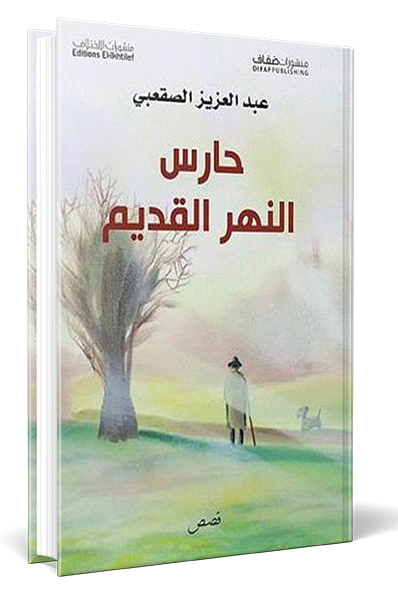
بواسطة رسول محمد رسول - ناقد عراقي | ديسمبر 27, 2016 | كتب

عبدالعزيز الصقعبي
في مجموعته القصصية التاسعة «حارس النهر القديم»، الصادرة عن منشورات ضفاف في بيروت ومنشورات الاختلاف في الجزائر، يأخذنا الروائي والقاص السعودي «عبدالعزيز الصقعبي» إلى مسارات تسريد عوالم ما تعيشه الذوات البشرية في حِلّها وترحالها، في حضورها وغيابها، حضور الآخرين فيها وغيابهم.
تضم هذه المجموعة التي تقع في أربع وستين صفحة من القطْع المتوسط، أربعة عشر نصًّا قصصيًّا قصيرًا، هي: الباب الموارب، جرح، شوق، غبار، قافلة الكلمات، ورد حجري، التنين يحترق من الداخل، بقعة صوت، تفاحة، حارس النهر القديم، حكاية عشق، رغبة خاصة، سبات، هم. وهي عنوانات تتأرجح بين معناها المعجمي والشعري، أو المركب بدلالته الشعرية المنزاحة عن المعنى المعجمي كما هي الحال في العناوين الآتية: قافلة الكلمات، ورد حجري، بقعة صوت. أما عنوان المجموعة «حارس النهر القديم» فهو عنوان القصَّة العاشرة في هذه المجموعة.
في قراءتي الأولى والثانية لهذه المجموعة القصصية، وجدت نفسي بإزاء كتابة دافئة يحدوها الحنين إلى عالم الطفولة؛ هذا الحنين الذي سرعان ما نجده مسرودًا في القصَّة الأولى «جرح»، وهو عنوان بدا عاملًا سرديًّا مولِّدًا لمبنى القصَّة الحكائي، الجرح الجسمي كما بدا جراء شج رأس طفل: «ماذا عساه أن يفعل هذا الطفل ابن السابعة بحجر قذفه طفل آخر فشج رأسه وأدماه؟» (ص 9).
هذا السؤال سيتواصل مع أثر الجرح في الطفل والأب والأم، في الراهن والمستقبل، وهي عوامل مُشاركة في حكاية القصَّة، سيتحوَّل الجرح الذي جاءت موجوديته كحادث في مدينة الطائف، سيتحوّل إلى «علامة بالرأس بقيت سنوات طويلة» (ص 10)، لكنه سيتحوَّل أيضًا إلى قيمة تأريخية، بل كونها دالة على أحداث موضوعية تبدو أكبر من مجرَّد جرح جسمي ابتلي به رأس طفل.
في قصَّة «شوق» يعود الناصّ (Textor) = عبدالعزيز الصقعبي، إلى الطفولة ثانية حيث «ذاكرتي تنبض بالطفولة» (ص 11) كما يقول الراوي بضمير المتكلِّم، وكذلك الملفوظ الإخباري: «كنتُ طفلًا وكانوا يتحدثون عن أجمل نساء الحيس» (ص 12). ومرة أخرى يحضر عالم الطفولة في النَّص ذاته حيث اسم المرأة، موضوع الشوق، مكتوب بالذاكرة من دون أن يُمحى حتى يستعيد وجوده بعد حين ليسأل الناص بضمير الغائب: «هل يتجرأ ذلك الطفل ويقول لتلك المرأة: كم أنت رائعة أيتها العزيزة؟» (ص 12).
في نص «ورد حجري» ترد الطفولة بملفوظات حكائية مسردة: «كنتَ أنت الطفل حينها..» (ص 18)، ومن ثم: «ذلك الذي غادر أرضًا وطئتها أقدام أطفال يلعبون» (ص 18). إن حضور الطفولة المسرودة تضفي على حكائية هذه المجموعة طابع البراءة، لكنّها البراءة غير العابرة حتى لتبدو علامة ثاوية في نفس الناص وذاكرته التي تموج بالكثير مما راح ينجلي مسرودًا بعد حين.
في عمق الطفولة يوجد الغياب الذي تسعى مسارات السَّرد في هذه المجموعة إلى استحضاره عبر استذكار بعض الصور المتعلقة به. في «الباب الموارب» نجد الأب ذلك الذي رحل (ص 7)، وفي «جرح» نقرأ عن «الجرح القديم» (ص 10)، وفي «شوق» نقرأ عن «الذاكرة التي تنبض بالطفولة والتوق» (ص 11)، ومن ثم تساؤل الراوي الشريك في الحكي بلسانه عن «الشوق الذي يكبلني من ذاكرتي ليتجه سنوات إلى الوراء..» (ص 12). وفي «حارس النهر القديم» يتوق «أبو سيل» إلى نهره المتدفق وقد طمرته حداثة المدن، يتوق إلى والديه اللذين جرفهما سيل النهر فماتا، وما حراسته للنهر المتهالك سوى استعادة للغائبين ربما وهمًا لكنّه الانتظار المثقل بالأسى. وفي «رغبة خاصة» يستشعر الراوي العاشق غياب الحبيبة تحت سطوة الأمنيات: «فقط.. هي أمنيتي بأن نتحدَّث..» (ص 40). وفي «ورد حجري» يخاطب الراوي ذاته مخاطبًا إياها عن أمس مضى في ظل سطوة الرغبة الجامعة بالتواصل مع الآخر المفتقَد إليه دومًا، وتلك عذابات الذات المنعزلة التي تستشعر الغياب بحساسية مفرطة الحضور.
تتضح الكتابة في مجموعة «حارس النهر القديم» مدارًا كثير التكرار، وذلك موئل يدفعك إلى التوقف عنده؛ ففي «ورد حجري» يخاطب الراوي ذاته عن أمس مضى، يخاطبها قائلًا: «ها أنتَ أكتبك.. ألونك بألوان مسخت إلى الرمادي.. كم أنت مسحوق فدعني ألملم بقاياك وأشكِّل منها مدينة حلم جديد» (ص 18). هذا يعني أن الكتابة هنا هي تشكيل وجودي قد يستحضر الماضي على نحو مبدع وخلاق لكنّه يبقى الأثر الجديد الذي يمكن أن يكون معادلًا للغياب صوب الحضور الذي يأمله الناص/ الراوي وهو يعيد ذاته عبر التذكر، ففي «ذات مساء»، يقول الراوي: «حلمتُ بامرأة.. تقرأ نصًّا كتبته.. تسخر من كلمة قلتها.. تقرأ عليَّ مَقاطعَ شعرية.. لها.. لكل من أحب، امرأة.. لي… لكل من غادرته النساء» (ص 20).
تبدو الكتابة ههنا استعادة وجودية، ورغبة مأمولة، وهمًّا وجوديًّا، فالراوي في قصَّة «بقعة صوت» يبحث، بحسب ما يقول: «عن كلمات قد أعرفها.. قد تعرفني.. قد أفهمها.. قد تمتلكني..» (ص 24). وفي «حكاية عشق» يروي العاشق تجربة قد تكون يومية في مخاطبة الحبيبة التي يبحث عنها يوميًّا: «الواقع الذي يجعلك تجهشين بالبكاء.. وتبحثين عن رجل مثلي يجلس على كرسي وأمامه طاولة صغيرة ليكتب على أوراق بيضاء هموم الآخرين» (ص 34)، ومن ثم يخاطب الحبيبة الغائبة قائلًا: «أوظف عددًا من الكلمات وأجعل لكل كلمة موقعًا خاصًّا… أجند كل الكلمات لتعزف لحنًا يوقظ نخوة الرجال… سأكتب بذلك الدم حكاية عشق لرجل أحب امرأة ذات يوم..» (ص 35).
في «حارس النهر القديم»، أبدى عبدالعزيز الصقعبي بوصفه ناصًّا، أبدى حرصًا لافتًا على تسريد «الصوت» كعلامة سيميائية دالة على توليد الحدث في بعض قصص هذه المجموعة، ومنها قصَّة «بقعة صوت» التي لعب المتخيل السَّردي لديه ابتداء من العنوان على شعرية التسمية والعنونة والحدث، فيمكن أن يقال مثلًا «بقعة لون» أو «بقعة طين»، أما أن يقال بقعة صوت فذلك عدول معنوي وانزياح دلالي مغاير، وتلك هي بعض جماليات الكتابة السَّردية في لعبة القول الإبداعي.
تحكي قصَّة «بقعة صوت» تجربة مسافر من جدة السعودية إلى الدار البيضاء المغربية، مسافر يزعجه صوت الكرسي الذي يجلس عليه في رحلة طيران تستغرق سبع ساعات متواصلة، يتساءل الراوي قائلًا: «لكَمْ هو مزعج… هدير صوته يجعلني أترنح؟ لماذا لا يصمت..؟» (ص 23). ومن ثم يشخص مكانية الصوت كحدث: «المقعد لا يغادرني مطلقًا في زمن يحملني به إلى هنا التي غالبًا ما تكون هناك..» (ص 23).
في تلك الأثناء، يتحوَّل الصوت إلى موضوعة تأمل واستذكار لكل صور الصوت المزعجة التي يعمل الناص على تسريدها، وهي تجربة ستجد صداها في قصَّة «رغبة خاصَّة» التي يتوغَّل الصقعبي فيها، نحو تفكيك بنية الملافظ الصوتية التي تضمُّها كلمات قابعة في ذات البطل المسرود بعمق، إنها تجربة الصوت الوجودية، تجربة العلاقة بين الحروف المنطوقة، أو التي يُراد نطقها ضمن مسار السَّرد، والذوات البشرية، فالمعشوقة من جانب العاشق في نأي تواصلي عنه، وهنا غياب من نمط آخر، بل هو ضياع الأنا من نمط مختلف أيضًا حرص الناصّ على تسريده عبر ملفوظ «مرحبًا» الذي يتمنّى البطل نطقه كصوت كامل في مواجهة المحبوبة التي أسدلت أبواب الاستماع إلى هذه اللفظة، فيبقى يدور ويدور مفككًا هذا الملفوظ التواصلي مع ذاته، لكنَّه في النهاية يجلس مع المرأة المتبناة رغبة وعشقًا، يجلس إلى جانبها:
«- هي أمنيتي.. بأن نتحدَّث.
– فقط.
– لا أدري.. إذا كان هنالك شيء غير التحدث معك.
– كم تدفع؟!» (ص 40).
إنها عوالم غير معتادة يروّدها عبدالعزيز الصقعبي في مجموعة قصصه «حارس النهر القديم»، ما يكشف عن تجربة دافئة التلقِّي في مبنييها؛ السَّردي والحكائي معًا، وهي تجربة استدرجت لغة توصيل سردي تفتح للقارئ آفاق القراءة التأويلية، كون السرد فيها يلاعب فراغات الحكي وبياضات التدوين؛ ما جعل الكتابة لدى الصقعبي تمنح القارئ فضاءات للقراءة الجمالية مفتوحة الأثر.