
بواسطة فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مارس 1, 2024 | مقالات
تتوزع حياة الإنسان على وضعين: وضع أول يدعوه الفلاسفة: الاغتراب، يتسم بالنقص والحرمان، ووضع ثان يحلم به ويتطلع إليه وهو: عالم التحقق أو: اليوتوبيا.
يتعرف الاغتراب، فلسفيًّا، بفقدان الإنسان لجوهره، وتوقه إلى استعادة جوهره المفقود بعد أن يتغلب على العوائق التي تشوه حياته. وما الجوهر المفترض إلا العمل الذي يبذله الإنسان في بناء ذاته. ولهذا يقال: يساوي الإنسان جملة ممارساته العملية والنظرية، كما لو كان يبني ذاته وهو يبني موضوعات حياته، ويتطور وهو يطور حاجاته، على اعتبار أن تطور الحاجات الإنسانية يقاس به تقدمه.
إذا كانت ماهية الإنسان من رغباته المتحققة أو المقموعة فإن اغترابه مما انتهى إليه، ما يعطي الاغتراب مراتب متعددة تنطوي على: المغترب، الغريب، المنقسم، اللاجئ،… الهامشي، المهاجر،… مع أن لكل مرتبة من الاغتراب ما يميّزها، نسبيًّا عن غيرها، تظل الفروق بينها ملتبسة ومبتورة، بل إنها تتداخل أحيانًا وتلغي الحدود بينها، نسبيًّا؛ إذ في كل مغترب غريب، وفي كل مغترب غريب إنسان منقسم غائم التعريف، ولكل واحد منها أقداره الممتدة من شقاء الروح إلى المجاهدة والمطاردة إلى عبث لا أفق له.
ولعل غربة الإنسان المتعددة، كما انقسامه الصادر عن شروط اجتماعية متنوعة، تفرض عليه غربة عن ذاته، فيعرف ذاته ولا يعرفها، يسيطر على وجه منها ويضطرب وهو يبحث عما تبقى. ذلك أنه لا يسوق حياته إلا إذا تعرف إلى إمكانياته الواضحة- الغامضة. ولهذا بدأ سقراط فلسفته بسؤال شهير: «اعرفْ ذاتك»، حيث الذات غموض يتكشّف منقوصًا دائمًا، يتوهّم الإنسان معرفتها، لكنها تَفِرُّ منه ذاهبة من زاوية عمياء إلى أخرى.
لا يختلف سؤال «اعرف نفسك بنفسك» عن عين تريد أن تبصر ذاتها، كما لو كانت تحتاج إلى عين أخرى. نعود إلى سقراط مرة أخرى حين يقول: «إن عينًا تتطلع إلى ذاتها تحتاج إلى عين أخرى وإلى تعريف معنى الرؤية»، وهو الأمر الذي يعني أن الغريب يتعرف إلى ذاته وهو ينظر إلى غريب يجاوره دون أن يصل إلى ما يريد. فالغريب، كما يقال، لا تاريخ له، يرى الآخرون خارجه ويظل داخله مستترًا. كما لو أن أحوال الغريب لا يلمسها إلا الغريب.
يساوق التعرف إلى أحوال الغريب شيء من العَمَاء تضيئه شروطه ولا يتمثلها إلا هو، فهي تستدعي المعاناة والسياق، وهو ما يجعل من الرواية مرآة ضرورية تعكس أحوال الغريب، أكان ذلك غريب نجيب محفوظ في «اللص والكلاب»، أو لاجئ غسان كنفاني في «رجال في الشمس»؛ فالأول تطارده السلطة السياسية حتى ترديه قتيلًا، والثاني يطارده لجوؤه إلى أن يتبدّد، أو يقضي بعد سقوطه ويذهب إلى اتجاه جديد.
والسؤال: ما ماهية اللاجئ الفلسطيني، في وضعه الإنساني الاستثنائي؟ كيف يكتب الروائي اللاجئ غسان كنفاني عن شخصياته التي هي لاجئة بدورها؟ لا جواب إلا برؤية روائية تضيء الروائي وشخصياته. تناول غسان موضوعه بمقولة: العار الذي لاحق فلسطينيًّا «فرّ من أرضه»، استحق التوبيخ والعقاب. ولهذا أمعن غسان في العقاب، وحكم على شخصياته بالموت، ألقى بها على قارعة الطريق وتركها بلا قبور.
عَمَاء الوجود
بيد أن «عَمَاء الوجود» الذي يجعل لاجئًا يوغل في عقاب لاجئ آخر يطرح سؤالين: لماذا انتقل غسان من شكل روائي إلى آخر؟ وهل أخذ غيره من الروائيين الفلسطينيين بمنظوره؟ تضمن مسار غسان ما يشبه (النقد الذاتي)، فبعد العنف الشديد الذي تعامل به مع شخصياته الروائية في روايته الأولى، عاد وقال: أريد أن أكتب رواية فلسطينية مئة بالمئة، وانتقل مباشرة إلى شكل روائي مختلف، كما هي الحال في «ما تبقى لكم»، و«أم سعد»، و«عائد إلى حيفا»… راسمًا الشرط الفلسطيني في «وجوهه المختلفة» الذي يحتمل الفرح والحزن والنبل والخديعة والتكسّب والتضحية بالذات…إلخ. لم يكتفِ بفكرة العار أضاف إليها بُعد المقاومة في الرواية الثانية، وصورة الهامشي في الثالثة، والذاكرة وخطاب العدو الصهيوني في الرابعة. وما إن وصل إلى مطلع «برقوق نيسان» حتى اقترح شكلًا روائيًّا جديدًا، جمع فيه بين الحاضر والماضي… وصل إلى نتيجة تقول: إن هوية اللاجئ من فعله المقاتل ضد اللجوء، ومستعيرًا ما قاله أندريه مالرو عن معنى الإنسان الذي هو محصلة لأفعاله المختلفة، مدركًا أيضًا الفرق بين وضع اللاجئ الاستثنائي ووضع الإنسان المغترب الذي بقي في أرض له.
الأرض/ الوطن أو الموت، على الإنسان أن يموت واقفًا، وعلى اللاجئ أن يعود إلى حيث كان، والهامشي لا وجود له، والمنقسم لا يعرف معنى الكرامة، والمهاجر إنسان ضل الطريق… أدرج غسان في رواياته قصدية مقاتلة لا يتحملها «السياق الفلسطيني»، المحاصر بأكثر من حصار؛ لذا بدت مقولاته مزيجًا من الشعر والإرادة الحائرة، ذلك أن الاستثنائي لا يصبح قاعدة إلا إذا اخترع «وجودًا مستحيلًا» لا تقبل به إلا رواية مستحيلة لها شروطها العادية المعيشة وزمنها الذي لم تعبث به الأقدار.
الرواية الفلسطينية المستحيلة، مزيج من الرغبة والحنين، تؤالف بين ما كان وما سيكون، ولهذا كتب حسين البرغوثي، وهو مبدع قصير العمر، عن أطياف فلسطين الغاربة في روايته «سأكون بين اللوز». واجتهد إميل حبيبي في رواية «إخطيّة» في وصف فلسطين «أيام العرب»؛ ذلك الأمن الدافئ الذي تداعى. أما جبرا إبراهيم جبرا «في البحث عن وليد مسعود» فاحتفى بفلسطيني «طوباوي»، تستولده الذاكرة ويمنع تحققه الواقع.

اشتق جبرا إنسانه الفلسطيني من مدينة القدس، وعطف ابن المدينة المقدسة على السيد المسيح، وصاغ من الطرفين شخصية تُسلّم قيادتها إلى الخير والجمال وتستعصي على الأرواح الشريرة. احتضنت رواياته فلسطينيًّا مقدسيًّا وسيمًا ذكيًّا عاشقًا للشعر والموسيقا، متفوقًا يحاكيه غيره ولا يحاكي أحدًا، فهو «ابن ذاته» وسيد حياته. طرد جبرا مأساة الفلسطيني بالأحلام، واعتبر الأحلام قوة منتصرة.
كتب جبرا رواية حالمة «متوهمة»، ليس بينها وبين الرواية الممكنة علاقة، فالأخيرة لها فضاء مكاني موحد وزمن موحد ونهاية واضحة، خلافًا لرواية جبرا التي عبّرت عن بطولة الثقافة والجمال والانتصار الخالص، وأنجبت بطلًا أثيريًّا لا علاقة له بحياة العاديين من البشر الذين تمتزج فيها حياة المأساة والملهاة، وواقع الأمر أن المكان الفلسطيني بعد اللجوء جملة من الأمكنة، وأن زمنه جملة من الأزمنة. وأن الفلسطيني الموحد لا وجود له بعد الشتات.
الاغتراب المقاتل
ظلّلت المأساة الرواية الفلسطينية «الحقيقية»، وهي جملة من الاحتمالات الدامية، آيتها مدينة غزة التي لا تتقي البرد إلا إذا راهنت على وجودها، تنتزع بطولتها الإعجاب والتحية وتعامل مستقبلها بمنطق الرهان والاحتمال. تقاتل ولا تعرف إلى أين تسير، وتنظر إلى المستقبل وتكاد لا تتذكّر الماضي إلا كلحظة سعيدة لن تعود. لكأنها تلتبس بصورة «سعيد مهران» بطل محفوظ في روايته «اللص والكلاب»، الذي يسير إلى حيث يرغب وتعبث بخطواته الدروب الشائكة.
غزة في صورتها الأولى مرآة «للاغتراب المقاتل»، وهي في صورتها الثانية دمار وشرف، وفي بعدها الأخير «يوتوبيا الانتصار»، الذي يتبخر إن أشرقت الشمس. هويتها رغبة وموت ومقبرة ونشيد، أي مأساة تغرقها الأماني والدموع. بطولة مغتربة مسكونة بالانقسام تساوي نواياها ولا تجسد أفعالها المباشرة، كما أراد أندريه مالرو الذي قال: «صورة الإنسان من أفعاله»؛ ذلك أنها تبني صورتها مشرقة يمحوها الاغتراب، فعلى الإنسان أن ينجز ما يستطيع ويدع الرواية تسردُ معادلات واقعية وغير واقعية في آنٍ.
ما يجب التذكير به أن الغريب واللاجئ والمنفي، ولكل منهم اغترابه، تلاحقهم صفات ثلاث: الاستثنائي والاتهام والخوف الذاتي. فليس للغريب حقوق المواطنين الذين يعيش بينهم، فغير مقبول أن يحتل وظائفهم، ولا أن يتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، ولا أن يشاركهم احتجاجهم و«مظاهراتهم»: إنه داخل القانون وخارجه، يعاقبه إن أخطأ كالآخرين، ولا يسامحه إن سامحهم أو خفّف عنهم الأحكام. تغذي فيه استثنائيته الاجتماعية شعوره بالنقص وتملي عليه حياة إنسانية ناقصة. ألمح إلى ذلك جبرا إبراهيم جبرا في روايته: «صيادون في شارع ضيق»، حيث الوافد الفلسطيني موضوع للنقد والنكد والاستبعاد.
يأخذ اتهام اللاجئ شكل البداهة، فهو ليس في وطنه ولا حق له في وطن الآخرين وعليه أن يخفض رأسه ليتقي أشواك الاتهام. عالجت سميرة عزّام حيرة اللاجئ في قصتها القصيرة «فلسطيني»، حيث الضفة لا تشير إلى وطن مفقود أفقر اللاجئ إنسانيًّا ومعنويًّا، بقدر ما هي إعلان عن: النقص يدفع به إلى شراء هوية «لا تشترى»، فنقصه يلاحقه من الصباح إلى المساء. وقالها غسان في روايته «عائد إلى حيفا» التي استنكر فيها اللواذ بالذكريات، فهي حفنة من الصور المتقادمة، أكبر في عدوه استعداده للقتال، واتخذ منه «معلّمًا» جديرًا بالاحترام. ربما تكون هذه الرواية فريدة في جرأتها ومنظورها ووحيدة في حوارها الشجاع مع اليهودي الذي احتل فلسطين؛ ذلك أن معظم الروايات الفلسطينية اكتفت بتسخيف اليهودي دون الاعتراف بإمكانيته الإنسانية المقبولة والمرفوضة.
الغريب المسورة حياته بالخوف صورة يلتقطها الأدب مجزوءة، وتتضح أبعادها في الحياة كائنًا متهمًا تلاحقه الأسئلة، مشكوكًا في وجوده وإنسانيته، عليه أن يتذكّر أمام مخبر بليد اسم جدّه الخامس، والبيوت التي سكنها، والمواقع التي مرّ بها، وأسماء أصدقائه الأحياء والأموات والذين سيموتون قريبًا.
استولد كابوس الغربة وشقاء الاتهام وتهافت «الأجهزة الأمنية المتسلطة» صورة الوطن المفقود، وخلق «يوتوبيا» الغريب الراجع إلى وطنه. تعني «يوتوبيا» حرفيًّا المكان الذي لا وجود له، فهو أمنية ورغبة، وهو في الحلم متجانس وشامل ولا انقطاع فيه وغريب اللغة. وإذا كان القرن الثامن عشر في أوربا خلق اليوتوبيا من العلم والفضيلة والأنوار، فإن يوتوبيا الغريب/ اللاجئ/ المنفي، الذي سقطت عليه أكثر من مجزرة عالم لا تنقصه العدالة، يعرف القانون ويطبقه على الجميع، لا يحوّل البيوت إلى سجون ولا يملأ الشوارع بالمخبرين ولا يصيّر مدينة محاصرة فقيرة إلى «مقبرة للأطفال».
إذا كانت يوتوبيا عصر التنوير التاسع عشر مهجوسة «بالتقدّم»، فإن يوتوبيا اللاجئين مهجوسة بهواء نظيف لم تدمره القذائف والطائرات، تقدمه رحمة وأنواره عدالة مشتهاة.
لا غرابة أن يكون بين السعادة والرواية مسافة واسعة. فلا وجوه حقيقية تخفق في نهايتها رايات الانتصار منذ أن ابتلع «موبي ديك» البحار العصابي «إيهاب»، وصولًا إلى مصري فقير وشجاع يدعى «سعيد مهران» قتل قبل أن يداعب طفلته «سناء»، انتهاء بمتشائل إميل حبيبي؛ حيث التشاؤل مناورة متقشفة تسمح للوجه أن يبتسم شرط ألا يختلج، وللعينين التمتع بالربيع وهما مغلقتان، وتعد مدينة غزة الفلسطينية بشتاء لطيف القنابل.

بواسطة فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يناير 1, 2024 | مقالات
يحتمل المثقف، كما تصوره الكتابات المتعددة، صفات متنوعة: فهو المرشد والهادي والمتعلم والمعلِّم النوعي والثوري والناقد، وغيرها من صفات ممتدة، كما لو كان «كاتبًا» لا تعريف له يُختصر، ضرورة، في بعدين: الكتابة والمعرفة؛ إذ في الكتابة ما يوحي «بمهنة» وفي المعرفة ما يحيل على اختصاص… بيد أن البعدين لا يأتيان بتعريف بقدر ما يؤكدان «هشاشته»؛ ذلك أن المهن متعددة والاختصاصات كثيرة.
كتب إدوارد سعيد في «صور المثقف»: «لكأن في أقدار المثقفين ما يشبه خصائص الأنبياء…». وخصائص الرسل تنطوي على الإصلاح والهدى والإرشاد والتهذيب وتوليد أرواح جديدة، كما لو كان عالم المثقفين آية على عالم القيم والأخلاق الكريمة.

مهدي عامل
أما المفكر القومي ساطع الحصري فذهب إلى فضاء القيم من باب أكثر تحديدًا حينما كتب: لا تقوم القوميات إلا بمثقفين نوعيين. يشرحون معنى القومية ويكشفون عن ضرورتها ودلالتها، فالشعوب بلا قومية واهنة مريضة، والقوميات بلا مثقفين جماعات ضائعة. أعلن الحصري عن ذاته مثقفًا قوميًّا صريحًا يبشر بتاريخ عربي جديد، قوامه الوحدة والتضامن واستلهام أرواح الأجداد وتفعيل الذكريات البعيدة المنتصرة. المفكر الماركسي اللبناني مهدي عامل، في كتابه الكبير «نمط الإنتاج الكولونيالي»، اطمأن إلى مصطلح: «المفكر الثوري»، الذي ينحاز إلى طبقة اجتماعية صاعدة، ويندد بطبقة أخرى تأتي بالتبعية والاضطهاد. نسب الحصري إلى مثقفه دورًا محددًا، يتجاوز الطبقات جديدًا ويلتزم «بروح الأمة التليد»، واكتفى عامل بمثقف وطبقة وأسبغ عليهما صفة: الثورية، التي تنقل المجتمع من مرحلة «ما قبل التاريخ» إلى ما بعده وتستولد تاريخًا غير مسبوق.
المثقف الجمعي
تقاسم مثقفو إدوارد سعيد والحصري ومهدي عامل صفة عامة مشتركة، تقوم على عارف، يرشد غيره، وآخر -«أقل مرتبة»- يحتاج إليه ويختلف عنه في الغاية والهدف. وإذا كان في المثقفين ما ينسبهم إلى «الأنبياء»، بلغة سعيد، فإن دورهم، الصريح والمضمر الارتقاء، «برعيتهم» من طور إلى آخر أكثر علوًّا… يخالط الدور، على رغم نبله، سلب يثير الارتباك؛ ذلك أن هذا الرسولي والقومي والثوري يكتفي بفرديته، ما يجمع بين المثقف و«الفرادة»، على اعتبار أن «الفردية» في ذاتها، قيمة إيجابية أكيدة.

إدوارد سعيد
ولعل الاحتفاء بالفرد العارف، المتميز عن الذين يتوجه إليهم، يفرض الانتقال من صفة الفرد إلى معيار أكثر اتساعًا هو: الثقافة الاجتماعية التي تستدعي «الجماعة». كتب الإنجليزي ريموند ويليمز في بحث طويل: الثقافة نمط شامل من الحياة يأخذ به أفراد المجتمع جميعًا. يُشتق المثقف، والحال هذه، من ثقافة مجتمعه، ولا يكون مفردًا، تصوغه ممارسات المجتمع الذي يعيش فيه، التي تتضمن القراءة والكتابة والإقبال على الفنون الحديثة، والتعرف إلى الحياة السياسية وإلى الفرق بين الدكتاتورية والديمقراطية والانفتاح على الثقافة العالمية…. وكما يربّي المجتمع مثقفه، فهو ينتج مثقفين تخرجهم الجامعات وتدعم ثقافتهم المجلات والكتب وإصدارات دور النشر ويشاركون في حوار اجتماعي، مجتمعي، يسهمون فيه ويوسعون آفاقه، ولذلك تتصف المجتمعات المتطورة بظواهر ثقافية متنوعة، يقترحها أفراد، وتشارك فيها ممارسات اجتماعية واسعة: المسرح، السينما، معارض الفنون… ومن هنا جاء قول أشبه بالقاعدة؛ يتذوق الفنون فرد تربى في مجتمع شهد تربيات فنية…
يفضي الحوار الثقافي المجتمعي، في «المجتمع المفتوح»، إلى ظاهرة: مثقفون كبار لهم مشروعات اجتماعية، «يشاركون فيما يتجاوز اختصاصهم»، ويمثلون أنواعًا متعددة من المثقفين «محددي الصفات»: المثقف العضوي عند غرامشي الذي يدافع عن مصالح طبقة وينقض مصالح أخرى وينتهي، في الشروط الديمقراطية، إلى «المثقف الجمعي» الذي يوحد بين الثقافة والسياسة وينفتح على مشروع اجتماعي. دعا جان بول سارتر إلى «المثقف السياسي». الذي يأخذ موقفًا نقديًّا من الظواهر الاجتماعية جميعها، ويتدخل فيما يتجاوز اختصاصه. ودعا إدوارد سعيد إلى «المثقف الهاوي»، البعيد من المثقف ذي الاختصاص المغلق، القريب من السلطة… كان الفرنسي هنري لوفيفر قد تحدث عن «المثقف النوعي» الذي يتكئ على معرفة تدعم المصالح الجماعية المدافع عنها، وتسهم هذه المصالح في تطوير ثقافته وتجديدها.
تميل الثقافة التبسيطية البعيدة من التحديد إلى مثقف مجرد الصفات: تدعوه: المثقف الثوري، التي لا تعني صفته شيئًا، أو المثقف الطبقي التي لا تأتي بمفيد، وكذلك المثقف الحزبي الذي صلاحه من «حزبه»، وهو كلام أجوف. تنوس هذه الصفات بين الاختراع و«الأيديولوجيات الفقيرة». فالثورة مشروع اجتماعي متخيل لا يوكل إلى فرد يحسن القراءة والكتابة، والطبقات الاجتماعي محض لغة مستحيلة التجسيد: فلا وجود «لثقافة عمالية» إلا في الإنشاء الفقير، وقيم الرأسمالية لها وجود في الاقتصاد لا في غيره وفي مدارسها المختصة… والبرجوزاية الصغيرة، التي عاشت بالكلام ردحًا من الزمن ظهرت في الدعاوي السياسية العارضة ودفنت خارجها.
وبسبب استبداد البداهة التي تساوي بين الكلمات والموضوعات، ارتاح تلاميذ محمد عابد الجابري إلى مصطلح: «المثقف الهادي» حيث «الإبستمولوجيا» تنير «طريق الثوار» على اعتبار أن المثقفين «البرَرَة» من الثوار، يشير إلى الانتصار بيد ويحمل مراجع المعرفة بيد أخرى. ولكأن التزود «بالنظرية» «يسوغ» وجود الفقر ويحقق الكرامة المنشودة ويسيس جموعًا من المضطهدين حرمت طويلًا من الحرية والسياسة وعفوية الحركة والتنظيم. ينتهي هذا الزعم الفاسد، في النهاية، إلى قول مستبد يمحو مبادئ السياسة ويحتفي بالانضباط والعقول المنضبطة، يستعيض عن المتسلط التقليدي بمتسلط دقيق الكلام يؤمّن «للمخْضَعين» سبل الرشاد والهداية. ومع أنه يزجر «العفوية الشعبية» رافعًا رايات المعرفة، فهو يكرر، بشكل مختلف، قولًا قديمًا زهيد التكلفة: «من لا شيخ له شيخه الشيطان»، ألمح إليه طه حسين في كتابه «الأيام»؛ إذ المثقف الهادي، الشيخ الجديد، مرتبة معرفية- اجتماعية «تبجّل» الثورة العارفة وتدعو الخاضعين إلى الالتحاق بالأساتذة و«الأكاديميين».

هنري لوفيفر
ارتضى «بعضٌ» مصطلح «المثقف الهادي»، حيث الهداية من الثقافة والثقافة من الهداية وممارسة الحياة لا معنى لها، و«التجربة اليومية»، تاليًا، لا تفيد الإنسان في شيء. تتلاشى في الهواء بداهة معروفة: «شخصية الإنسان من أفعاله»، ويتداعى قول أندريه مالرو الشهير: «يساوي الإنسان مجموع أعماله»، الذي يعتبر الفعل المشخص للإنسان المشخص بداية المعرفة، وأن الإنسان البنّاء يتعلم البناء وهو يبني، تاركًا «جمالية الكتب» لأصحاب الاختصاص، الذين هم افتراضيًّا «جنس كتابيّ من البشر» يسترشد بالنظرية ومشتقاتها. يعلم «تلاميذ الفقراء» القراءة والكتابة والبناء والمظاهرات منطلقًا من النظريات المتعالية.
بعض آخر من مثقفي الاختصاص ينادي «بالمثقف الإيماني»، محتفلًا بالثقافة القلبية، حيث المعرفة الحقة تتكون في «القلب المؤمن» ولا تحتاج إلى الفعل واليدين. تنتقل المعرفة الصالحة، والحال هذه من «النظرية» إلى القلب، الذي يصبح، أحيانًا، «قلبًا ثوريًّا» لا علاقة له بالحاجات المادية والتجريب. وقد يصدر عن هذا القلب «إيمان ثوري» مغلق، لا يفيد الأغراض اليومية ولا تفيده في شيء أيضًا.
المثقف بصيغة المفرد
ولعل في توزع المثقف على وجهات نظر مختلفة ما يعفيه من التعريف، ويمنع عنه صيغة الجمع، ويضع تعريفه في الناظر إليه، اتكاءً على عمومية: العمل اليدوي والعمل الذهني، التي تصلح للأفكار الكتبية وتتعثر في الحياة العملية. فلا وجود لعمل يدوي متحرر من «تفعيل الذهن» حتى لو كان هامشيًّا، كما أن العمل الذهني، الذي يشتق منه: «المتذهّن» يصطدم بالمعيش اليومي حتى لو لم يسعَ إلى ذلك. وواقع الأمر أن بين «صفات المثقف» والسياق الاجتماعي التاريخي علاقة عضوية، كما أن السياقات المتعددة تقترح «صفات متعددة». فللمثقف «الثوري» سياقه الأيديولوجي الأكيد، فلولا سياق ساطع الحصري لما طلع بمثقفه القومي، ولولا صعود «اليسار» في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لما تكاثر «المثقف العضوي»، ولولا تراجع الطرفين لما ظهر ثالث يستضيء بالمثقف المصري «سيد قطب». ولو لم تنطفئ النزوعات الأيديولوجية المختلفة لما غدا المثقف العربي أثرًا من الماضي.
قلنا اتكاءً على ما سبق: لا وجود للمثقف بصيغة الجمع، فهو كلمة يأتي معناها من «القائل بها»، يستدعيها سياق ويطردها سياق آخر. ويمكن مراجعة القول في أحواله المتحولة، عربيًّا، الوصول إلى نتيجة أخرى: كل الناس مثقفون لا انطلاقًا من المساواة التي احتفى بها غرامشي إنما لأمر آخر مرآته: تراجع القراءة والكتابة وانطفاء السياسة و«التحزّب» الفاعل؛ ذلك أن كل ما يعمم الجهل يجهض معنى الكلمات. فكل الناس أميون في مجتمع كل الناس فيه متعلمون، وكل الناس مربون في مجتمع حسن التربية.
تتأتى من مستويات التعليم المتفاوتة مقولة: تبادلية العلاقات المعرفية؛ إذ المعرفة الأرقى تفعل في معرفة محدودة التطور، وكذا الأمر في العلاقات الثقافية المختلفة المراتب التي تضع «المثقف» في سلسلة تاريخية «متنوعة». فقبل المثقف يأتي «الفقيه»؛ إذ حقل الأول الموضوعات الدنيوية، يقرؤها وينقدها ويتخذ منها موقفًا، وإذ الثاني يقرر ويشرع وينشغل بالأحكام الدينية، مع فرق أساسي بين الطرفين: يتعين المثقف بموقفه من السلطة السياسية، يقومها، ويقترح بديلًا، بينما يظل الفقيه مشدودًا إلى السلطة. يظل الفقيه قائمًا بين حدين: السلطة كما يقبلها الناس والناس كما تريدهم السلطة وترضى عنهم. بيد أن هذين الحدين يضطربان في زمن «السديم الاجتماعي»، فلا الفقيه جليّ الصورة، ولا أتباعه واضحو القيم. آية ذلك ما ازدهر في عقود أخيرة وأخذ صفة: الداعية.

محمد عابد الجابري
إذا كان زمن خطاب الداعية سلطويًّا، يتداخل فيه الحاضر والماضي بلا تمييز، يفيد منه الداعية والسلطة، فإن زمن المثقف، تاريخيًّا، يرنو إلى المستقبل ينشد، نظريًّا، مصالح «الشعب» ويدافع عنها. المثقف مقولة حديثة، والداعية وما يشبهه لا زمن له، حده الأول مصلحة «متدينة» أو «تأويل ديني» نفعي النزوع.
ظهر المثقف العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما تلاه، وتوالد الفقيه في جميع الأزمنة. ارتبط مسار الأول، صعودًا وهبوطًا وتجددًا وتداعيًا، بالحوار الاجتماعي ومساحة الحرية الاجتماعية والقول الحر، وحايثت حركة الثاني اتجاهات السلطة التي تمجد الثبات وتميل إلى «التأبّد».
هل على المثقف أن يعترف أولًا بعلاقات القراءة والكتابة، أم إن عليه قراءة الظواهر الاجتماعية المعيشة التي هي قوّامة على المجردات الثقافية؟

بواسطة فيصل دراج - ناقد فلسطيني | نوفمبر 1, 2023 | مقالات
لماذا بدأت الرواية العربية الأولى باسم امرأة؟ وما الذي أعطاها حضورًا متوالدًا في روايات لاحقة؟ وهل كانت فكرة «فاضلة» مجردة أم كيانًا مشخصًا واضح الحركة والفعل؟
جاءت شرعية السؤال من «زينب»، التي كتبها محمد حسين هيكل في نهايات العقد الأول من القرن العشرين واعتبرها بعضٌ الرواية العربية الأولى، ولحقت بها أنثى تشبهها في رواية توفيق الحكيم «عودة الروح»، في انتظار أخرى أوسع حضورًا وغموضًا في «دعاء الكروان» لطه حسين… أخذت «زينب» ملامح الأصل، بالمعنى النظري: فهي بداية ما لحق بها من روايات، وامتداد للريف المصري، أصل الشخصية المصرية الموزعة على النيل والأهرامات، ومرآة «لعبقرية المكان» بلغة الجغرافي النبيه جمال حمدان. وهي روح غامضة مشبعة بالجمال وسريعة الرحيل… ولأنها أصل فهي تنفتح على الماضي والمستقبل وتحرض في ديمومتها على التأويل، وهي في الحالات جميعًا «رمز» وطبقة من الرموز المتعددة الدلالات.
أنثى هيكل
ما يميّز زينب، كما رسمها هيكل الشاب، أمران: جمال هادئ وروح مستقرة، ورحيل عن الحياة في زمن الشباب واضح وغامض في آن. الأصل، نظريًّا، لا يموت، له ماضٍ أثيل، تمتد فيه «طبيعة مصر» سرمدية الوجود. زينب من خضرة الأرض وأريج الظلال، لصيقة بأرضها، بها تبدأ وإليها تنتهي، بعيدة من أنثى توفيق الحكيم القريبة من المدينة وعالم الطلبة والمظاهرات الوطنية، لكنها كالأولى تقاسمها جمالها وأنس حضورها ولها روحها الجماعية، تعشق الكل ويعشقها الكل، تجسّد «الواحد في الكل والكلّ في واحد»، يتساند فيها الحاضر والماضي معًا. كأن وجودها «لا زمني»، تعبره جميع الأزمنة ويظل شابًّا.
يلفّ التساؤلات السابقة سؤال «صغير»: لماذا دفع هيكل زينب إلى موت مبكِّر واستبقى الحكيم أنثاه المشرقة صامدة منتصرة؟ لماذا اختلف مآل «مصريتين» مرتبطتين «بالأرض» في منظورين روائيين يذكران بجمال الريف و«بجيوش الشمس» الفرعونية؟ يصدر الجواب عن منظور أول عامر بالارتباك، يعشق الريف المصري وسماءه، و«يعطف على فلاحين طيبين»، ويستنكر استبداد العادة الذي يحكم حياتهم، يختصر الفرد في خضوعه والفلاح إلى جوعه. ولهذا تحضر زينب كموضوع وإشارة، فهي عاشقة مضطهدة، تكون كما أرادت لها العادات المستبدة أن تكون، وهي «روح مصر القديمة الخالدة»، صورة عن «جمال فرعوني» وآية له، تفتقر إلى حرية تدعها طليقة الرغبات. وإذا كانت صورة زينب في جمالها الباذخ من صورة مصر الأصلية، فإن مآلها الحزين أثرٌ لمجتمع متخلّف، الجمال العميم رحمة لكنه لا يرحم. تفتقر الصورة الأولى إلى «العقد الاجتماعي»، المأخوذة عن جان جاك روسو التي تدع البشر متساويين أحرارًا، بينما يترجم المآل الحزين أحوال مجتمع يسوسه «بشر بلا مدارس» وعقول لا تُحسن القياس.
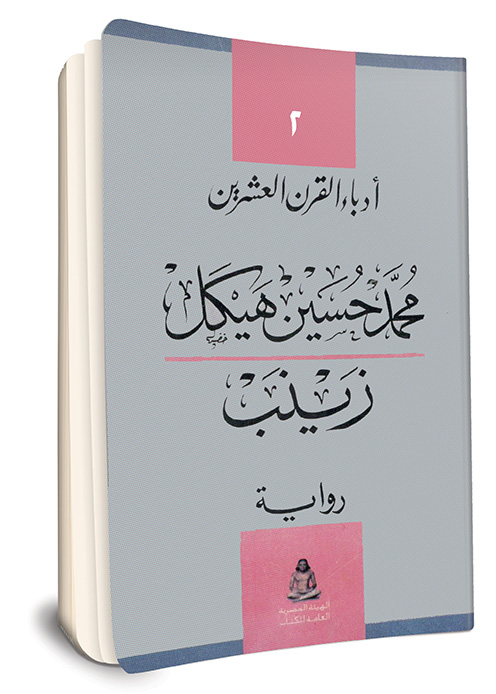 الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
تتعيّن رواية زينب خطابًا حداثيًّا، آيته أنثى لها طبيعة مصر، عشقها تصادره الأعراف، وصبيها الواعد يتأمل الجمال ويقف عاجزًا. ولهذا يكون السارد المتمرد قناعًا فكريًّا، يشهد على بيئة «جميلة مستبدة»، تعارض قواعدها الحاجات الطبيعية، وعلى تفاؤل كسيح، ينظر إلى مجد قديم لن يعود، وإلى مجتمع يعترف بالحرية والمساواة، يشفق على فلاحين يعتاشون بآفات يظنونها فضائل، يقدسون ذكورة فارغة ويرجمون أنوثة جديرة بالحياة.
يتجلّى البعد التبشيري في نظر الصبي المفتون بجمال زينب، الذي يقنعه بأنها لا تموت، فإن ماتت بعثت من جديد. يأخذ عندها المثقف الشاب دور «المبشّر»، يقتات برغباته ويحملها ويسير إلى لا مكان. كما لو كان مصيره شكلًا آخر من المصير الذي انتهت إليه زينب.
أنثى الحكيم
ارتاح هيكل إلى رومانسية فلسفية متأثرة بأفكار فرنسية، واطمأن الحكيم في «عودة الروح» 1923م، إلى رومانسية صوفية، تضع الكلّ في واحد وتضع ذاته فوق الجميع. نسب الحكيم فلسفته إلى موروث مصري قديم، يساوي بين العقل والقلب والزمن والروح. قاسم هيكل مجاز «الصبي الواعد»، والقول بأصل فرعوني عظيم، مجلاه الفلاح المصري الذي يجتمع فيه الصبر والتضامن والتسامح، وتقاسم معه صورة الأنثى الفاتنة، التي هي من روح مصر وآية لها، وغالى في تجميلها حتى تفرّدت. أراد هيكل أن يواجه التخلّف بثقافة حديثة، تحرّر الفرد من استبداد الجماعة، لا فرق إن كان ذكرًا أو أنثى. رأى الحكيم في الجماعة كيانًا فاضلًا، عبقري القلب، يحايثه الكمال في جميع الأزمنة. وبسبب عمومية سمتها الخلود، تتساوى فيها الأنثى والذكر، ويرشدان إلى المستقبل بلا خطأ.
شاء الحكيم مصر مبدعة متجددة، اشتقها من ميتافيزيقا ساذجة؛ إذ المصري من جوهر فلاحي، مفعم بالنقاء كالأرض التي يمشي فوقها، يعيش بإحساسه و«الإحساس هو علم الملائكة»، لا يحتاج إلى «لغة العقل» الغريبة عن مصري مندمج بالكون، يأتلف مع جميع المخلوقات: «إن مصر الملائكية القلب ذات القلب الطاهر ما برحت مصر، وقد ورثت -على مرّ الأجيال- عاطفة الاتحاد مع الوجود دون أن تعلم…».
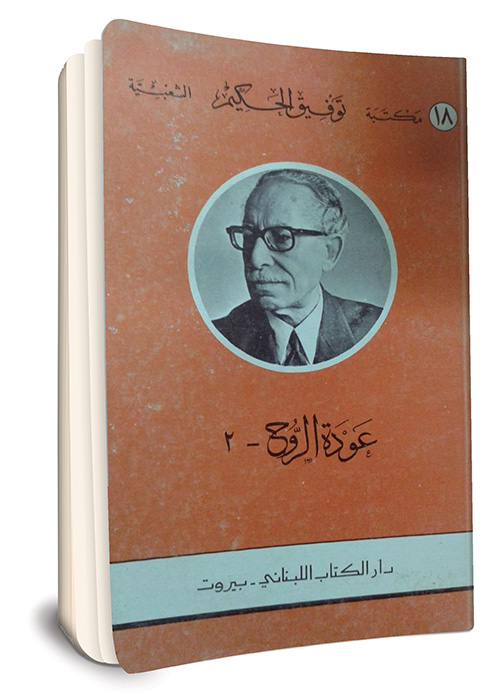 لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
تجسّر «سنيّة» المسافة بين ما مضى وما سياتي، بين الفلَّاح القديم وثورة 1919م، وبين مصر فرعونية: «عنقها غابة من البياض»، وفضاء روائي حديث يقتات بالواقع ولا يتعامل مع المعجزات. تجتمع المتناقضات في نص مجرد موحّد الزمن، يحتفي بثورة 1919م ويعد إلى الوراء إلى زمن أخناتون، كأن الرواية جنس أدبي تقبل به جميع الأزمنة.
أنثى طه حسين
استُهلت الرواية العربية بأقلام غير روائية، فرنسية الثقافة، وتتصرف بالرواية كما تشاء. عُني هيكل بالفلسفة والرواية ووقف إلى جانب الحرية، وكتب الحكيم عن ذاته وميوله وكتب الرواية في «أوقات الفراغ». انشغل طه حسين بقضايا التخلّف والتقدم وحاول الرواية في مجتمع مسكون «بثقافة الأدعية»، وأنجز رواية أولى عام 1934م عنوانها: «دعاء الكروان»، سردت رغباته الفكرية الذاتية واقتفت مسار «حب مشؤوم» يثير السخرية، يجب أن ينتصر.
ما حديث التخلّف والتقدم في عقل نقدي عنيد كعقل طه حسين إلا الحديث الصعب عن قيم جميلة منتصرة في مجتمع يسكنه الكراهية. ذلك أن طه حسين لا يرضى بأنصاف الحلول ويؤمن بقوة المعرفة إيمانًا مطلقًا. والأرجح أنه حين كان يكتب «دعاء الكروان» كان يهجس بمسيرته الذاتية، كما ساقها في «الأيام»؛ إذ الإرادة تروّض الوجود والأرجح أيضًا أنه انتصر للحب المثالي مثلما انتصرت إرادته على «عماه»، وانتقل من وضع إنسان يُرفع كالمتاع إلى وضع آخر مستقل، مرفوع الرأس، ينصاع إلى إرادته ولا يخضع لأحد.
أقام حسين روايته «دعاء الكروان» على مجاز الانتقال الوهمي: انتقال مكاني، اجتماعي، نقل فتاة من البادية إلى الريف، من حياة خشنة بائسة الحاجات إلى حياة في بيئة ميسورة من الريف، وانتقال على مستوى الوعي صدر عن اختلاف البيئة، فعرفت الفرق بين القراءة والأميّة واستمعت إلى صوت البيانو الذي لم تراه من قبل، وتبدلت كلامًا وملبسًا، كأنها حظيت بأكثر من ولادة. وانتقال الثالث على مستوى العاطفة، جاءت كارهة مملوءة بروح الانتقام وانتهت متسامحة، قلقة، عاشقة.
طرح المؤلف في روايته موضوعه الأثير والمحدّث عن التعلم والتعليم، وغالى فيه واستحضر ثقافته المدنية- الفرنسية، فنقل الفتاة من الريف إلى المدينة. ومن تعلّم القراءة والكتابة إلى تهجّي «الثقافة الفرنسية»، فكأنها انتقلت من فضاء الرمال إلى ضفاف نهر النيل. ونقلت معها «المعشوق» من لا مبالاة مؤذية إلى قلب رقيق هذّبته العاطفة المتبادلة والحوار بين عقلين متساويين في التساؤل والمحاججة.
تساوي شروط الحضارة بين فتاة من البادية وأخرى من المدينة، فإن كان لها حظ من الاجتهاد تفوقت على الأخيرة، تفوقًا «يمكن» أن يجعلها من «النخبة المتعلمة». اختصر حسين إيمانه بقوة المعرفة في حكاية متعددة الأبعاد.. الإيمان بالمساواة بين البشر، إمكانية التحضر وتوليد شروطه، وحق الأنثى في التعلّم «الراقي»، ليكون لها حقٌّ في الحب والاختيار الحر والمساهمة في تطوير المجتمع. ليست صعبة المقارنة بين الصبي الضرير في «الأيام» والبدوية النجيبة في «دعاء الكروان»: سيرتان لإنسانين نبيهين، لهما شروطهما الصعبة، يقتحمان الصعاب ويبلغان السلامة.
اللجوء إلى الرواية
سؤال يثير الفضول: لماذا لجأ المثقفون الثلاثة (هيكل والحكيم وحسين) إلى الرواية وهم الذين انشغلوا بصياغة «الأفكار الاجتماعية»؟ محاكاة الثقافة الفرنسية «ربما»، فجان جاك روسو، الذي أخلص الشاب لأفكاره، كتب رواية عن الحب -هولويز الجديدة- والحكيم انشغل بالمرأة والحب في «عصفور من الشرق»، روايته الأولى التي كتبها في باريس، وعرف حسين بدوره «قيمة المرأة»، عاشها حسين حين كان بدوره طالبًا في باريس. اعتنق الثلاثة معًا، بأشكال متفاوتة: فكرة التقدم واعتبروا الرواية، كما الدفاع عن المرأة، وجهًا من وجوهها. حرّض على ذلك «المتخيل الروائي»، الذي يقبض على وجوه من الحياة المعيشة، ويضيف إليه «أوهامًا جميلة»؛ ذلك أن «فكرة التقدم» اتكأت على فكر «رَغَبي» عريض قوامه «المستقبل المنتصر» والكمال الاجتماعي ومصر الخالدة.
مازج الفكر الرغبي تجريدًا واسعًا أدمن عليه «المحرومون» الذين يفصلهم عن نقائضهم مسافة واسعة، كما لو كان لا يستوي إلا بإضافة -ضرورة- تعترف بالمعيش وتعيد خلقه كما يجب أن يكون. لهذا تأتي المرأة في الروايات الثلاث، رحيبة الجمال والنباهة، سبقها زمن مغترب وعقبها زمن منتصر آخر.
كان فرح أنطون، المثقف السياسي التنويري المنفتح على الثقافة الأوربية يقول: «الرواية فن تأخذ به الشعوب الراقية»، والرواية عندنا «كتابة تدعى الرواية على سبيل التساهل». سيطرت الرغبة المضمرة، أو الصريحة، بمحاكاة «الآخر المتقدم» على الروايات الثلاث، ما يسمح بالقول: كان هيكل والحكيم وطه حسين روائيين على سبيل التساهل ويتصرّفون بالأفكار تصرّفًا مريحًا: الفلاحون عند هيكل يعيشون «الاشتراكية» بشكل عفوي، وأنثى الحكيم تقارب الشمس ضياءً، توحّد بين الجامعة الحديثة والأفكار الفرعونية القديمة، والأنثى في «دعاء الكروان» أقرب إلى المعجزة. أدرج الحكيم في نصه «صبيًّا ملائكيًّا»، وساوقت الملائكة «المرأة الروائية» في الروايات الثلاثة؟
جاءت الرواية العربية؛ في بداياتها، معوّقة، صاحبتها أفكار تقدمية لا تنقصها الإعاقة، منّت النفس بامرأة مصرية من حرية وذهب، يضيق به الواقع المعيش وتحتفي بها الكتابة المجردة.

بواسطة فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يوليو 1, 2023 | سيرة ذاتية
ما يترسّب في ذاكرة الطفولة يعيش طويلًا، تمر به الكهولة ويظل سليمًا، ويبلغ الشيخوخة ولا يشيخ، وقد تتسع أبعاده ويأخذ شكل الأسطورة، لا يتضح ولا يكتنفه الغموض. وكان للقاهرة، في طفولتي، ملامح الأسطورة.
ارتاحت إلى صيغة: «الأفعل»، فهي أوسع المدن العربية وأكثرها سكانًا، مدينة إلى جانب المدن وأوسعها هيبة، وعاصمة تزهو على العواصم. نيلها أطول الأنهار، ينبع من «سدرة المنتهى»، وهو مكان في الجنة، ويصب في بحر من بياض، يعلن أن «مصر هبة النيل»، وأن بهاء المدن من أنهارها. إلى جانب النهر تقف الأهرام شامخة منذ زمن سحيق، وأن في المدينة المختلفة مسجدًا دعاه المسلمون: «الأزهر الشريف»، وأن اسمها يخبر عن مدينة «تَقْهر ولا تُقْهر».
أشهرت القاهرة رموزُها المتوارثة، المصوغة من حجر وماء ومعرفة تكاد تكون مقدسة، ومن أبي الهول «الذي جدع جنود نابليون أنفه»، وأشهرت «حناجرَ ذهبية» مطلعها «أم كلثوم»، «كوكب الشرق»، كما دعتها سيدة من القدس، صفّقت لها طويلًا، قبل أن تودّع مدينة سائرة إلى «التهويد» في زمن يقف على الأبواب، وأسمهان القتيلة الملائكية الصوت، أبهرت عيناها الجنرال الفرنسي ديغول، كما جاء في مذكراته، ومحمد عبدالوهاب «مطرب الأمراء والملوك» بلغة زمن قضى، وفريد الأطرش الذي لاحقته صفة «الشامي» حتى رحل.
وزّعت القاهرة صورها، ذات مرة، على ذاكرتي البعيدة وعلى مشهورين احتفى بأسمائهم وعي شعبي مرتاح في ضاحية دمشقية شبه مغلقة كانت تدعى: «حي الأكراد»، ثم دعيت بغيره. ما جاء اسم قاهري/ مصري إلا ولحق به نعت عالي الصوت: يوسف بيك وهبي عميد المسرح العربي، قامة من أناقة وصوت جهير، والمسرحي نجيب الريحاني، ضحكه باكٍ وبكاؤه يبعث على الضحك، وزوجته -إلى حين- بديعة مصابني، حوّلت الفن إلى تجارة والتجارة إلى فن، و«ملك الفكاهة» إسماعيل ياسين، عشقناه أطفالًا وتأسينا على مآله في بداية الشباب.
وما كان الحال في مجال القراءة و«تهذيب العقل» مختلفًا؛ إذ «الشيخ» طه حسين عميد الأدب العربي، نقرأ كتابه «الأيام» ونستظهره، و«عبرات» مصطفى المنفلوطي يحتفظ بها الطامح إلى «إنشاء بليغ»، وإبراهيم عبدالقادر المازني الساخر المتأسّي على مصير فلسطين، وعباس العقاد في «عبقرياته»، نقرؤها لشهرتها ونفهم منها القليل، وأحمد حسن الزيات ومجلته «الرسالة» الذائعة الصيت، التي عاشت ثلاثين عامًا، بدأت في ثلاثينيات «القرن» وأغلقت في مطلع ستينياته، و«الهلال» مجلة جورجي زيدان، الأشبه «بموسوعة صغيرة»، وجامعة فؤاد الأول يقصدها طلاب علم ميسورون، ناهيك عن جامعة الأزهر، يذهب إليها طلاب «مثلنا» يعودون «مشايخ» يحظون بالاحترام ويباركون غيرهم… كما لو كان ارتيادها يغدق على التلميذ لقبًا ويزيده عمرًا وإجلالًا ونطقًا باللغة عاليًا متمهلًا لا ينقصه التكلّف.
ستأتي صورة أخرى للقاهرة، موئلًا للإبداع الأدبي الحديث مجسدًا في اسمين عامرين بالجدة: يوسف إدريس وكتابة القصة القصيرة المتميزة في مجموعته: «بيت من لحم»، جمعت بين المأساة والسخرية؛ إذ العمى يساوي بين الأجساد المختلفة، والأجساد المحرومة، المختلفة الأعمار، تستدعي الأعمى وتبارك عماه. والروائي نجيب محفوظ الذي عرّفنا على «خان الخليلي»، أنطق شخصيات روايته بمفارقة ماكرة الأقدار، فالوسيم الضاحك لا ترحّب به الحياة، والأعجف الكدر الوجه يتابع حرمانه راضيًا. واعتبر المعلّم الثانوي: «يوميّات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم عملًا روائيًّا بديعًا.
الدخول مبكرًا إلى عوالم القاهرة
دخلتُ عوالم القاهرة مبكرًا، متوسلًا الرواية والسينما، تعرّفت إلى أسماء الأمكنة ومخرجي السينما وملامح قليلة من «الرقابة الفنية». نقل الراحل حسن الإمام والمنعوت بمخرج الروائع رواية محفوظ «قصر الشوق» وخنق فيها أشياء، واختار آخر رواية يحيى حقي: «قنديل أم هاشم» وأعاد كتابتها كما يشتهي، و«أفْلم» الموهوب توفيق صالح رواية صلاح حافظ «المتمردون» ولم ينل رضا الرقابة، وتعامل صلاح أبو سيف مع «القاهرة الجديدة»، رواية محفوظ بعد مرحلته الفرعونية، حاذر الرقابة ودعاها: «القاهرة 30»، احتفظت «القاهرتان» بفساد متين البنيان.
زرت القاهرة مرة أولى صيف 1976م، هربًا من «الحرب الأهلية العربية في لبنان»، بلغة المفكّر اللبناني مهدي عامل، الذي لاحقته أكثر من رقابة ظالمة وقضى شهيدًا. ملأتُ حقيبة السفر بأسطورة القاهرة، ولم أستطع التصرّف بها، وأرجأت التصرّف إلى زيارة قادمة، وبقيت الأسطورة سليمة لم تُمَسّ.
كان صديق لبناني يعمل في دار الفارابي، دار نشر يسارية في بيروت، زوّدني بعنوان «دار الثقافة الجديدة» في القاهرة وقال متفائلًا: لن تضل الطريق، اسأل عن «شارع صبري أبو علم، محمد الجندي» وتجد نفسك وصلت، فالطيور على أشكالها تقع، كان التفاؤل مشروخًا عوّضته صدفة «طيرُها».
عارفٌ بالقاهرة القديمة والجديدة وما بينهما قال: أنا صلاح عيسى، بشوش طويل القامة، ظاهر الوسامة كأنه في عشريناته. تعرّفت إلى مقالاته الجادة في مجلة «الكاتب» التي أدارها فترة أحمد عباس صالح صاحب كتاب «اليمين واليسار في الإسلام» كان عيسى يساريًّا بلا أقنعة أسّس، كما قال لي حركة «حشد» اختصرت حروفها الأولى: «الحركة الشعبية الديمقراطية»، أغلق «أبوابها» بعد حين، ونسي موقع الأبواب لاحقًا. اكتفى بصفة «المؤرخ»، كان مجددًا في مجاله، وخلّف وراءه كتابًا- وثيقة: «مثقفون وعسكر»، هذا إذا كانت الذاكرة بلا ثقوب.

صنع الله إبراهيم
التقيت في «دار الثقافة الجديدة» عجوزًا ناصع التهذيب اسمه «محمد الجندي»، مؤسس الدار، قال آخر يجاوره: «والد الأستاذ شارك في بداية عشرينات القرن في «جمهورية زفتة»»، لم أفهم شيئًا، كانت ربما ثورة شعبية محدودة تطالب بالعدالة. وراء الطرفين كان إنسان مشغول تدثّر بالصمت وبشيء من الشرود، عرفته قبل أن ألتقيه.
الذي بدا شاردًا كان صامتًا، بدا مسؤولًا عن الدار، جمّ الأدب، بقميص «نصف كُم» يدعى: صنع الله إبراهيم صديقًا مقربًا من الصديق السوري محمد ملص، درسا معًا الإخراج السينمائي في موسكو، وقدّم الأول «عملًا تطبيقيًّا» عند التخرّج، لا يزال اسمه يفلت مني: «كل شيء جاهز، كل شيء في مكانه سيدي الضابط». في العنوان ما يسخر من عسكري مترهل الانضباط.
استضافني صنع الله لأيام بكرم لا ينسى. حافظ على اقتصاد الكلام، وأضاف إليه صفات ثلاثًا: دوامه الصباحي على قراءة الصحف، يستقبلها «بكأس من الشاي مع اللبن» وسيجارة عالية الهمّة، وطاولة عليها مقص وأكوام من «قصاصات الصحف»، التي عقدت مع رواياته صداقة دائمة محاكيًا، ربما، الروائي الأميركي جون داس باسوس، وعزلة مستقرة، يخرج من البيت قليلًا ولا يطرق بابه أحد. ذكّرني إيقاع حياته بروايته «تلك الرائحة»، حيث في الهواء حضور عسكري واسع الأذنين، ومحقّق سريع التحقق يذكّر بعسكري آخر صرع القائد الشيوعي المثقف زهدي عطية الشافعي بضربة واحدة، وصفها صنع الله في روايته: «نجمة أغسطس».
ما زلت أذكر أن صنع الله كان يتهاون مع صمته ويفرج عن «ضحكة مفرقعة» وهو يداعب أبناء أخته ويعدهم بزيارة «الميريلاند»، ويداعبونه بدورهم ويدعونه «صنعو»، ويتكوّمون عليه مبتهجين. شعرتُ كما لو كان في «صنعو» طفولة مقموعة وميلًا إلى اختصار الكلام. حين سألته عن رأيه في رواية جمال الغيطاني أجاب: أكتب بشكل يختلف عنه، فإن أشرتُ إلى إدوار الخرّاط، وكان قد نشر روايته «رامة والتنين» قال: لكل منا طريقته. تساهل في الكلام عند وصولي إلى: غالب هلسا.
زرت آنها من القاهرة ما زرته وبقيت أسطورتها مستسرّة. فالأهرام صرح حجري خالد يحجب عذابات الذين بنوه، مثلما ألمحت الراحلة رضوى عاشور في روايتها «أطياف»، والنيل لم يتخفّف من أسراره بعد أن غنّى له عبدالوهاب: «يا نيل يا ساحر الغروب»، وأذكر من «ساحة الأزهر» طفلًا تمدّد على الأرض يكتب «واجبه المدرسي صباحًا»، نظر إليه عبدالرحمن منيف بإشفاق ومودّة. لم نكن نبحث عن أسطورة القاهرة كنا نتأمل معًا حياة المصريين.
للظاهر سطح له سطحه أيضًا
ما يظهر للعيان لا يعوّل عليه، والجوهري لا يتكشّف مرة واحدة، فله ظاهر يحجبه، وللظاهر سطح له سطحه أيضًا. والمحقق أنني ما زرت القاهرة مرة إلا وبحثت عن أسطورة تراوغ الباحث كلما قبض عليها تسرّبت منه. ولهذا قصدت باحثًا بصيغة الجمع، ولم أخرج بتصوّر لا زيغ فيه.
سألت الروائي الراحل خيري شلبي، الذي كان يعرف القاهرة شبرًا شبرًا عن أسطورة مدينته، فأجاب: القاهرة حديقة من البشر مختلفة الألوان والروائح والأشواك، بشر تعرفهم مدينتهم ولا يعرفونها، ولا يسألون عن أسطورة لا تسأل عنهم. أما محمود الورداني الذي ألزمه نشاطه السياسي بالانتقال السريع من مكان إلى آخر، فقال ضاحكًا: أسطورة مدينتنا ما نعيشه ولا نرضى عنه ولا نقبل بالابتعاد منه، إنه تورّط له ملمس شجرة الصندل باردة السطح حارقة القلب. كاتب القصة والرواية يوسف أبو ريّة الذي رحل مبكرًا أجاب: القاهرة، إن كانت لها أسطورة فهي ماثلة في المقاهي والحواري المتقاطعة والمساجد و«الشيشة والسخرية الطليقة»، وليل يمتد في الصباح، وصباح يستأنف ليلًا لا ينام. والريفي المولد نصر حامد أبو زيد الذي أطفأته صدفة عاثرة، قال: القاهرة صعيد في مدينة، ومدينة كأنها في الصعيد. وضحك الصديق جمال الغيطاني وهو يسير في القاهرة القديمة، وهمس: القاهرة من السلطة السياسية التي تحكمها، وأهلها يقدّسون الحاكمين،…
عرفت متواليات من الأسئلة والإجابات أن: أسطورة القاهرة من قاهري عادي قديم، إنسان يسبق صبرُه شقاءَه، وبشاشة وجهه معاناته، ورِضَاؤُه توجُّعَه، أدمن على مساومة الوجود، من دون أسئلة. إنه ذلك المخلوق الطيب القائل صباحًا «خليها على الله»، مقتصدًا بالطلب قانعًا بالمردود، يقول لمن يلتقيه: «الله يكرمك»، فإن كان مجهولًا له أضاف: «وحياة ربّنا» مؤمنًا برب جميع المصريين و«بفرج» يأتي مع الصباح…
تكشّفت أسطورة القاهرة في بسطاء أقوياء الروح يعيدون تعريف البساطة، يصبحون على تفاؤل ويغلقون النهار «بموّال» مرتاح الكلمات. عبّر عن قناعة المصريين يوسف إدريس في مجموعته «أرخص ليالي»، حيث الحرمان لا أظافر له والمرأة دفءٌ وظهير وأغنية عفوية، وأكمل التعبير توفيق صالح في فِلْمه: «درب المهابيل»؛ إذ الحياة رغيف خبز واحتمال مشاكس وعاشق ينتظر ابتسامة مؤجلة الوصول. وتلك التي صوّرها يوسف شاهين في فِلْمه «باب الحديد»، وصاغها من حرمان وأحلام جسّد المسافة بينهما بأنثى ضاحكة تعيش ما يعاش، وتغنّي لما هو منتظر.
كل الأساطير تأتي وتذهب، يخلقها خيال الإنسان قبل أن يعرفها تظل رغبة قبل التعرّف إليها وبعده، يأتي بها سياق ويصرفه آخر، وتحتفظ بغموضها.
كان لنا في زمن الطفولة قاهرة عبدالوهاب يغني: «فلسطين تفديك منا الصدور، فإما الحياة وإما الردى». جاءت بعدها قاهرة «ثرثرة فوق النيل»، وهي رواية لمحفوظ وصفت «عوامة» مخلعة الأطراف، يسحبها التيار ويعد بهزيمة كاسحة عام 1967م.
الأسطورة رغبة تنعقد غيومها في زمن الطفولة، إن ارتفعت الشمس تبقت منها غيوم راحلة. القاهرة مدينة من سحر متعدد الأزمنة، وغموض يثير العقل والقلب، امتدت من عهد الفراعنة إلى زمن ما بعد الحداثة، وتبقّت منها أسرار لا تروّض.

بواسطة فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مايو 1, 2023 | سيرة ذاتية
هل يستطيع فلسطيني أن يكتب سيرة ذاتية؟ يبدو السؤال في البداية بسيطًا قوامه ذاكرة قوية أو معطوبة وقدرة على السرد بلغة أليفة تسعفها القواميس بقبضة من الكلمات لا تعتب عليها قواعد النحو والصرف إلا قليلًا…
بيد أن السؤال لا يلبث أن يصطدم بما يشجّ رأسه لا فرق إن كان الجرح هيّنًا أو فيه ما يثير الألم ويحتاج إلى ضماد. يأتي الجرح من سيرة لا تكتب بصيغة المفرد، ففي مآل المفرد الفلسطيني مآلات وما أصابه وتقاسمه مع غيره عنوانه: نكبة جماعية قذفت بشعب خارج الوطن الذي انتمى إليه. وقد تبدو الإجابة شائكة الأطراف إن كانت علاقة الكاتب بأرضه ضيقة المساحة، كأن تكون النكبة جرفته وهو في الخامسة من عمره، عرف من وطنه القليل وجاءه الكثير من المنفى الذي لم يختره. وما يضاعف الصعوبة عجز الذاكرة، حتى لو رُمّمت، عن الإحاطة بما تقاسمه مع غيره من شقاء ومذلّة، ففي كل لاجئ فلسطيني حكاية، وفي كل حكاية عنف غير متوقع، والحكايات لا تلبي الذاكرة دائمًا.
التصالح بين الحكايات المتناثرة، أو نثار الحكايات، قاعدة تقول: كل ما يستذكره اللاجئ المقهور يصدر عن خارجه، عن وقائع صدمه بها آخرون لم يفقدوا أوطانهم. ففي مبتدأ اللجوء استسلام إلى قادم مجهول، يميط اللثام عن وجهه بمقادير غير متوقعة. إنها لعنة المقارنة بين عوالم اللاجئ وعالم الآخرين الذين يرون فيه لاجئًا، يساوونه بصفة تفقده اسمه، يصبح اللاجئ اسمه الأول، دون أن يصبح أخيرًا. فبعد الصدمة دوار وعثار واختبار يرهق الروح.
تنطوي المقارنة اللعينة على أخرى تخترقها مفارقات، تفصل بين اللاجئ وغيره، فكأنه من البشر وليس منهم، يسائل نفسه بصوت لا يسمعه أحد: كيف كنتُ قبل اللجوء وما أصبحته بعده، وهل كنت بين الزمنين أشبه غيري من غير اللاجئين؟ وماذا تبقى من الصبي القديم الذي له بيت قريب من مدرسة وجار دائم الابتسام، وله أم يمسك بيدها حين تزور في الأعياد قبرًا تغطيه بالريحان وتذرف دمعًا على أخ وحيد رحل قبل العشرين؟ شاقٌّ أن يقسم صبي نفسه على زمنين مختلفين، يبتلع صمته وينزوي بعيدًا. وسواء قبل بحياته أو قبلت به الحياة تلازمه أطياف صامتة، وتصاحبه ذاكرة تستيقظ جريحة حين يوقظها الآخرون وذكريات تمتلكه ولا تنصاع له إلا قليلًا.
تحيل ذاكرة اللاجئ على ذاكرة غافية توقظها واقعة واجهت الغريب، عرف ملامحها في زمن سبق المقارنة الجارحة. كأن يستذكر بستان جدّه لأمه وهو يستمع إلى آخر، لا يقاسمه الغربة، يفاخر بحقل جده الرحيب، ويبالغ في التفاخر، ويشرح للغريب معنى الحقل والأرض الخضراء والجد الوافر الثروة والشاربين. عندها يستذكر الغريب صبيًّا يتسلق منحدرًا جبليًّا مكسوًا بالعنب والزيتون ينتهي إلى حوض مائي إسمنتي الجدران يصبّ فيه مسيل من الماء شحيح. كان جدّي يصنع في نهاية المسيل ورقة تين عريضة تقطر منها حبات ماء صافية. كانت أمي، في زمن الغربة، تفاخر بأرض أبيها، لا تذكر المساحة، وتكتفي بمديح مذاق التين والرمان.
أيقظ ذاكرة الغريب الغافية شعورٌ بالحرمان، أحزنه وإحساس بالاستهانة والإهانة، فأطرق رأسه وعبث بصفحات كتاب قديم طبع في القدس بعد «وعد بلفور»، ألّفه خليل السكاكيني المربي العروبي الفلسطيني الذي تمرد على «الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية». هل كانت رغبة الغريب بالعودة إلى كتاب مهترئ الأطراف ممكنة لولا كلام خارجي اعتبره بلا ذاكرة ولا تاريخ؟ أدمنتُ لاحقًا ترداد جملة الشاعر التركي ناظم حكمت: «المنفى مهنة شاقة يا صاحبي»، كان عنوان رواية ـ مذكرات، أسعدني الحظ، لاحقًا، حين طلب مني السيد غازي بروّ أن أكتب لها مقدمة حين ظهرت مترجمة عن دار الفارابي في بيروت.
قريبًا من قول «حكمت» وبعيدًا منه كانت روحي تقول: اللجوء إهانة وما تبقّى إقامات مؤقتة. لا أمان في الإقامة المؤقتة ولا كرامة في لجوء يلغي اسم اللاجئ ويستعيض عنه بصفة سالبة، تفكك وتركّب وتنتج إنسانًا هجينًا، لا هو بين البشر ولا هو امتداد للشياطين. كان الشاعر توفيق زياد، الذي كان نائبًا في البرلمان الإسرائيلي عن مدينة الناصرة، يقول: الأرض ليست مصدر رزق فقط، إنها هوية، تمنح الفلسطيني اسمًا ووجهًا وأمانًا. كتب جبرا العجوز في لحظة غضب: «فليعلموا أننا أكثر منهم كرمًا وثقافة وكرامة»؟
لا عجب أن يستهل الأستاذ إحسان عباس سيرته الذاتية «سيرة الراعي». «برموز الأمان»؛ إذ في أرض الميلاد خضرة يعانقها المطر يمتد فيها بيت وعائلة ترسل ابنًا إلى المدرسة وتنتظر آخر يعود منها وتتهيأ لسفر ثالث إلى جامعة القاهرة… كانت المدرسة من رموز الأمان، حال الزيتون، الذي يمتد في الجبل ويمتد الجبل فيه، وحال البرتقال قبل أن يصبح حزينًا. لم يصاحب الأمان الطالب الذاهب إلى «جامعة فؤاد الأول»، لم يخذله اجتهاده خذلته النكبة، اجتاحه عسر الحياة وحواجز قيّدت حركته أفرج عنها جواز سفر سوداني بعد حين.
رسائل الفلسطينيين إلى ذويهم
تناثر اللاجئون مع حكاياتهم المتناثرة، عاشوا ما لم يتوقعونه وصار لهم عادات لا يعرفها غيرهم، كأن ينتظروا «برنامج رسائل الفلسطينيين إلى ذويهم في الخارج»، الذي كان يبثه راديو لندن في سنوات تلت التهجير الاجتماعي، وجعل من سماع اسم بعيد «لقيا» مبهجة، كأن يغمرني اسم «عمتي» بالفرح، رفضت الرحيل وانتقلت من الجاعونة إلى حيفا، ولاحقت أخبار عائلتها برسائل تصل ولا تصل، رسائل ترهق روحها وتداعب روحنا وتتوسل الأثير. حين انقطعت رسائلها بكينا، لم ندرِ إن وقعت في اليأس أو ارتاحت إلى رحيل أخير.
امتد نثار حكايات اللاجئين من عام النكبة إلى أعوام نسألها ولا تجيب. وكلما أوغل عنف الزمن تزايدت الحكايات واتّسعت صفات اللاجئين السالبة. كبر أولاد لا يعرفون مقابر أجدادهم، وتهدّم أجدادهم ودفنوا في الغربة، وتعرّف «الإخوة اللاجئين» على سلوك ناحل الأخوة، واشتكوا من غلظة «دَرَك» فقيري اللباس غليظي الهراوات، يعلّمون اللاجئ الانضباط واحترام القوانين وأصول «الضيافة». شاهدت في مرفأ عربي عجوزًا يبكي، واقفًا تحت شمس آب، يتوسل عسكريًّا من حطب ينهره: «ممنوع دخول الفلسطينيين وأنت فلسطيني». يبرز العجوز جواز سفره ويقول: لا علاقة له بفلسطين، انظر إلى ما هو مكتوب على الغلاف، ترفع قطعة الحطب صوتها وتقول: مكتوب فيه أنك من مواليد القدس، يرد العجوز ولدت فيها قبل سبعين عامًا وتركتها عام 1948…، ينظر العسكري إليه بلا مبالاة ويتلفت إلى آخرين،…
وقعت على العجوز لعنة ولادته في «مدينة مقدسة»، كما لو كان في الفلسطيني رجس يمحو كل قداسة ودنس مستطير لا يجيزه الرحمن ولا يرضى به الشيطان. لم يعترف العسكري العربي بالعجوز الفلسطيني لأنه «موظف مخلص»، فالمقدسي فلسطيني والفلسطيني مقدسي وكلاهما من المحرّمات رغم سخاء اللغة العربية!! بل إن عَلَمًا ثقافيًّا يكتب بأسلوب عربي جذل استطرد في القول في نهاية سبعينات القرن الماضي وساوى الفلسطيني بالإرهابي. تكدّس تحت «طائفيّته» وأثنى على الديمقراطية والعلمانية، ولم يسأل هل من علاقة بين الفلسطينيين والطوائف؟

بلدان لا تنقصها عنصرية متمدنة
العجوز الذي سقط على الأرض إعياءً لا اسم له، له صفة عامة لا توحي بالاطمئنان ولا تثير الطائفية فهو فلسطيني أو لاجئ وبما يساويه بأغفال البشر الأشرار. فبالاسم يمتلك الإنسان نفسه وروحه ويصبح كيانًا، وغياب الاسم يضع حدًّا بين الهنا والهناك، بين نحن والآخرين وبين المعترف بهم من البشر و«الهؤلاء»، مثلما يُدعى الأغراب في بلدان لا تنقصها عنصرية متمدنة.
يذكر حسين البرغوثي، الذي رحل مبكرًا، في روايته «نهار أزرق»، عنوانها بالفرنسية، أنه مرّ على بيروت ووصل إلى المنطقة التي يسكن فيها غسان كنفاني، سأل عنه والتقى جوابًا لا ينقصه الاتهام: «هناك، في تلك البناية، يسكن واحد فلسطيني». كان غسان، آنذاك، أديبًا معروفًا ينتظره اغتيال إسرائيلي قريب. لم يشأ جاره أن يعترف باسمه وهو على قيد الحياة وعرفه بعد أن مزّقه الموساد إلى شظايا مع ابنة أخته. واجب الدفاع عن كرامة الإنسان جعل غسان يقول: «الإنسان الذي فاته اختيار لحظة ميلاده يستطيع أن يختار اللحظة التي يموت فيها». كان يشير إلى شيء من العار الفلسطيني، من وجوهه نفي الاسم العلم بهوية ممزقة لا تبعث على الاحترام.
الفلسطينية سميرة عزام صرعتها أخبار هزيمة حزيران 1967م وهي ذاهبة من عمّان إلى دمشق، سجّلت إهانة اللجوء في قصة قصيرة عنوانها: «الفلسطيني» الذي تساقط اسمه العلم ورغب بهوية عادية تعيد إليه ما فقد، فتصرّف بماله القليل واشترى اعترافًا ودون أن يدري أن «الرشوة» في بلد فاسد لا تغيّر من حاله شيئًا. بقي مع صفته السالبة مثلما كان: «هل فتح الفلسطيني دكانه اليوم، واسألِ الفلسطيني عن موعد إغلاق حانوته مساء، وتأكدْ أن أسعار بضاعة الفلسطيني لا غش فيها؟» جمع الفلسطيني ما تبقى من نقود قليلة وسافر إلى بلدان لا توحّد بين اسمه ولجوئه، ولا تعطف على الاسم- اللاجئ تهمًا لا يعرف أسبابها ولا تتحدث بالعربية…
الفلسطيني الذي هُجّر من وطنه في الخامسة يكتب سيرة ما عاشه بعد الوطن، سيرة تحوّله إلى إنسان مختلف، يعرف الفرق بين المواطن واللاجئ وأدرك، مبكرًا، أن المساواة بين البشر درس ركيك في الإنشاء، يستعرض فيه معلّم ابتدائي بلاغته الشاحبة. كان ذلك المعلم الطويل القامة في معطفه الفضفاض يفرش وجهه بابتسامة عريضة ويقول: «لو جنة الخلد اليمن، لا شيء يعدل الوطن»، ثم ينهر ابتسامته ويسأل: «إنت يا فلسطيني ما معنى هذا القول؟»، أجيب: هذا يعني أن وطن الإنسان أجمل من كل الأوطان. يستعيد ابتسامته مرة أخرى ويقول: «كيف عرفت هذا وانت بلا وطن؟». كدت أن أجيب: أعرف هذا لأني بلا وطن، وكنت أخشى أن ينهرني وينهر ابتسامته معًا. وكثيرًا ما كنت أحجب فلسطينيتي المتشكية وراء أقنعة محايدة فلا أنطق بشيء وأنا أستمع إلى «آخر» يمجّد وطنًا لو كان الفقر الروحي والثقافي وطنًا لكانه….
لازمني حتى سنين العمر المتأخرة سؤالان: لماذا أصبحت لاجئًا؟ وهو سؤال هيّن الإجابة، مراجعه القوة التي تهزم الحق، والوهم الذاتي الطارد للحقيقة، وسقوط الأمم التي يسقط فيها «المواطن» قبل أن تسقط الأوطان. والسؤال الثاني: كيف يتكوّن الإنسان لاجئًا في عالميه الداخلي والخارجي؟ والإجابة هنا عنيدة مؤجّلة الوضوح؛ ذلك أن الإنسان، نظريًّا، لا ينفذ إلى قرار ما أصبحه، ينوء تحت وَهْم الذات ومفاجئات الواقع المنفلتة. قال المربي الفلسطيني خليل السكاكيني، الذي سجل يومياته في ثمانية مجلدات وأكثر، في عام 1947م: «ربما يأتي يوم تصبح الخيانة فيه وجهة نظر». ولكن ما هذا النظر الذي يساوي بين اتساع السماء ورطوبة الزنازين المغلقة؟ وما هو جمال الأوطان الذي يفوق جمال اليمن حين كانت سليمة؟
أطياف طفولة مبتورة
إنه الشميم وعري الفتى الشجاع الذي كبر في العراء. شميم الأوطان ما ترسب في ذاكرة «الصبي المهاجر» من أطياف طفولة مبتورة. شميم ميسور الصور يضيف إلى الوطن المفقود من الجمال ما يشاء، فلولا صقع المنفى لما بدا الوطن عامر الدفء والوفاء. ولولا إفقار اللاجئ المعنوي لما نسب الفلسطيني ذاته إلى أرض «ثمارها من ذهب»، ترابها أحمر مدثر بالفضة، بلغة جبرا ابراهيم جبرا وهو يصف «قدسًا» لن يرجع إليها، في مطلع روايته: «صيادون في شارع ضيق».
اللجوء معاناة، والكتابة عن اللاجئ معاناة بدورها. فاللجوء كثير التفاصيل وأرواح اللاجئين لا تتسع لمتاهة. قالت امرأة ثكلى سُوّيت أفراحها بالأرض وهي تنظر إلى صورة ابنها الشهيد: «الله يرضى عليه، حاصروا المخيم أسابيع، قاتل واستشهد وقاتلت معه الحصار ونفدت الطلقات، دفنته تحت الليمونة الوحيدة في الفناء. أشم رائحة ولدي مع الليمون». ما قالته المرأة الواسعة العينين قاله غيرها جيش من النساء الفلسطينيات.
اختصرت حكاية المرأة التي تستنشق رائحة ابنها مع أريج الليمون إشارات فلسطيني غير مرحب به: المخيم، اللاجئ، الشهيد، الحصار، إذ المخيم مكان يجب اقتلاعه يشوّه ضواحي مدن ما هي بالمدن، يهدد توازنًا اجتماعيًّا معطوب التوازن، واللاجئ وجود شائه ومشوّه جدير بالعقاب، والشهيد متطفّل على أرض الآخرين لقي جزاءه، والثكلى فلسطينية تنجب صابرة، وتصبر على فقدان ما أنجبته، والحصار نصيب لاجئين أضاعوا الاتجاهات وأخطؤوا في تحديد معنى الإقامة… الكتابة ذاكرة تسجّل ما تعثر عليه في الطريق، تذهب إلى قارئ يعي أطرافًا منها وتفوته أطراف لم يحسن الكاتب التعبير عنها. ينوس القول الفلسطيني المكتوب بين المجزوء، يصف ما اختبره، والمجهول، فالمعيش اللاجئ يتناثر فوق أقاليم عديدة. تطمح الكتابة إلى بناء تاريخ من حكايات متعددة غائمة التفاصيل، تصل إلى ما استطاعت الوصول إليه ويكون المجهول أكثر اتساعًا. يختلط فيها المعيش بالمراد، والقريب من الوثيقة بما هو ممنوع توثيقه، ذلك المسكوت عنه الذي ينتظر زمنًا لا يخاف من قول الحقيقة.
يكتب اللاجئ سيرة ذاتية منقوصة ويقول: إن مرجع الفلسطيني في ماضيه المستمر لا في مستقبله، ففي كل مستقبل أصوات من حاضر سبقه. يتعرّف الفلسطيني النجيب بالقديم الذي ينتسب إليه، لا بمستقبل هو مزيج من الرغبات والدعوات ووجوه المقاومة المتاحة.









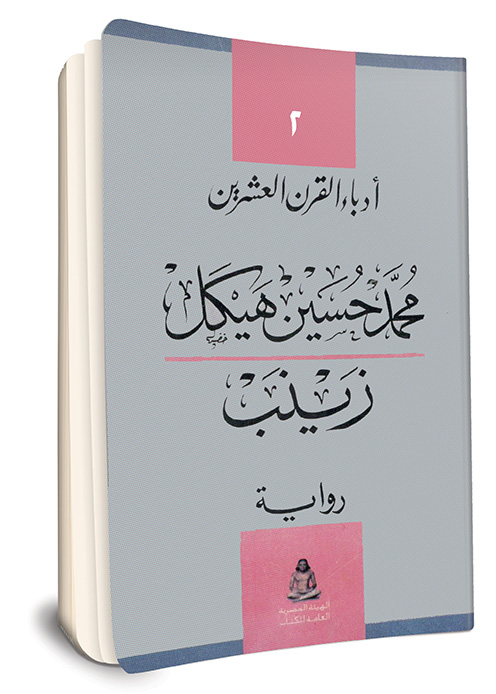 الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.
الريف والعشق المحرّم والوجه الجميل الذي يلامسه الموت مقولات رومانسية تضيء رواية هيكل وفكره وتناقضاته في آن. تتجلّى المقولات في نظر «حامد» الصبي الواعد المبشّر بالتقدم، يرى الريف في قوام زينب ويعشقها كتلميذ طموح أكمل دراسته، يهندس «مستقبلًا» لن يصل إليه. يضطرب نص هيكل أكثر من مرة: فالصبي الواعد يكتفي برغباته، يفلت منه المستقبل يلاحق الفتاة الجميلة إلى قبرها. و«للفلاحين المتآزرين» اشتراكية غامضة، توزّع الفقر عليهم بالتساوي، ولمقولات «روسّو» ليس لها مكان، كما لو كانت زينب فرعونية الجمال سقط جمالها وهي تنصت إلى عشقها المستحيل ذلك أن مجتمع العادات يجهض كل جميل قبل أن يولد.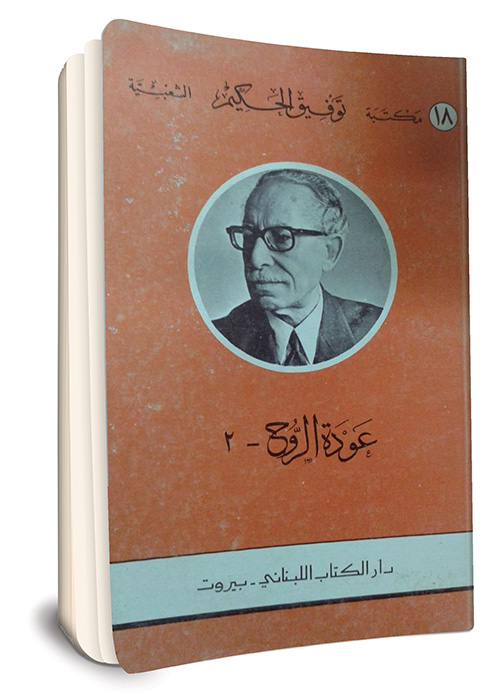 لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.
لن تكون الأنثى في «عودة الروح» إلا روح مصر المضيئة مجلاها الروائي: «سنيّة»، «لها رأس جميل ذو شعر أسود لامع وعينان سوداوان كعيني الغزال ذواتي الأهداب السود الطوال، عينان خلّابتان، فمها وأسنانها كالكأس السحرية، لها نحْر عاجي غاية في البياض يعلوه رأس جميل يلمع كأنه قمر من الأبنوس وهي الظبية الجميلة تضاف إلى جمال الجسد والهيئة والروح…». خلق الحكيم أنثاه المصرية من جمال الوجود وفتنة الكائنات جميعًا، قريبة هي من الظباء والغزلان والقمر وشجر الأبنوس… صورة هي عن «إيزيس القديمة» ذهبت إلى الجامعة وزادت جمالًا. «تحسن القراءة والكتابة وتعزف على البيانو وتحب الغناء وتقص شعرها بشكل حديث…». تضمن الرومانسية المتصوفة الخلق والابتكار ما يتيح استعادة روح أثيلة، بقدر ما تضمن «سنيّة» التجدد المفتوح الذي يذود الأذى عن الأهرام، ويوائم بين مصر القديمة ومصر الجديدة.



