
بواسطة الفيصل | مارس 1, 2024 | الملف
الاعتراف بحق الموريسكيين
مبادرة رمزية من أجل التوافق
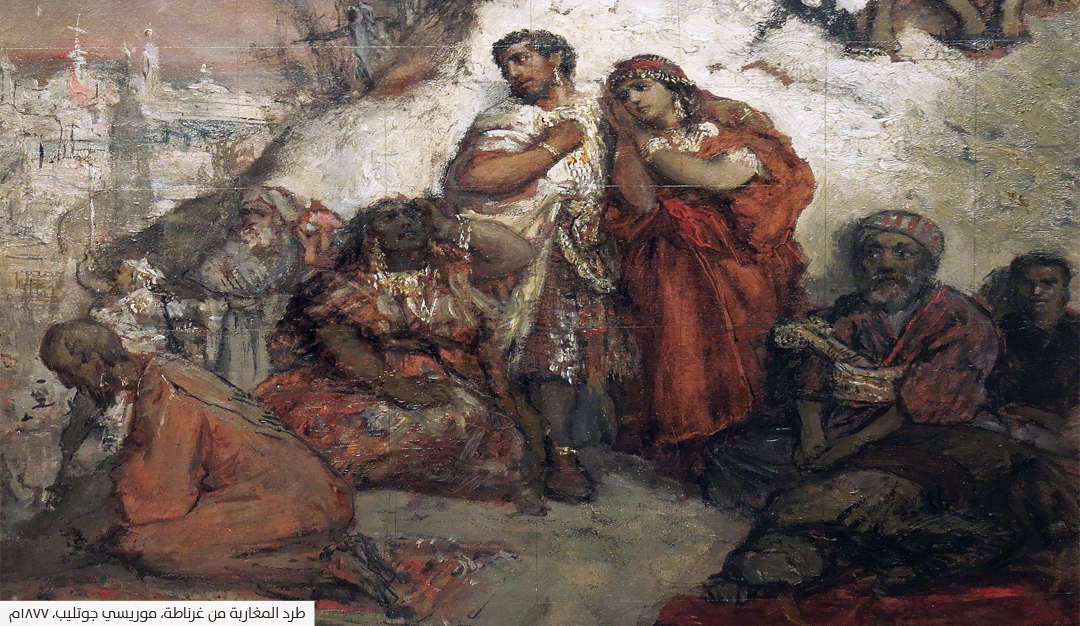
أنطونيو مانويل رودريغث راموس* ترجمة: آنا مارية سانشيز – باحثة إسبانية
كتب بلاس إنفانتي: «أكثر من مليون من إخواننا، من الأندلسيين المطرودين ظلمًا من أرضهم منتشرون من طنجة إلى دمشق! أنا عشت معهم، وعانيت معهم، تطلعت معهم لأمل خلاصنا المشترك؛ لأن هذا الخلاص سيكون مشتركًا، أو لن يكون أبدًا».
مما لا شك فيه أن منح الجنسية الإسبانية للموريسكيين الأندلسيين ليس إلا آلية للحصول على الخلاص الذي تحدّث عنه بلاس إنفانتي. ومع ذلك فإن إنكار هذا الحق، عندما يتم الاعتراف به في حالات مشابهة، كما حدث مع اليهود السفارديم، يعد موضع تساؤل؛ لأنه يُعَدّ تمييزًا واضحًا، ودليلًا آخر على نفور الوطنية الكاثوليكية الإسبانية من البصمة الأندلسية، وبخاصة الإسلامية. وهي الإهانة نفسها التي تقع على الهوية الأندلسية القائمة عبر آلاف السنين على نموذج التنوع. ومن ثم فالقرن الحادي والعشرون يجب أن يكون قرن المطالبة بـ«الأرض والذاكرة… ثقافات متعددة وإنسانية واحدة».
ضرورة عاجلة
وبالتالي فقد بات ضروريًّا وعاجلًا الاعتراف بسلالة الموريسكيين الأندلسيين الذين يعيشون على ثلاث ضفاف، إحداها هنا في إسبانيا، والثانية على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، والثالثة في أميركا اللاتينية، وهم جميعًا منا ونحن منهم. هذه الضرورة ليست إحياء للصراعات القديمة ولا حنينًا إلى الماضي، ولا للمطالبة لبعضٍ بالعفو عن بعضٍ. لكنها على النقيض، كما يقول تودوروف: «فإن إعادة البناء المثالي للذاكرة تسمح باستخدام الماضي بنظرة على الحاضر، وأخذ العبر من الظلم الذي عانوه، مكافحة للمظالم التي تحدث في وقتنا الحالي، وتنحية للذات والذهاب باتجاه الآخر». وبناء على هذا الاعتراف يجب، على الأقل، إدماج مصطلح «الموريسكيين الأندلسيين» في المادة 22 من القانون المدني، إلى جانب السفارديم والمواطنين الذين ينتمون إلى ولايات مرتبطة تاريخيًّا وثقافيًّا بإسبانيا».
سيكون الأمر مثل النظر في المرآة ورؤية الهوية الكاملة للذاكرة الجماعية الإسبانية، وخصوصًا في إقليم الأندلس. ولذلك فإن إفادة شفشاون التي قدمتها في اللقاء الدولي الثاني للتربية والثقافة عام 2006م، حول تحالف الحضارات، ما زالت صالحة فيما يخص حق الأفضلية في الحصول على الجنسية الإسبانية، وذلك لمن يثبت أنه من سلالة الموريسكيين الأندلسيين، وقد قُبِلَتْ كاقتراح وليس كقانون من جانب برلمان إقليم الأندلس. وذلك على غرار مطالبتنا سنة 2010م بجائزة «أمير أستورياس للوفاق» لسلالة الموريسكيين، وذلك حفاظًا على ذكرى وروح الأندلسيين. لقد كررنا الطلبين في مناسبات متعددة، وبخاصة في اللقاءات التي عُقدت في طنجة والرباط في السنوات الأخيرة.
معاملة مماثلة
في سنة 2020م أرسلت مؤسسة «ذاكرة الموريسكيين»، وكان مقرها في الرباط، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية تطالبه فيها بمعاملة مماثلة لتلك التي اعتُرِفَ فيها بالسفارديم، أو على الأقل «برسالة الطبيعة» في المادة 22 من القانون المدني، الخاصة بالحصول على الإقامة. الأمر لا يزيد على مجرد بيان رمزي يتعلق بعدد المستفيدين وما سيترتب لهم من امتيازات. وهذا في رأيي هو المفتاح. فقد قال لي صديق أندلسي: إنه انتظر مدة طويلة، وإنه لا يهمه أن ينتظر أكثر، طالما أنه سيُمنح هذا الحق من القلب؛ لذا من المهم تذكّر القيمة الرمزية لهذه المادة، فكما قلنا في بيان شفشاون، ذلك تطبيق ضروري للعدالة والذاكرة، وهذا ما عبّر عنه خوسيه أنطونيو بيرث تابياس في عرضه للاقتراح في الكونغرس عام 2009م، حول «تفعيل الذاكرة وتطبيق المسؤولية مع السلالة والورثة الثقافيين لهذه المأساة، التي تمثلت في الطرد الوحشي للموريسكيين من إسبانيا، ومن ثَمّ استعادة الذاكرة التاريخية لشعب خضع للحرمان من التعايش، واستخلاص نتائج خاصة بالمستقبل، وتعزيزًا للوعي الوطني من عواقب التعصب وعدم التسامح والعنصرية الاجتماعية والثقافية، ومنعًا لانتشار التحيزات الخطيرة الجاثمة في الخيال الاجتماعي».
إن مجرد إضافة مصطلح «الموريسكيين الأندلسيين» إلى القانون المدني يعد ثورة أو بادرة لتعزيز العدالة التاريخية مع سلالة أجدادنا المنفيين، ومع ذاكرتنا الجماعية الخاصة.
* ناشط سياسي من أصول موريسكية، وأستاذ القانون المدني في جامعة قرطبة.
كيف ينظر الإسبان إلى الموريسكيين اليوم؟

صبيح صادق – باحث عراقي جامعة أوتونوما – مدريد
في يوم الثلاثاء، الثاني من شهر يناير، 2024م، أحيت مدينة غرناطة -ضمن احتفالات ضخمة بإشراف بلدية المدينة، كما هي الحال في كل عام- ذكرى إسقاط آخر مملكة عربية في إسبانيا، عام 1492م، وبسقوطها أسدل الستار على الحكم العربي في شبه الجزيرة الأيبيرية، لكن الوجود العربي وتأثيره ظل مستمرًّا.
لقد استطاع الموريسكيون الإبقاء على دينهم ولغتهم وعاداتهم وممتلكاتهم وأعمالهم في الحقبة الأولى بعد سقوط غرناطة. لكن ذلك لم يستمر طويلًا، فسرعان ما بدأ التضييق عليهم وبدأت حملة لإجبارهم على ترك الإسلام وعدم استعمال اللغة العربية ومُنعوا من تداول الكتب العربية، وأُحرِقَت كثير من الكتب العربية والمكتبات، فاضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد والاتجاه نحو الدول الأخرى وبخاصة شمال إفريقيا، بينما فضل آخرون البقاء في أرض آبائهم وأجدادهم، والقيام باحتجاجات وثورات ضد السلطة. وبعد صدامات عديدة، قرر الملك الإسباني فيليب الثالث طرد الموريسكيين عام 1609م من إسبانيا، وبدأت حملة مداهمات وملاحقات واضطر عندها الموريسكيون إلى الهروب بينما قرر آخرون التحول من الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي، وبمرور الزمن ذاب الموريسكيون في المجتمع الإسباني، ولكن بعضهم استطاع الحفاظ على بعض آثار عائلته، اعتزازًا بكونه عربي الأصل، أما الذين غادروا إسبانيا فلم يكن حظهم أفضل من أولئك الذين لم يغادروها، فقد لاقوا مصاعب كثيرة، لكن كثيرًا منهم استطاع الاحتفاظ بالهوية الموريسكية التي عاشها أجداده.
وعلى الرغم من طردهم من الأراضي الإسبانية، فإن التأثير العربي استمر في إسبانيا ولا يزال، وما وجود مثل هذا الاحتفال المناوئ لمملكة غرناطة الذي يحتفي بسقوط مملكة غرناطة، إلا دليل على أن التاريخ العربي لا يزال ماثلًا أمام الإسبان.
في إسبانيا تثار بين حين وآخر مسألة منح المجموعات التي طردتها إسبانيا، مثل العرب واليهود، الجنسية الإسبانية، وقد تحقق منح أحفاد اليهود، الذين طردوا، الجنسية الإسبانية المزدوجة، بقرار صدر عن الحكومة الإسبانية عام 2015م، ولم يصدر قرار مماثل فيما يخص العرب المطرودين من إسبانيا، الذين أطلِق عليهم اسم «الموريسكيين». ولا يزال كثير من الشخصيات والتجمعات تطالب بمنح الموريسكيين المتفرقين اليوم في دول عديدة من العالم، وبخاصة في شمال إفريقيا، الجنسية الإسبانية، أسوة بقرار الحكومة الإسبانية الذي منح أحفاد اليهود المطرودين الجنسية الإسبانية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، لكن فكرة منح الموريسكيين الجنسية الإسبانية لا تزال تلقى كثيرًا من الصعوبات والعراقيل.
احتفال رسمي وشعبي بذكرى إسقاط مملكة غرناطة
كما هي الحال في كل عام جرت العادة أن تبدأ الاحتفالات في بلدية المدينة بين العاشرة والحادية عشرة صباحًا. يتوجه ممثلون عن البلدية إلى الكنيسة الملكية، وهم يحملون العلم الرسمي مع استعراض عسكري رسمي، يقطع شارع الملكة إيزابيل الكاثوليكية ثم شارع غران بيا، متجهًا نحو الكنيسة حيث يرقد جثمانا إيزابيل وزوجها فرناندو، مع حضور كبار شخصيات المدينة. ومن ثم يُعقد قداس تحت رعاية رئيس الأساقفة، ثم يوضع إكليل غار وباقة من الزهور على قبر إيزابيل وفرناندو، تخليدًا لهذه الذكرى، وهي سقوط مدينة غرناطة.
من جهة أخرى، هناك كثيرون يعارضون عدّ هذا اليوم يومًا لغرناطة، ولا يحبذون الاحتفال به، كالجاليات الإسلامية التي تعدّه يومًا لبداية انهيار الوجود الإسلامي في إسبانيا، ثم طردهم نهائيًّا منها عام 1609م. ويعارض الاحتفال بهذا اليوم أيضًا ناشطون في حقوق الإنسان، مثل جمعية غرناطة العلمانية، وجمعية «أوقفوا العنصرية». وفي عام 1995م تقدم عدد من المفكرين والفنانين ببيان أعلنوا فيه معارضتهم الصريحة لهذه الاحتفالات، ومنهم خوان غويتيسولو، وأنتونيو غالا، وروجيه غارودي، وأمين معلوف، ولويس غارثيا مونتيرو وغيرهم.

التصادم بين الرأيين
وفي احتفال هذا العام، 2024م، تجمهر الأهالي أمام بلدية المدينة لحضور الحفل بذكرى سقوط غرناطة، وفي الوقت نفسه كانت هناك مجموعة المعارضين للاحتفال بذكرى سقوط مملكة غرناطة العربية، وهي مجموعة «منصة غرناطة المفتوحة»، رافعة شعار «من أجل التعايش، لا للاحتفال بسقوط غرناطة».
وفي حفل هذا العام، قالت رئيسة بلدية غرناطة ماريفران كاراثو، وهي من الحزب الشعبي الحاكم في المدينة: «هذا يوم عيد، إنه المؤشر لتاريخ الغرناطيين. غرناطة يجب أن تزدهر وأن تنظر إلى المستقبل، ولكن لا يمكنها أن تترك الإشارة إلى تاريخها وإلى تقاليدها»(١).
وفي المقابل، هناك تجمعات تعارض الاحتفال بسقوط غرناطة وتعدّه إهانة للغرناطيين. في هذا السياق نذكر ما قالته الناطقة باسم تجمع «الأندلس إلى الأمام» تيريسا رودريغيث: «يحتفل اليوم المتطرفون باستعادة غرناطة. إن اليمين المتطرف يؤسس اتجاهًا ضد الإسلام وضد الأندلس… إنهم من الجهلة العنيدين من العنصر الأبيض والمسيحي الذي لا يوجد إلا في أحلامهم الغارقة في الفاشية».
وعلقت على دعوة حزب «بوكس» اليميني بعدم منح الجنسية الإسبانية للمسلمين: «إن عدم منح الجنسية الإسبانية بسبب أي مظهر من مظاهر الثقافة الإسلامية يعني إلغاء منارة الخيرالدا (في إشبيلية)، وقصر الحمراء (في غرناطة)، والمسجد (في قرطبة)، وكذلك الفلامنكو، وحلاوة بيستينيو، والتوابل والزيتون من الثقافة الإسبانية»(٢). في إشارة واضحة إلى أن كل هذه الأسماء التي ذكرتها هي من نتاجات الثقافة الإسلامية في الأندلس، وتشكل اليوم جزءًا من حضارة إسبانيا وتاريخها.
آراء تؤيد طرد الموريسكيين
بعد سقوط غرناطة عام 1492م، شاعت روح الفخر عند كثير من الإسبان بأنهم استطاعوا أخيرًا، بعد ثمانية قرون، إسقاط الحكم العربي وتوحيد إسبانيا. وقد عكست أغلبية آراء المؤرخين والكتّاب تلك الروح المعادية للعرب وضرورة الخلاص منهم، لكن هذه الروح بدأت تخفت، وأخذ بعضهم يعترف بالمظاهر الحضارية للأندلسيين، لكن الاتجاه العام كان يميل إلى ضرورة طردهم من إسبانيا. وفي القرن التاسع عشر بدأت بوادر لتيار يدعو إلى إنصاف العرب ويدعو للنظر في تاريخهم، نظرة بعيدة من التطرف العنصري أو الديني. وبمرور الزمن ازداد هذا التيار قوة عندما أخذ الكتاب والباحثون بالكتابة حول الحضارة الأندلسية يصفونها بأنها متميزة ولها تأثير حضاري ليس فقط على إسبانيا وإنما على أوربا أيضًا.
ومن بين شخصيات هذا التيار الذي أيد طرد الموريسكيين، تظهر أسماء لها شأن كبير في الثقافة الإسبانية. وهنا نعرض رأيين لشخصيتين مشهورتين حول هذه المسألة. الأول الكاتب مارثلينو منندث بلايو (1856- 1912م)، وهو سياسي ومؤرخ وباحث أدبي ولغوي مشهور في إسبانيا. كتب أنه يؤيد قرار طرد الموريسكيين من إسبانيا ومن أوربا:
«لا أتردد في الإعلان بأنني أتبنى الالتزام بإكمال الواجب فيما يتعلق بقانون تاريخي (طرد الموريسكيين)، وآسف لتأخرهم في القيام به. هل كان من الممكن وجود الطائفة المحمدية بيننا، وفي القرن السادس عشر؟ الجواب بكل وضوح لا، ولا في أي مكان في أوربا الآن»(٣).
ومثال آخر، للكاتب غريغوريو مارانيون (1887- 1960م) وهو عالم موسوعي، مؤرخ وطبيب مشهور، نراه يدافع عن فكرة إجبار الموريسكيين على ترك عاداتهم وتقاليدهم ودينهم، كتب يقول في كتابه «طرد وهجرة الموريسكيين الإسبان»: «لو أنه قد تم السماح للموريسكيين كي يختاروا بحرية دينهم، وعاداتهم، إلخ، لازداد تحطيم إسبانيا بشكل عميق أكثر مما كانت عليه»(٤).
إنصاف العرب
وفي المقابل، نرى أن كثيرًا من الباحثين أنصفوا الحضارة الأندلسية والموريسكية، ومن الصعب الوقوف عند جميعهم، ولكن سنتوقف عند ثلاث شخصيات إسبانية مهمة ومشهورة دافعت عن العرب والموريسكيين، وهم: أكبر شاعر في عصر الرومانسية الإسبانية، غوستابو أدولفو بيكر (1836- 1870م)، وفدريكو غارثيا لوركا (1898- 1936م) الشاعر ذو الشهرة العالمية الذي قتل في بداية الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936م، والفنان كارلوس كانو (1946- 2000م) الذي تغنى بالوجود العربي في إسبانيا.
وأول هؤلاء، غوستابو أدولفو بيكر، عاش في القرن التاسع عشر، وهو العصر الذي كان لا يزال فيه الإسبان يميلون إلى انتقاد السيطرة العربية على إسبانيا، فاعترض بيكر على هذا الاتجاه، وحاول الاستناد على بحوث مؤرخ معروف كان يوضح ويشرح حضارة العرب الأندلسيين، وهو أمادور دي لوس ريوس وكذلك مجموعة أخرى من الباحثين.
يقول غوستافو أدولفو بيكر: «إن السيد خوسيه أمادور ده لوس ريوس، وعددًا آخر من الكتـّاب معه، كما ذكرنا ذلك سابقًا، يأسفون بمرارة أن يستمر حتى اليوم التقليل من مكانة العرب، وبالذات من قبل أشخاص من ذوي المكانة العلمية المرموقة، فهم يزدرون بقايا الآثار الرائعة التي تعود إلى عصر السيطرة العربية… ومن بين هؤلاء الذين يحتقرون العرب العالم اليسوعي ماريانا، في كتابه تاريخ إسبانيا العام، فهو من الذين تأثروا بنظرة القلق والنفور السائدين في عصره من العرب إلى درجة أنه يطلق تعبير «أوغاد» على شعب كان له دور مشرق وثقافة وبطولة لم يقدرها أحد حق قدرها»(٥).

فدريكو غارثيا لوركا
أما فدريكو غارثيا لوركا، فهو من أبرز أدباء إسبانيا، وله شهرة عالمية، وكان معروفًا بحبه للعرب وللموريسكيين، ويفخر بأنه غرناطي ينتمي إلى الماضي العربي. جاء في مقابلة صحفية معه، عام 1931م، ما يلي: «لكوني من غرناطة فإنني أشعر بالميل المتفهم والمتعاطف مع الملاحقين: الغجر، السود، اليهود.. الموريسكي، فكل هؤلاء نحملهم في داخلنا»(٦).
كان اعتزاز لوركا بكونه من غرناطة شديدًا جدًّا، ولا بأس من ذكر حادثة رواها صديقه سباستيان كاش عندما كان لوركا في برشلونة عام 1927م، وفي عصر أحد الأيام صاحب كاش صديقه لوركا إلى مجمع برشلونة، وهناك قام كاش بتقديم لوركا إلى الأعضاء المتحدثين، وهم حسب تعبيره «الأكثر شهرة ورعبًا». يقول كاش:
«بعد التقديم المتقن وكلمات المجاملة الموجزة، سأل أحد المتحدثين لوركا باللهجة نفسها التي كما لو كان قد تقدم للحديث مع شخص غريب:
– من أين أنت، أيها الشاب؟
في تلك اللحظات، في وقت دكتاتورية الجنرال بريمو دي ريبيرا، كان الشعور القومي الكتلاني من التعصب بمكان. لوركا الذي لم يكن بتلك البلادة، التقط في الحال معنى النية المتعصبة للسؤال، فرفع ذراعه فقط، كما كان يفعل كعادته عندما يتعلق الأمر بمسألة مهمة، وأجاب محاوره بلهجة، بين التحدي والافتخار: «أنا من مملكة غرناطة»»(٧).
في إشارة إلى أنه ينتمي إلى مملكة غرناطة العربية.
الفنان كارلوس كانو
اشتهر الفنان كارلوس كانو بكونه عاشق الأندلس، وكان يكتب القصائد التي يغنيها بنفسه، متحمسًا إلى أن للأندلس تاريخًا عربيًّا مشرقًا، وعكس ذلك في كثير من أغانيه. ففي «على ضفاف النهر» يشير إلى زوجة المعتمد ملك إشبيلية المعروفة باسم «اعتماد الرميكية»:
«مَن زهرة الدفلى البيضاء هذه التي تغني على ضفاف النهر؟ شفتاها سمراوان، شمس تختفي خلف الخمار، يا رميكية يا مليكتي هلا تحبيني، انظري فها أنا أعيش حياتي كي أكون عبدًا لحبكِ، عربية عربية عربية. آه يا ملكتي العربية».
وتعلق كانو بشخصية عبدالله الصغير آخر ملوك غرناطة وعدّه رمزًا للحزن. يقول في «قصيدة لعبدالله الصغير»: «وجدتُ الحزن في قعر الصهريج، الحزن الذي قتل الملك عبدالله، وعلى ظلال شجرة اللوز تركته هناك على تلال وجار».
وكتب كانو مرة: «إذا كانت كلمة (الحزن) لم تأخذ شكل حروفها هذه، فإنها بلا شك كانت ستأخذ شكل الكلمات التي تُعبر عن الحزن وهي كلمة (عبدالله)».
اعتبر كانو اللغة العربية لغة أجداده، وبعد سقوط غرناطة لم يعد من حقهم الكلام بالعربية، ولهذا نسي هو وأجداده تلك اللغة، وفي إحدى جولاته في المغرب طلب الجمهور منه أن يغني باللغة العربية وهو لا يتكلم العربية، وهو الذي يشعر بأن غرناطة عربية، وأنه من هذه المدينة، فأجابهم: «عفوًا، لم أتكلم بهذه اللغة (العربية) منذ 500 سنة، لقد نسيت لغتي».
اهتمام الباحثين والكتاب بقضية الموريسكيين
إن اهتمام الباحثين والمؤرخين والكتاب والمترجمين في تصاعد مستمر، وبخاصة في المدة الأخيرة حول الموريسكيين، وهي ظاهرة مشكورة. ومن جملة من كتب عنهم: محمد عبدالله عنان، وصلاح فضل، وسلطان محمد القاسمي، ومحمد عبده حتاملة، وسرى عبداللطيف، وجمال عبدالرحمن، ومحمد محمد عبدالسميع، وإسماعيل سراج الدين، ومحمد أحمد خليفة أحمد، ومروة محمد إبراهيم، وعبدالعال صالح، وعائشة محمود سويلم، ووسام محمد جزر، ومولاي أحمد الكمون، وهاشم السقلي، وعبدالله جبيلو، وعبدالله محمد جمال الدين، وعبدالله حمادي، ومحمد حسن العيدروس، ومحمد الصاوي، وإدريس الجبروتي، ومحمد القاضي، وجمال عبدالكريم، وكنزة الغالي، وأريج طيب خطاب، ومحمد طيب خطاب، وأحمد حمروني، وعبداللطيف مشرف، ومحمد قشتيليو، وقاسم عبد سعدون، ونعيم ناصر، وصالح حسب الله، ومنصور عبدالحكيم، أحمد شهيد، وغيرهم.
وفي الوقت نفسه هناك اهتمام من قبل الإسبان بموضوع الموريسكيين، ومن ضمن تلك الأسماء التي درست الموريسكيين: داريّو كابانيلاس، ومرثيدس غارسيا أرينال، وأنتونيو مانويل، وسيرافين فانخول، وماريانو دي بانو أي رواته، وبيدرو لونغاس، وميغيل أنخيل بونس إيبارا، وغونثاليث بوستر، وميغيل دي إيبالثا، ودومينغيث أورتيث، وبرنارد فينسينت، وغييرمو غوثالبيس بوستو، وفرنثيسكو ماركيث بيانوبيا، وإميليا غارثيا بالديكاساس، وأنتوني دومينغيث أورتيث، وخوسيه باسكوال مارتينيث، وتوليو البرين، ولويس رودريغيث غارثيا، ومانويل فرناندث جابيس، ورافائيل بيريث غارثيا، ومانويل دابيلا أي كوجادو، وإنريكه سوريا، وأنتونيو لويس كورتس، ومانويل لوماس، وخورخه أنتونيو كاتالا، وسيرخيو أورثاينكي، وأنطونيو دومينقير، وباسكوال بورونات، ولويس بونس، ومانويل بيجار، وميغيل أنخيل سان ميغيل، ورودريغو ده ثاياس، وخوليو كارو، وغيرهم.

نشاط الروائيين العرب
من الظواهر التي تلفت النظر في السنوات الأخيرة ازدياد اهتمام الروائيين العرب بموضوع الموريسكيين، فبعد أن نشرت رضوى عاشور «ثلاثية غرناطة»، التي صدرت عامي 1994- 1995م، عن دار الهلال، أخذت مجموعة من الروائيين العرب بالاهتمام بتناول موضوع الموريسكيين. وفي عام 2019م قدم الأستاذ حسني مليطات رسالته لنيل الدكتوراه من جامعة أوتونوما في مدريد، حول الـمـتخيل الموريسكي في الرواية المعاصرة، الإسبانية والعربية، وفيها درس وحلل روايات عربية وإسبانية عدة تناولت موضوع الموريسكيين، مثل: رواية «حصن التراب» لأحمد عبداللطيف، و«الموريسكي الأخير» لصبحي موسى، و«بيت الكراهية» لمحمد برهان، و«الحواميم» لعبدالإله عرفة، و«الأندلسي الأخير»، و«على أعتاب غرناطة» لأحمد أمين، و«رمل الماية»، و«حارسة الظلال- دون كيخوت في الجزائر»، و«المخطوطة الشرقية»، و«البيت الأندلسي»، و«جُملكية أرابيا»، و«سيرة المنتهى- عشتها كما اشتهتني» لواسيني الأعرج. و«جزيرة البكاء الطويل» لعبدالرحيم الخصار، و«الموريسكية» لحسنين بن عمو، و«سر الموريسكي» لمحمد العجمي. وكذلك روايات مكتوبة بالإسبانية لـ: ميغيل أنخيل سان ميغيل، وروسا مانويل بيجار، وخوسيه ماريا بيريث ثونيغا، ورودريغو ده ثاجاس، ومانويل ثيبريان إبيجان، ومونتسرات كانو. ورواية «الموريسكي» لحسن مريد، المكتوبة بالفرنسية وترجمها إلى العربية عبدالكريم جويطي.
في عام 2020م أصدر الدكتور مراد منصور الأستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء روايته عن الكاتب الموريسكي ألونسو دل كاستيو، وهي بعنوان: «ترجمان الملك، سيرة ألونسو دل كاستيو»، طنجة، دار سليكي أخوين، وفيما يخص الموريسكي ألونسو دل كاستيو، نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، عام 2023م، مخطوطة ألونسو دل كاستيو حول كتابات قصر الحمراء التي نقلها ألونسو بنصها العربي وترجمها إلى الإسبانية.
نشاطات أخرى
وفي عام 2023م عقد في إسبانيا مؤتمر حول الموريسكيين حضره عدد من الباحثين الأوربيين، ومن العرب شارك الدكتور أحمد شهيد تعبان والدكتور مرتضى كمال حريجة. ولا بد من التنويه إلى جهود الأستاذ عبدالجليل التميمي في تأسيسه مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، في تونس، وهو المركز الذي تحول عام 1995م إلى مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، وللأستاذ التميمي باع طويل في مجال الدراسات الموريسكية وتاريخ المغرب العربي.
نهاية الموريسكيين الحزينة
هناك أغنية موريسكية، وصاحبها موريسكي من مقاطعة أراغون، أرسلها إلى صديق له في طليطلة، يبين له قرب طردهم من إسبانيا إلى شمال إفريقية، تقول الأغنية:
«قالوا إنه وجب علينا أن نرحل/ نحن أيضًا من هذه الأرض/ نحو تلك الأرض الطيبة/ حيث الذهب والفضة الرقيقة/ يوجدان من جبل إلى جبل/ إنهم يهددوننا بالطرد/ لنذهب كلنا إلى هناك/ حيث توجد جماعات العرب/ وحيث توجد كل الخيرات هناك»(٨).
ويصف مؤلف مجهول اللحظات الأخيرة لطرد الموريسكيين بقوله: «فلما نظر الروم إلى المسلمين قد شرعوا في الجواز ورحل أكثرهم وما بقي منهم إلا القليل أظهروا لهم حسن المعاملة، فوعد الباقون من المسلمين أن يدخلوا في دين النصرانية عام أربعة وتسع مئة، فدخلوا كرهًا إلا من أخفى الإسلام، وضربت النواقيس في صوامعها ونصبت الصلبان في جوامعها وأكلت الجيف وشربت الخمور! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! لمثل هذا فلتبك كل عين فياضة بدموع الدم»(٩).
إسبانيا والمسلمون وحروب الاسترداد…
آليات إنتاج الصورة

إدريس الكنبوري – باحث مغربي
إن التطرق إلى موضوع التصورات الإسبانية عن الإسلام والمسلمين في القرون الوسطى يتطلب أولًا البحث في علاقة الثقافة المسيحية الإسبانية بنظيرتها الأوربية خلال تلك الحقبة، ومعرفة حدود هذه العلاقة، وطرح تساؤل منهجي، وهو: هل كانت التصورات الإسبانية عن الإسلام والمسلمين حصيلة التجربة التاريخية مع الأندلس، أم تشكلت بتأثير أوربا في صراعها مع الإسلام ورؤيتها للمسلمين؟
مفهوم حروب الاسترداد في إسبانيا ومقدماتها العقدية
لم يظهر مفهوم «حروب الاسترداد» في الكتابات التاريخية الإسبانية -للإشارة إلى طبيعة الصراع بين المسلمين والمسيحيين في إسبانيا- إلا في القرن الثامن عشر الميلادي، كإطار تفسيري لفهم مرحلة القرون الوسطى في شبه الجزيرة الأيبيرية، بوصفها مسلسلًا شاقًّا وطويلًا لبناء «الذاتية» الإسبانية، واسترجاع ما يسميه المؤرخون الإسبان «إسبانيا الضائعة» أو «ضياع إسبانيا» (La pérdida de España).
لقد رأى المسيحيون الإسبان أن غزو/ فتح العرب لإسبانيا يشكل انعكاسًا للعنة إلهية حلّت بهم نتيجة عصيانهم وخروجهم عن جادّة الدين الحق في نظرهم، وهو ما دفع الرب إلى تسليط العرب عليهم وغزو بلادهم. وقد كان هذا التفسير العقدي للفتح العربي ممهدًا للتفسير العقدي لحروب الاسترداد التي يقول المؤرخون: إنها بدأت مباشرة بعد الفتح العربي عام 711 للميلاد. بل يرى المؤرخون الإسبان أن المرحلة الفاصلة بين الفتح العربي، وسقوط غرناطة وخروج المسلمين من الأندلس عام 1492م تشكل كلها مرحلة حروب الاسترداد وبناء الهوية الإسبانية المفقودة(١٠). إن حروب الاسترداد لم تكن سوى عمل لاهوتي ناتج عن خطط إلهية، ومن ثمة فإن هذه الحروب لن تنتهي إلا عندما يأذن الله بذلك. ويرى أحد رجال الدين المسيحي من الإسبان أن مكافحة المسيحيين للمسلمين والعرب ستنتهي فقط «حينما تقتضي عناية الرب طردهم دون رحمة من إسبانيا»(١١).
تشكل حروب الاسترداد مفهومًا تاريخيًّا يعود إلى مرحلة قديمة، عندما وضعه الملوك الكاثوليك الإسبان والمثقفون الذين كانوا يحيطون بهم من أجل إضفاء الشرعية على حروب استعادة الأراضي التي كان يحتلها المسلمون. وفي قرون لاحقة لم يكن لهذه الحروب طابع ديني، وإن كان لها طابع شبه مقدس، وكان الهدف منها هو إعادة توطين الكنيسة في تلك الأراضي لكونها، في نظرهم، أرضًا مسيحية. غير أنه بدءًا من النصف الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد وقع تحول كبير في مفهوم حروب الاسترداد؛ إذ دخلته عناصر أيديولوجية نابعة من الحروب الصليبية التي كانت قد بدأت في أوربا، وهو الأمر الذي أغنى هذا المفهوم بمضامين جديدة وأعطاه طابعًا صليبيًّا. فقد بدأ المسيحيون الإسبان يعتقدون أن القتال لاستعادة الأندلس يشكل جزءًا من الحرب الصليبية في أوربا بدءًا من القرن الحادي عشر؛ إذ كانوا يريدون إدراج تاريخهم الديني الخاص ضمن التاريخ الديني العام لأوربا، بعد قرنين من الانعزال عن الكنيسة الرومانية بسبب رغبة ملوك القوط في الاستقلال بأنفسهم.
ويقول بعض المؤرخين: إن المسيحيين الإسبان الذين كانوا يتوجهون إلى الشرق الإسلامي للقتال إلى جانب المسيحيين الأوربيين في الحرب الصليبية، قبل تلك الحقبة، كان ينظر إليهم في إسبانيا نظرة احتقار إثر رجوعهم من ساحات الحرب، ويرجع الباحثون ذلك إلى أن تأثير البابوية في إسبانيا كان ضعيفًا؛ كما أن الإسبان كانوا يرون أن البابا لا يمكنه منافسة السلطة الملكية في إسبانيا. ويوضح باحث إسباني أنه بعد استعادة طليطلة عام 1085م أصبحت القيم المسيحية التي يدافع عنها الملوك الكاثوليك الإسبان منتشرة في العالم المسيحي كله(١٢). وبرز الاهتمام بحروب الاسترداد الإسبانية لدى روما المسيحية، وقد وجه أوربان الثاني بعد استعادة طليطلة إلى المسيحية رسالة إلى ملك إسبانيا يهنئه بذلك العمل، ويعترف فيها بأن العالم المسيحي أصبحت تحكمه سلطتان: روحية وزمنية. الروحية التي تقودها الكنيسة ورجال الدين، والمدنية التي يقودها الملوك الكاثوليك الإسبان، وكان ذلك أول اعتراف للكنيسة بسلطة الملوك الإسبان بحيث أصبح لقبهم بعد ذلك هو الملوك الكاثوليك، تشريفًا لهم بسبب الحروب التي يخوضونها ضد «الكفار» أي المسلمين.
وبدءًا من القرن الحادي عشر سعت روما إلى بسط نفوذها الروحي في إسبانيا عن طريق تحويل حرب الاسترداد إلى حرب صليبية تتم تحت السلطة الروحية للبابا، وقد سعى بعض المثقفين الإسبان منذ بداية حروب الاسترداد إلى جعلها تحت مظلة الحرب الصليبية حتى لا تبقى إسبانيا على هامش أوربا. والملحوظ أن هذه المسألة أثيرت في بدايات القرن العشرين لدى ظهور مدارس تاريخية تحاول البحث عن جذور الهوية الإسبانية، وربطها بالمسيحية ومحو أي صلة لها بالهوية الإسلامية للأندلس طوال ثمانية قرون. فقد كان الهدف من ربط حروب الاسترداد بالحروب الصليبية هو صهر تاريخ إسبانيا ضمن التاريخ الأوربي العام، ومحو أي حديث عن خصوصية التجربة الإسبانية في علاقتها بالإسلام.

وفي الحقيقة، مثلت إسبانيا لأوربا المسيحية في القرون الوسطى «حالة نموذجية» للعلاقة الصدامية بين الإسلام والمسيحية.
وفي المدة ما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر شكلت إسبانيا «نقطة جذب» للكهنة والعمال والمحاربين القادمين من أوربا في العصور الوسطى، وإحدى المناطق المفضلة لـ«انتشار الغرب»، كما كانت رمزًا لانتصار المسيحية الرومانية على الإسلام، وشكلت مختبرًا لمفاهيم «الحرب المقدسة»، و«الحرب الصليبية» لمسيحية أوربا. ويرى بعض المؤرخين، ومنهم الدكتور قاسم عبده قاسم، أن الحملة الكاثوليكية ضد مسلمي الأندلس شكلت ما يمكن وصفه بـ«السابقة الصليبية» على المستوى الأوربي، بيد أن غياب الدور البابوي النشط في هذه الحروب ينفي عنها صفة «الحملة الصليبية» الكاملة(١٣). ويوضح عبده قاسم أن مفهوم الحج التكفيري، الذي بدأت الكنيسة المسيحية تحث عليه أتباعها بدءًا من القرنين السابع والثامن الميلاديين وتحول إلى «مفتاح» لتفسير ميلاد الحروب الصليبية، قد استخدم لأول مرة في شبه الجزيرة الأيبيرية عنصرًا محرضًا في حروب الاسترداد ضد المسلمين.
ولقد أدت حروب الاسترداد في إسبانيا على المستوى الداخلي الدور نفسه الذي أدته الحروب الصليبية على المستوى الأوربي، فقد وحدت صفوف الإسبان والمناطق التي كانت متناحرة من قبل، وأصبحت تلك الحروب رمزًا لتحقيق الوحدة الدينية والثقافية والوطنية لإسبانيا؛ لأن الحرب ضد المسلمين صورت عقديًّا على أنها حرب لخلاص الكنيسة من الكفار والتصالح مع الذات المسيحية(١٤). وكان هدف البابوية هو ألا تظل إسبانيا بعيدة من سلطتها الروحية، ولذلك سعت أولًا إلى الضغط على الملوك الإسبان لإخضاعهم لنفوذ الكنيسة الرومانية، وثانيًا إلى دعوة المسيحيين المؤمنين إلى التوجه إلى إسبانيا للمشاركة في العمليات العسكرية ضد المسلمين.
الصورة العقدية للإسلام في إسبانيا في القرون الوسطى
يكشف المؤرخ الإسباني خوسيه خوان رودريجيز أنه مع بدايات الفتح الإسلامي لإسبانيا ظهرت أولى الكتابات الإسبانية عن الإسلام والمسلمين وكانت تتسم بطابع سلبي، وشكلت تلك الكتابات «نماذج» سرعان ما جرى تعميمها في القرون الموالية من دون أن تخضع للمراجعة أو النقد، فقد كانت تؤخذ على أنها كتابات علمية لا يرقى إليها الشك.
كانت الكتابات الإسبانية الأولى عن الإسلام عبارة عن محاولة لتأريخ مرحلة الفتح الإسلامي، وقد صورت تلك الكتابات المسلمين والعرب على أنهم أقوام غزاة ومتوحشون وقساة، وظلت تلك الصور النمطية هي الثابتة في العصور اللاحقة، بل شكلت نماذج أولية قِيسَ عليها من كتاب ومؤرخين آخرين تناولوا الموضوع نفسه، لكن بطريقة مبالغ فيها، بحيث كانت تُختلَق حوادث وهمية لنقل صورة سيئة عن المسلمين، والقول بأن الفتح الإسلامي تم بطريقة وحشية، ورافقته أعمال قتل ونهب وسلب واغتصاب، متناسين أن الفتح تم بطريقة سلمية من خلال إبرام الصلح مع السكان.
ويبدو أن الإسبان كانوا يجهلون كل شيء عن حقيقة الإسلام والمسلمين، وأن الصور التي نُسِجَت عنهم لم تكن إلا من إنتاجات الخيال. فقد صورت بعض الكتابات الأولى المسلمين على أنهم «عباد القمر»، كما كانت تلك الصور غارقة في العنصرية والازدراء، مثل القول بأن العرب والمسلمين «جنس نجس»، أو «عرق غير طاهر». كما يلحظ المؤرخ نفسه (خوسيه خوان) أن بعض الكتابات كانت تطلق على المسلمين أوصافًا وردت في التوراة للإشارة إلى أعداء بني إسرائيل، وتشبههم بالعموريين(١٥). وتمثلت الصورة الأكثر بشاعة في الحكايات الشعبية والحوليات التاريخية التي تتحدث عن المسلمين الذين يبترون الأجهزة التناسلية للمسيحيين المهزومين، وتتحدث في الوقت نفسه عن الشبق الجنسي الحاد لدى المسلمين، والإعراب عن التخوف من توجيه تلك الطاقة الجنسية نحو النساء المسيحيات.
من الواضح أن تلك الصورة كانت متأثرة بمناخ الحروب الصليبية وحرب الاسترداد. وقد ظلت تلك الصورة السلبية لمسلمي الضفتين الجنوبية والشرقية للمتوسط، أو لـ«المورو» عامةً، حاضرة طيلة القرنين السادس عشر والثامن عشر بسبب العداء القوي بين المملكة الإسبانية والإمبراطورية العثمانية من جهة، وبينها وبين الممالك المغربية من جهة ثانية. بل أضفيت عليها دلالات معينة طيلة القرون الثمانية التي استغرقتها حروب الاسترداد التي ظهرت وتطورت خلالها أسطورة «قاتل المورو» أو ماتاموروس: وهي أسطورة ظهرت في القرن السابع الميلادي تقول: إن هذا الأخير نزل مع الغيوم لنصرة مسيحيي إسبانيا ومساعدة الملك روميرو الأول في قتال المسلمين.
الموريسكيون في الرواية العربية
نقطة التقارب وتلاقي الأفكار بين العـــالم العربــي وأوربـا

آنا مارية سانشيز مدينة – باحثة إسبانية في الأدب العربي
لم يكن مجال ترجمة ودراسة الأعمال الأدبية عن اللغة العربية معروفًا، بصفة عامة في مجتمعنا الإسباني، حتى في نطاق العلوم السياسية، وخصوصًا في الروايات التي تعالج موضوع الموريسكيين. على الرغم من وجود دراسات وترجمات إلى الإسبانية لأعمال أدبية معاصرة قبل سنة 1988م، تلك السنة التي حصل فيها الكاتب نجيب محفوظ على جائزة نوبل للأدب، فهذه الدراسات والترجمات كانت نادرة نسبيًّا وكانت مرتكزة عمومًا على مؤلفين بارزين جدًّا.
بعدها بدأنا نشهد اهتمامًا متزايدًا بترجمة ودراسة أعمال أدبية في إسبانيا، ولكن مع مرور السنوات بدأ يتراجع هذا الاهتمام. حتى اليوم هناك العديد من الأدباء المعاصرين في العالم العربي غير معروفين عند الجمهور بصفة عامة، بينما البحث لم يتناول بشكل كامل ومنهجي التدفق الكبير للأعمال الأدبية من كل الدول العربية منذ بدايات القرن العشرين حتى وقتنا الحالي.
تيار جديد
في هذا الصدد، اخترنا الكاتبين صبحي موسى وحسن أوريد لرسالتنا للدكتوراه؛ لأنهما يمثلان تيارًا جديدًا ابتكاريًّا وحديثًا. من جهة، قدمنا صبحي موسى وهو كاتب وصحفي من مصر، ومن جهة أخرى حسن أوريد أديب ومفكر من المغرب، كلاهما بارز ومهم. وجدنا فيهما قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي طالب بها الربيع العربي. وكانا يعالجان مواضيع ذات أهمية كبيرة، مثل الإرهاب الدولي، أو القضية الفلسطينية.
لقد اخترنا موضوع الموريسكيين لرسالتنا للدكتوراه؛ لأنه مثير ومهم جدًّا لبعض المستعربين والمؤرخين، وهو غير معروف كثيرًا في المجتمع الإسباني. يجب أن نقول: إن المعلومات التي لدينا حول هذا الموضوع متفرقة، وهي معالجة في مجلات علمية وكتب فقط وبشكل جزئي. لا يوجد كتاب أو حتى مجموعة من الكتب تجمع تاريخ الأندلس وآدابه بشكل موحد، ولا من مرحلة الأندلس الأخيرة، التي بدأت في ثورة البيازين سنة 1568م، والتي أدت إلى حرب غرناطة وطرد الموريسكيين من أرضهم في النهاية. ولكن هناك شيء مهم تعلمناه وهو أن الموريسكيين هم أجدادنا. لقد وُلدت الأندلس في أرضنا وهي تمثّل سحر اختلاط أجناس مختلفة في رقعة واحدة. ومن المهم أن نذكر أن الأندلس لا تُدرّس في المدارس الإسبانية، ولا اللغة العربية أيضًا، على الرغم من تاريخنا الإسلامي العربي.
صدمة استثنائية
أحداث 25 يناير سنة 2011م في مصر كانت صدمة استثنائية، سياسيًّا واجتماعيًّا، معروفة عالميًّا؛ لذلك من المهم أن نأخذ في الحسبان تأثير وحضور هذا الموضوع في الأدب. لقد استخدم صبحي موسى هاتين الثورتين في روايته «الموريسكي الأخير» لإيجاد أوجه التشابه بين الماضي والحاضر وفهم المشكلات التي نواجهها حاليًّا. في رأينا، ترتكب الإنسانية الأخطاء نفسها بطريقة دورية على مر التاريخ. مأساة الموريسكيين هي مأساة الشعب الفلسطيني وغيرها من الإبادات الجماعية التي سبقتها. ومن الضروري أن نتعلم من التاريخ؛ لأنه من دون وعي لا يوجد سمو روحاني للإنسانية.
يحكي الكاتب في رواية «الموريسكي الأخير» عن حقب متتالية في تاريخ إسبانيا حتى الوصول إلى المرحلة الانتقالية التي كانت الطريق إلى الديمقراطية في عقد السبعينيات من القرن الماضي.
بلاس إنفانتي، أبو الوطن الأندلسي، كان يشير إلى أهمية توحيد الشمال والغرب، الأندلس والمغرب أو إسبانيا والمغرب. ما يريده صبحي موسى وحسن أوريد هو أن إسبانيا تمثّل نقطة التقارب وتلاقي الأفكار بين الثقافة العربية والغربية، وأن تكون الممر الثقافي بين العالم العربي وأوربا، ومن خلالها يكون ممكنًا ترجمة وانتشار الأدب العربي في العالم، ويريان أن إسبانيا جسر لانتقال الثقافة العربية في العالم كما حدث في الماضي.
هكذا اكتشفنا أن البطلة في رواية «الموريسكي» مسيحية، وهي حساسة وذكية، وفي رواية «الموريسكي الأخير» البطلتان لهما صفات المرأة المتمكنة أيضًا. وبالتالي، العلاقة بين البطل والبطلة في الروايتين هي علاقة المساواة.
من وجهة نظرنا يستحق الموريسكيون حق الاعتراف والعودة، شريطة استيفاء الشروط السياسية والاجتماعية في إسبانيا.
«سر الموريسكي» محاولة للربط بين الشرق والغرب
محمد العجمي – روائي عماني
تحاول رواية «سر الموريسكي» مقاربة العلاقة المتشابكة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، وذلك باستدعاء بعض أشكال هذه العلاقة؛ كالمطبعة العربية، والمخطوطات الإسلامية، وتجارة البحر المتوسط، والصراعات العثمانية الأوربية، والنهضة العلمية في أوربا. أزمة الموريسكيين أيضًا جاءت ضمن هذه المعالجة؛ كثيمة تتكامل مع بقية الملفات المفتوحة في العمل لتعكس الصورة العامة للصراع السائد بين الشرق والغرب في النصف الأول من القرن السابع عشر. حيث في هذه المدة تقريبًا سيُسدَل الستار الأخير على مأساة شعب الموريسكيين التي استمرت لأكثر من قرن ونيف؛ منذ سقوط غرناطة حتى قرار طردهم من إسبانيا في ١٦٠٩م. وفي هذه المدة أيضًا سيصبح التفوق الأوربي على العالم الإسلامي واضحًا تمامًا، مع الضعف الذي أخذ يدب في جسد الدولة العثمانية.
بداية الحكاية
هذا القرار هو الذي التقطته ليكون بداية الحكاية في «سرّ الموريسكي»؛ محاولًا استثمار العقود الأربعة التالية للقرار لبناء حبكة درامية لعائلة موريسكية مطاردة، ستكون شاهدة على عصر كان وعي أوربا بذاتها يتشكل بالتغذي على الفوارق التي تقيمها بالحديد والنار مع الآخر، الذي سيكون على طول القرون التالية موضوعًا للتحكم والسيطرة والاستعمار الممتد حتى اليوم، ونحن نشاهد ونعيش ونتلمس الازدواجية التي يتعامل بها بقايا الاستعمار الغربي مع القضية الفلسطينية، الذي تجلى بشكل فاضح في الحرب الإسرائيلية القائمة في غزة.
لقد كان مدهشًا لي وأنا أبحث في تاريخ شعب الموريسكيين ذلك الإصرار العجيب منهم على الحفاظ على هويتهم وتراثهم وثقافتهم؛ حتى على الرغم من تخلي القريب والبعيد عنهم. وتضافر هذا الإعجاب مع المقابلة التي أقمتها بين مرسوم طرد الموريسكيين ووعد بلفور الذي مهد الطريق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم؛ في أن أجعل قضية الموريسكيين الموضوع الأبرز للقضايا التي أعالجها في الرواية. لم أكن ملتفتًا وقتها لحجم الحضور الأدبي لمأساة الموريسكيين عربيًّا، ولكن مع التقدم في العمل والاطلاع على المزيد من المشروعات الإبداعية التي استثمرت الموضوع نفسه؛ أدركت أن القضية مغرية للكاتب العربي لدرجة ربما تثير التساؤل فعلًا.
بين القضية الموريسكية والفلسطينية
بغض النظر عما يشكله التاريخ من ثروة ومعين لا ينضب يكون مثيرًا للأديب في اختيار موضوعاته، ويكون في الوقت نفسه مادة للكتابة؛ غير أنه في حالة الموريسكيين؛ فالشبه بين قضيتهم والقضية الفلسطينية شكّل دافعًا خفيًّا لدى معظم من كتب عن الموريسكيين. لا أظن أني كنت بعيدًا من ذلك، على الرغم من المسافة الزمنية بين التاريخ الذي تتحدث عنه «سرّ الموريسكي»، والزمن الذي بدأت نيات البريطانيين تتجلى أكثر تجاه تسليم فلسطين لليهود في أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. ولعلي لا أجانب الصواب لو قلت: إني فعلت ذلك من دون قصد. اللاوعي هنا يتحدث أكثر من الوعي. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع عربي إسلامي مع بقايا الاستعمار الأوربي المتمثل في دولة الاحتلال، وهو لا يختلف من حيث الجوهر عن صراع الموريسكيين مع الإسبان.
إذا تجاهلنا المسألة الموريسكية فإننا ندعم النسيان لا الذاكرة
أحمد عبداللطيف – روائي ومترجم مصري
تظل مسألة الموريسكيين قضية قائمة ويجب ألّا تنتهي؛ ذلك لأن الدرس الكبير الذي يجب أن نتعلمه من التاريخ (كما الطب) ألا نغلق الجرح قبل تنظيفه، وإلا دفعنا أثمانًا غالية قد تؤدي إلى البتر أو الوفاة. بنظرة بديهية، اعتذرت ألمانيا عن الهولوكست وأبدت دعمها الشامل والمطلق لدولة الاحتلال منذ البداية حتى الآن، تكفيرًا عن ذنب المحرقة. ومنحت إسبانيا اليهودَ السفارديمَ حقَّ العودة بعد مرور خمس مئة عام من الطرد. أما الموريسكيون فلا يذكرهم أحد، على الرغم من أن أثر المسلمين في إسبانيا سياسيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا وفنيًّا ومعماريًّا، كان أكبر من أثر اليهود بشكل لا يمكن دحضه أو حتى مناقشته. وكانت محاكم التفتيش وأساليب الطرد أشد ضراوة مع المسلمين؛ لذلك لا يصح أن تُغلق هذه الصفحة أبدًا، حتى لو اعتذرت إسبانيا وأعطت الموريسكيين حقَّ العودة. فمن التاريخ نتعلم أن المجازر والقتل والدم والعنصرية أوبئة لا يجب أن تعود. وإن تجاهلنا المسألة الموريسكية فنحن ندعم النسيان لا الذاكرة، ونبني مستقبلنا على باطل.
لهذا السبب، ومن هذا المنطلق، كتبت رواية «حصن التراب» عن الموريسكيين. وكانت نيتي في الأساس تسليط الضوء على القضية في جو فني وجمالي لا يقتله الثقل التوثيقي والتاريخي، بحيث أمنح المظلومين صوتًا يتكلمون من خلاله عن اليومي والمعتاد، برواية تواجه الرواية الرسمية وتدحضها.
هدم التاريخ
من أجل هذا العمل، قرأت الأعمال المكتوبة بالإسبانية، وزرت أرشيفات تضم محاكمات التفتيش، ورأيت آلات التعذيب في كل من طليطلة وكوينكا. لكن ما كان يشغلني في العمق هو هدم هذا التاريخ الرسمي الذي تبنته السردية الإسبانية. فالتاريخ، في رأيي، مجرد حكاية قابلة للتصديق والتكذيب؛ لذلك استعرت الصياغة الإسبانية لأبني تاريخًا آخر مضادًّا، يرسم الموريسكيين بشرًا عاديين يتطلعون للحياة لا للموت، تشغلهم اليوميات لا التحالف مع الإمبراطورية العثمانية، وليسوا مضطرين لإثبات هوية ولا دين، غير أنهم اضطروا لفعل ذلك على مدار أكثر من قرن.
التاريخ الموريسكي، الذي بدأه المؤرخ كارباخال، أحد جنود محاكم التفتيش، بدا لي مغالطة بنيت عليها مغالطات أخرى، صححها مؤرخون إسبان انحازوا للقضية المسلمة، وأنا شعرت أني في حاجة لأكثر من التصحيح، أقصد الهدم. فلا الملوك الكاثوليك كانوا كهنة ولا كان هدفهم الحفاظ على كاثوليكية إمبراطوريتهم، كما لم يكن الصليبيون أبناء المسيح، ولا جاؤوا للشرق الأوسط للحفاظ على مهد المسيح. ببساطة، في الحالتين، كانت السياسة والاقتصاد ما يحرك الحكام، وكان التخلص من المسلمين هدفًا سياسيًّا لا دينيًّا في الأساس.
في النهاية، على الرغم من أن التاريخ يكرر نفسه بأشكال مختلفة، فإن الواجب الأخلاقي يفرض علينا أن نأمل بألّا يتكرر. وربما كان ذلك أحد أفكار الأدب.
الموريسكيون: التسمية، والطرد، والتوطين

حسام الدين شاشية – باحث تونسي
ليس من السهل تحديد الجماعة الموريسكية، لكن بدايةً أريد تعريف مُصطلح «الموريسكيون» أو «الموريسكيين»، الذي لا يعني بأي حال من الأحوال «المُسلم الصغير»، كما هو شائع في كثير من الكتابات العربية؛ بل إن أصل التسمية إسباني (Moriscos)، ويعني باختصار: المعتنقون للمسيحية من ذوي الأصول الأندلسية المُسلمة. وهو مُصطلح في أصله ليس تحقيريًّا، لكنه حمل معاني سلبية في المجتمع الإسباني المسيحي في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. هذا المصطلح وقع تعريبه في بداية القرن العشرين، في البداية إلى كلمة «موريسكوس» عن طريق شكيب أرسلان، ثم «الموريسكيون» ومُفردها «موريسكي» عن طريق عبدالله عنان. عمومًا، يُمكننا أن نُحدد أفراد الجماعة الموريسكية على أنهم الأندلسيون الذين بقوا للعيش في مدنهم بشبه الجزيرة الأيبيرية بعد سقوطها في يد المسيحيين، ثم أجبروا ما بين سنتي 1502م، و1526م على اعتناق المسيحية.
سياسات قاسية
اختلفت وضعية الموريسكيين قبل الطرد من منطقة إلى أخرى، نتيجة اختلاف التطور التاريخي للأحداث وسياسات الملوك الإسبان وحكام المُقاطعات ورجال محاكم تفتيش كل منطقة. على أنه يمكننا القول: إنه قد مورست على الموريسكيين طيلة القرن السادس عشر سياسات قاسية، تهدف إلى صهرهم دينيًّا وثقافيًّا بالقوة وبسرعة في المجتمع المسيحي الكاثوليكي الأيبيري، وهو ما جعلهم عرضة لملاحقات محاكم التفتيش ورجال الكنيسة. واجه الموريسكيون هذه السياسات أحيانًا بطرائق سلمية، عبر استعمال التقية وعيش حياة مزدوجة، أي إظهار التدين المسيحي في الفضاءات العامة والمحافظة على الإسلام في المنزل والتجمعات الخاصة، وأحيانًا أخرى من خلال القوة، أي بالقيام بعدد من الثورات المسلحة، التي لعل أهمها ثورة البشرات أو الألبوخارس التي كانت في الجبال القريبة من غرناطة ما بين سنتي 1568م و1571م.
في شهر إبريل من سنة 1609م اتخذت السلطات الإسبانية قرار طرد الموريسكيين، لكن صدور القرار الأول للعلن والخاص بموريسكيي جهة بلنسية لم يكن إلا في 22 سبتمبر 1609م. هنا أريد تأكيد أن قرار طرد الموريسكيين هو قرار طرد ثقافي وليس دينيًّا كما هو الأمر بالنسبة لليهود السفارديم سنة 1492م، فبالنسبة لأفراد الجماعة الأخيرة، كان يمكن تجنب الطرد من خلال إعلان اعتناق المسيحية الكاثوليكية، أما بالنسبة للموريسكيين، فحتى الأفراد والجماعات التي وقع تأكيد صدق إيمانها المسيحي، فقد أصرت السلطات على طردهم.
ثلاث مئة ألف
تواصلت عملية طرد الموريسكيين حتى بداية سنة 1614م؛ إذ طُرد موريسكيو منطقة الريكوتي بجهة مُرسية. تختلف تقديرات أرقام الموريسكيين المعنيين بقرار الطرد من جهة إلى أخرى، على أن الأعداد التي وقع توثيقها، تُقدر بنحو ثلاث مئة ألف موريسكي: بضعة آلاف تمكنت بطرائق مختلفة من تجنب الطرد، وبضع مئات استطاعت العودة بعد طردها، في حين طُرد نحو ثمانين ألفًا إلى المغرب، وخمسين ألفًا إلى الجزائر، وما بين ثمانين ومئة ألف إلى تونس، ووصلت عشراتٌ أو مئاتٌ أُخرى إلى فرنسا وإيطاليا وأميركا الجنوبية، ومثلهم إلى ليبيا ومصر وبلاد الشام والأناضول، وغيرها من المناطق.
تعرض المهجرون في أثناء الإبحار للقتل والنهب على أيدي رَبَابِنَة السفن الفرنسية والإيطالية، فقد كان هؤلاء يسرقونهم ثم يلقون بهم في البحر من أجل زيادة عدد السفرات. كذلك تعرض بعض المهجرين عند وصولهم للشواطئ للقتل والنهب والاغتصاب على أيدي الجماعات الخارجة على السلطات المركزية في المغرب والجزائر.
سياسة ناجحة
فيما يتعلق بتونس، فقد رحبت بهم السلطات السياسية والدينية، وخصصت لهم مناطق ليستقروا بها في الشمال، كتستور وسليمان ومجاز الباب وغيرها، وكانت متسامحة معهم، خصوصًا أن العديد من الموريسكيين الذين وصلوا البلاد لم يكونوا يعرفون جيدًا الإسلام واللغة العربية. هذه السياسة آتت أكلها، حيث ساهم المهجرون في تطوير العديد من القطاعات. ففي الفلاحة أُدخِلَتْ تقنيات وزراعات جديدة، أما على المستوى الحرفي، فتظهر مُساهمتهم أساسًا في الصناعات النسيجية مثل صناعة الشاشية، كما أدوا العديد من الأدوار المهمة على مستوى التجارة الخارجية. أما على المستوى الفكري، فقد ألف الموريسكيون في بداية القرن السابع عشر في تونس عددًا من المخطوطات الفريدة باللغة الإسبانية التي كانت في الأساس موضوعاتها الجدل الديني، والعقيدة والعبادات.
كيف تحايل الموريسكيون على محاكم التفتيش؟!

جمال عبدالرحمن – باحث مصري
إزاء تعنت محكمة التفتيش لجأ الموريسكيون إلى بعض الحيل؛ لكي يتمكنوا من أداء شعائر الإسلام من دون أن يكتشفهم أحد. كان الوضوء جريمة في نظر القانون، لكن الاستحمام لم يكن جريمة؛ لذلك كان الموريسكي يستحم في النهر بدلًا من أن يتوضأ. كانت الصلاة «جريمة» أخرى؛ لذلك كان الموريسكي إذا أراد الصلاة، يصلي في بيته ويكلّف صديقًا بالوقوف في الشارع، لكي يحذّره إذا رأى قسيسًا قادمًا، وبالطبع كان من يقف في الشارع يدّعي أنه جاء لتحية صديقه وأنه يناديه لكي يخرج.
صيام رمضان
من الذي كان يعلم بالشهور القمرية، وبالتالي بحلول شهر رمضان؟ موريسكيون قليلون. كيف كانوا يعلمون إخوانهم بحلول شهر رمضان (وبأخبار تخص الأمة الموريسكية: انتصارات الأتراك مثلًا)؟ ابتكر الموريسكيون مهنة البغّالين؛ يعني استخدام البغال لنقل البضائع مقابل أجر. كانت تلك المهنة مجرد غطاء لعمل سِرّيّ، فالبغّال كان يتحرك بسهولة بين القرى ويحتك بالناس من دون أن يعترضه أحد؛ ولذلك كان بإمكانه إبلاغ الناس بمقدم شهر رمضان، أو بأية أخبار تهم الموريسكيين. (سنرى لاحقًا كيف تمكّن البغّالون من إبلاغ الموريسكيين بموعد ثورة البشرات في سرية تامة بحيث فوجئ المسيحيون باندلاع الثورة).
في شهر رمضان كان على الموريسكي أن يستيقظ ليلًا لكي يتسحّر، وكانت هناك مشكلة في إيقاظ الناس، لكن أحدهم وجد الحل: سيكلّفون من يمر على بيوت الموريسكيين قبل الفجر بساعة، بحجة التحرك مبكرًا لرعي الأغنام. وإمعانًا في التخفي، اختاروا للقيام بالمهمة رجلًا مسيحيًّا أبًا عن جد، وكلّفوه بإيقاظهم «لرعي الأغنام» مقابل أجر، وظل ذلك المسيحي يوقظ الموريسكيين، فيتسحرون ويؤدون صلاة الصبح، ثم يسوقون أغنامهم إلى حيث المراعي. كانت هناك مشكلة أخرى في شهر رمضان: كيف سيبررون للجيران أنهم لا يتناولون طعام الغداء؟ بعض الأسر كانت تدّعي أنها ستبيت في الحقول لحراسة محاصيلها، وهكذا كانوا يمارسون حياتهم بحرية في الحقول، بعيدًا من الرقابة، فيصومون، ثم يفطرون بحلول المغرب، ويتسحرون قبل الفجر من دون عائق.
أما الحج، وهذه هي المفاجأة. هل يظن أحد أن يسعى الموريسكيون إلى الحج في تلك الظروف؟ لقد حددوا طريقًا يذهب الموريسكي عبرها إلى بيت الله الحرام ثم يعود، من دون أن تفطن السلطات إلى وجهته. لم يستسلم الموريسكيون للظروف، بل ابتكروا الحيلة تلو الحيلة؛ لكي يتمكنوا من أداء شعائر الإسلام، وهم يدعون الله أن يغفر لهم تقصيرهم.
الموريسكيون في التاريخ والأدب

الأندلسي والموريسكي
صبحي موسى – كاتب مصري مؤلف رواية «الموريسكي الأخير»
منذ سقطت الأندلس في أيدي الإسبان وهي كالفردوس المفقود في الثقافة العربية والإسلامية، فطالما كتب عنها الشعراء والروائيون، ومع بزوغ القضية الفلسطينية في الأفق أصبحت الأندلس المعادل الموضوعي في الأدب العربي لخروج الفلسطينيين من قراهم وبيوتهم، وتوالت الأعمال الإبداعية التي ربطت بين كلتا المأساتين سواء على نحو خفي أو مباشر، بدءًا من جورجي زيدان الذي كتب «فتح الأندلس»، وأحمد أمين صاحب «الأنشودة الموريسكية»، وصولًا إلى «ليون الإفريقي» لأمين معلوف، و«ثلاثية غرناطة» رضوى عاشور، و«ظلال شجرة الرمان» طارق علي، و«البيت الأندلسي» واسيني الأعرج، و«راوي قرطبة» عبدالجبار عدوان، و«حصن التراب» أحمد عبداللطيف، و«سر الموريسكي» محمد العجمي، وغيرهم كثيرون.
الأندلسي
لكن عادة ما يخلط بعضٌ بين مصطلحي «الأندلسي» و«الموريسكي»، فالحضارة الإسلامية في الأندلس استمرت 781 عامًا، وحين أخذت في الانحسار وتوالى سقوط مدنها واحدة بعد الأخرى، لم يحدث ذلك فجأة، فقد استمر الأمر نحو أربع مئة عام، بدءًا من سقوط طليطلة عام 1084م حتى سقوط غرناطة عام 1492م، وكلما سقطت مدينة كان الإسبان يخيرون أهلها بين تسليمهم بحكم الإسبان لهم، أو الهجرة إلى غيرها من مدن الإسلام، فكان بعضهم يهاجر سواء إلى المدن الأخرى مثل قرطبة وغرناطة وإشبيلية وبلنسية وملقة وغيرها، أو يعود إلى المغرب في الشاطئ الجنوبي للبحر، ومنها يرتحل إلى مدن المشرق العربي سواء في مصر أو الشام أو الجزيرة العربية، وبخاصة أن رحلة الحج تمرّ بهذه البلدان، وكان بعضهم يفضل الإقامة فيها، سواء لأن جذوره الأولى منها، أو لأنها كلها بلاد الإسلام، وهؤلاء يسمون الأندلسيين، ومنهم عائلات شهيرة مثل: التميمي، والشطبي، والقرطبي، والطرطوشي، ومنهم متصوفة وأولياء كبار مثل: المرسي أبو العباس، صاحب المسجد الشهير في مدينة الإسكندرية.
الموريسكي
أما الموريسكيون فهم الذين هاجروا بعد سقوط غرناطة، وتحديدًا هم الذين خُيِّروا بين التنصير الإجباري أو الرحيل عن الأندلس، وذلك بعد صدور قرار التنصير عام 1496م، ومن ثم ظهر لأول مرة مصطلح موريسكي، الذي يعني النصراني الجديد، أو المغربي قليل الشأن، والذي على إثره بدأت هجرات الموريسكيين نحو الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، التي استمرت نحو مئة وعشرين عامًا، هاجر فيها أكثر من مليون نسمة قسريًّا بسبب الاضطهاد الديني، وانتهت بالطرد الجماعي لهم؛ إذ لم يستطع ملك إسبانيا فليبي الرابع أن يحتمل مزيدًا من الثورات والقلاقل داخل بلاده، فقررت حكومته بعد ثورة الموريسكيين في بلنسية طرد الموريسكيين منها، ثم امتد القرار من بلنسية إلى كل الموريسكيين في مختلف أنحاء البلاد، فاستمر تهجيرهم القسري من 1609م إلى 1613م؛ لتمتلئ مدن المغرب العربي بهم.
اضطهاد معاكس
لكن الموريسكيين عانوا مرة أخرى اضطهادًا دينيًّا معاكسًا؛ إذ نظر إليهم كثيرون على أنهم نصارى وليسوا مسلمين، فكثير منهم كان يحمل أسماء مسيحية، ومن ثم ارتحل بعضهم من المغرب العربي إلى بقية البلدان الإسلامية، سواء في آسيا أو إفريقيا، وبعضهم فكر في العودة إلى شواطئ الأندلس من جديد، وقلة منهم تمكنت من الهروب عبر الجبال مع الغجر إلى فرنسا، وبعضهم حُكِمَ عليه بالتجديف مع العبيد على السفن الذاهبة إلى العالم الجديد، فقد اكتُشِفَت أميركا اللاتينية في العام نفسه الذي سقطت فيه غرناطة 1492م، ومع هؤلاء انتقلت الفلامنكو والموسيقا الأندلسية إلى أميركا اللاتينية، مثلما انتقلت العمارة وطرائق الري الأندلسية المتطورة إلى المغرب العربي، وصارت في كل مدينة أحياء لهم، وعرفت مدن كاملة باسمهم، مثل «تطوان»، و«شفشاون»، و«فاس» في المغرب، و«زغوان»، و«بنزرت» في تونس، و«القليعة» في الجزائر، تلك التي هاجر إليها نحو ثلاث مئة عائلة بحسب المؤرخ الإسباني لويس مارمول كارباخ. وفي مصر بحسب الدكتور حسام محمد عبدالمعطي في كتابه «العائلة والثروة » استوطن الموريسكيون شمال الدلتا، وخصوصًا في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، فأنشؤوا العديد من القرى التي حملت أسماء أندلسية مثل الحمراوي، وإسحاقة، وأريمون، ومحلة موسى، وسيدي غازي، وكفر الشيخ، وسيدي خميس، والناصرية، ومحلة دياي، وقطور، والشاطبي، والمنشية وغيرها. ومنهم عائلات نقيطة، وديلون، وجبريل، والحوني، والعادلي، والصباحي، والطودي.
جريمة إنسانية لم تنتهِ

عبدالقادر بوباية – باحث جزائري
تمكن المسلمون من إقامة دولة مترامية الأطراف امتدت حدودها من الصين شرقًا إلى البحر المحيط (الأطلسي) غربًا، ومن أواسط آسيا شمالًا إلى بلاد السودان جنوبًا، وكانت بلاد الأندلس من المناطق التي فتحها المسلمون عام 92هـ (711م) على يد طارق بن زياد الولهاصي النفزي، مولى موسى بن نصير، والي بلاد المغرب على عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، واستمر حكمهم للعدوة الأندلسية نحو ثمانية قرون، وتمكنوا من تشييد حضارة لا تزال آثارها تدل على العظمة التي وصلوها في تلك القرون التي كانت فيها بقية القارة الأوربية تعاني ويلات التخلف في المجالات كافة.
معالم حضارة الأندلس
ومن أبرز المعالم التي تدل على ذلك المسجد الجامع في قرطبة الذي بناه عبدالرحمن بن معاوية (756- 788م)، ووسّعه كل من عبدالرحمن الناصر، والحكم المستنصر بالله، والمنصور محمد بن أبي عامر، ومدينة الزهراء التي بناها عبدالرحمن الناصر لدين الله بداية من 936م، ومئذنة جامع إشبيلية التي شيّدها أبو يوسف يعقوب المنصور سنة 1197م لتخليد انتصاره على النصارى في موقعة الأرك سنة 1194م، وقصر البديع الذي شيده المعتمد بن عباد، وقصر الحمراء في غرناطة الذي شيّده أبو عبدالله محمد بن يوسف ابن الأحمر، وأشهر أجنحته «بهو السباع» الذي أنشأه السلطان محمد الغني بالله (1354- 1391م)، وغيرها من المآثر العمرانية التي لا تزال قائمة، وتجلب إلى إسبانيا أكثر من ستين مليون سائح سنويًّا، ويدر هذا العدد ملايين الدولارات على الخزينة حيث تعد السياحة المورد الرئيس لخزينة المملكة الإسبانية.
وفي أثناء وجود المسلمين في الأندلس، ظلت الروابط وثيقة بينهم وبين إخوانهم في العدوة المقابلة، كما استمر التأثر والتأثير بينهما في المجالات كافة، وعندما بدأت حركة الاسترداد المسيحي كان المغاربة في مقدمة المتطوعين لنجدة إخوانهم، وعندما فقد المسلمون ممتلكاتهم في بلاد الأندلس، كانت مختلف بلدان المغرب الملاذ الأقرب للفارين بدينهم من البطش الإسباني الصليبي.
شروط أهل غرناطة
من جملة الشروط التي شرطها أهل غرناطة على ملك الروم أن يُؤمِّنهم على أنفسهم وبلادهم ونسائهم وأبنائهم ومواشيهم وجنّاتهم ومحارثهم، وجميع ما بأيديهم وغيرها من الشروط، وقد كتب لهم ملك الروم بذلك كتابًا، وأخذوا عليه عهودًا ومواثيق في دينه مغلظة على أنه يوفي لهم بجميع ما شرطوه عليه، وفي يوم 21 من المحرم 897هـ/ 25 نوفمبر 1492م وُقِّعت معاهدة دولية بين سلطان غرناطة أبي عبدالله محمد بن علي بن سعد النصري (Boabdil) وفرناندو وإيزابيلا ملكَيْ قشتالة وأراغون وليون وصقلية، وبموجبها التزم السلطان النصري بتسليم غرناطة للملِكيْنِ النصرانيين مقابل شروط عليهما احترامها، والسهر على تطبيقها.
وكان يُفترض على ملكي قشتالة وأراغون الالتزام بهذه الشروط، ولكن معظم بنود المعاهدة انْتُهكت من النصارى، الذين أعلنوا حربًا شعواء على من بقي من المسلمين في بلادهم، حيث تعرّضوا إلى الإبادة في البُشارات ووادي آش ومالقة وغيرها.
إن ما وقع لمسلمي مملكة غرناطة على يد جيش إيزابيلا وفرناندو ورجال كنيستهما ومحاكم التفتيش التي أنشئت لمعاقبة المسلمين، ومنعهم من ممارسة عبادتهم، والتمتع بممتلكاتهم لا يُضاهيه بتاتًا ما تعرّض له اليهود في الحرب العالمية الثانية على أيدي النازية الألمانية حسب الرواية المزعومة للحركة الصهيونية، ولا تزال متاحف كثيرة في إسبانيا تعرض وسائل التعذيب الجهنمية التي اخترعتها محاكم التفتيش لتعذيب المسلمين، وإجبارهم على التنصر.
بناءً على ما سبق ذكره؛ يمكن القول: إن الحديث في القضية الموريسكية كجريمة إنسانية لم ينتهِ، ولذلك فإن الخوض في الموضوع المؤلم لنا نحن المسلمين؛ وبخاصة المتخصصون في التاريخ الأندلسي ما زال قائمًا، ويجب التكتل من أجل مطالبة الحكومة الإسبانية بالاعتذار لهم، ومنحهم حق العودة إلى وطن أجدادهم على غرار ما حدث مع اليهود السفارديم على الرغم من أنهم كانوا أقل عددًا، وأقل إمكانات مقارنة بالمسلمين.
مفاتيـح البيوت الموريسكية
مــحـمــد أحمد بنيس – شاعر مغربي من أصول موريسكية
يصعب الجزم باحتفاظ بعض العائلات الموريسكية بمفاتيح بيوتها في الأندلس، التي يفترض أنها توارثتها على مدار القرون الخمسة الأخيرة. أعتقد أن هناك مساحة من الأسطورة في ذلك. وهي أسطورةٌ كان الخروج الدراماتيكي من الفردوس المفقود بحاجة إليها في لحظة تاريخية فارقة. هناك عائلات أندلسية احتفظت بمفاتيح بيوتها التي تركتها وراءها في مدن الأندلس وبلداتها، لكن هل يمكن أن تصمد هذه المفاتيح في انتقالها من جيل إلى جيل حتى الآن، وبخاصة أن الموريسكيين باتوا جزءًا من النسيج المجتمعي والأهلي والثقافي في البلدان التي هاجروا إليها؟ الاحتفاظ بهذه المفاتيح يتطلب قدرًا من الوعي الذي يفترض أنه ينتقل من جيل إلى جيل؛ الوعي برمزية هذه المفاتيح وقيمتها العائلية والتاريخية والثقافية.
بالتوازي مع ذلك، لا تمتلك مدننا العربية أرشيفًا أهليًّا ومجتمعيًّا يسمح بالتعرف إلى أسماء العائلات التي سكنتها أو التي وفدت إليها في أزمنة معينة، والأحياءِ والمنازل التي سكنتها وغير ذلك. طبعًا يُفترض أن تحفظ ذلك سجلاتُ البلديات ومجالس الأحياء والحارات والمستشفيات والمحاكم والإدارات المختلفة. وهذا أمر لم يكن متوافرًا في البلدان التي هاجر إليها الموريسكيون بسبب البنية الاجتماعية التقليدية آنذاك.
ترتيب الذاكرة الموريسكية
أمّا حق الموريسكيين في العودة إلى الأندلس (إسبانيا)، فأعتقد أن الأمر ينبغي النظر إليه من جوانب مختلفة؛ إذ يصعب النظر إليه بمعزل عن التحدي المرتبط بإعادة تركيب الذاكرة الموريسكية والمصالحة معها. وهو ما يتطلب قدرًا من الجرأة من الدولة الإسبانية، بمختلف مكوناتها، للإقرار بمسؤوليتها عما لحق بالموريسكيين من اضطهاد. وعلى الرغم من أنها فتحت هذا الملف منذ سنوات على درب إعادة الاعتبار لأعقاب الموريسكيين الذين طردتهم إسبانيا قبل قرون، فإن ذلك لا يكفي، فهي ترفض، أو بالأحرى، تتجاهل مسألة تقديم اعتذار لهم كما فعلت مع أعقاب اليهود السفارديم الإسبان الذي طردوا سنة 1492م. ذلك كله يلقي بظلاله على مسألة العودة، التي لا يمكن فصلها، كذلك، عن سياقاتها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المرتبطة بإشكالية الهجرة، فكل البلدان التي يوجد فيها أعقاب الموريسكيين توجد في الجنوب، بما يحيل إليه هذا المفهوم من دلالات اقتصادية وسياسية، بمعنى أن العودة ستكون لأسباب اقتصادية واجتماعية على الأرجح، على الأقل بالنسبة لأغلبية هؤلاء المنحدرين من أصول موريسكية.
هوامش:
(١) A B C, Guillermo Ortega: El 523 aniversario de la Toma vuelve a unir historia y tradición en Granada, Guillermo Ortega, 2, enero, 2004.
(٢) La Razón, Lorena Velasco: “Toma de granada: el día que Boabdil “El Chico” entrega la ciudad a los Reyes Católicos”, 2, enero, 2024.
(٣) MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Historia de los heterodoxos españoles, Librería católica de San José, Granada, 1880, II, p. 632.
(٤) MARAÑÓN, Gregorio: Expulsión y Diáspora de los mariscos españoles, Taurus, Madrid, 2004, pp. 102-103.
(٥) BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Historia de los Templos de España – Toledo-, publica y prologa Fernando Iglesias Figueras, 120-1.
(٦) BEBUMEYA, Gil: “Estampa de García Lorca”, Gaceta Literaria, Madrid, 15, 1, 1931, Obras Completas, VI, prosa, I, p, 509.
(٧) GIBSON, Ian: Federico García Lorca, Grijalbo, Barcelona, 1985, vol. I, p. 477.
(٨) كاردياك، لوي: «الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، المجابهة الجدلية (1492ـ 1640م)»، ترجمة عبدالجليل التميمي، مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 1983م، ص 83.
(٩) مجهول: كتاب «نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر، تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب»، ضبطه وعلق عليه الأستاذ الفريد بستاني، مكتبة الثقافة الدينية، 1423هـ/2002 م، الظاهر، ص 49.
(١٠) Miguel Angel Ladero Quesada: La “Reconquête”, clef de voûte du Moyen Âge espagnol. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. Année 2002.Volume 33.Numéro 33.pp: 23-45.
(١١) فيسنت كانتاريو: «حرب الاستعادة الإسبانية، هل هي حروب كلونية مقدسة ضد الإسلام». ترجمة: الدكتور أبوبكر باقادر. مجلة الاجتهاد اللبنانية. العدد 29. السنة السابعة. خريف 1995م. ص 64-65.
(١٢) Carlos de Ayala Martínez: Las Cruzadas. Silex ediciones.2004. p 85.
(١٣) قاسم عبده قاسم: «ماهية الحروب الصليبية». سلسلة عالم المعرفة. الكويت. مايو 1993م.ص 43.
(١٤) Jean Flori:Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le christianisme et l’islam. Editions du Seuil, 2002. P: 209-210.
(١٥) José Juan Cobos Rodriguez: la visión del otro en la historiografia, aproximacion a los autores locales.Editorial vision net. Madrid. 2005. P 37.

بواسطة الفيصل | يناير 1, 2024 | الملف
خلدون النبواني– كاتب سوري
في مؤلفه الأشهر «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (1905م)، يفترض عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر أنه في مقابل الكاثوليكية المحافظة، فإن الإصلاح البروتستانتي التجديدي وما تضمنه من منظومة أخلاقية جديدة في المسيحية هو ما دفع بتطور الرأسمالية قدُمًا إلى الأمام. بمقاربة لا تخلو من ذاتية وشيء من التحيز، رأى فيبر أن البروتستانتيين يعملون أكثر من نظرائهم الكاثوليكيين وهم يربحون بالتالي أكثر منهم، وأن ما تميزوا به من السعي وراء الربح «دائم القدرة على التجدد» و«البحث عن المردودية» والقدرة على مراكمة رأس المال هو ما صاغ روح الرأسمالية الغربية الحديثة.

ماكس فيبر
على خلاف ماركس الذي منح الأولوية للبنية التحتية (الاقتصاد خاصة) في تغيير البنية الفوقية (بما فيها الدِّين)، يجعل فيبر من الدِّين محركًا للاقتصاد. هكذا يُجري فيبر مفاضلتين مزدوجتين في آنٍ؛ فهو يعطي أولًا الأسبقية للديني على الاقتصادي، ويمنح ثانيًا الأولوية للبروتستانتية على الكاثوليكية؛ مذهبَي الديانة المسيحية البارزين. لكن إذ تنحصر نظرية فيبر التفاضلية تلك في إطار المسيحية الغربية، فإن أحد ناقديه البارزين وهو فيرنر سومبارت سيوسع من دائرة المقارنة، ويمنح الفضل في تطور الرأسمالية الحديثة لليهود بدلًا من البروتستانت.
بين أولوية الدين على الاقتصاد (فيبر) أو أولوية الاقتصاد على الدين (ماركس) ينقسم علماء الاجتماع والفلسفة في مقاربة تلك العلاقة المعقدة بين الدين والاقتصاد. على الرغم من عيوب التحيز الواضح فيها، فإن نظرية فيبر-التي تمنح القيمَ الدينية أثرًا جوهريًّا على العملية الاقتصادية المزامنة لها سلبًا أو إيجابًا وذلك وفقًا لدرجة حداثتها وعقلانيتها وواقعيتها، أو تخلفها وجمودها- تظل مقاربة مهمة تحولت إلى مرجعية كلاسيكية في تناول إشكالية التأثير المتبادل بين الديني والاقتصادي. وعلى الرغم من اعترافنا بهذه الأهمية، فإن هذه الورقة ستبتعد من رؤية فيبر هذه في نقطتين اثنتين: الأولى هي أننا سنكتفي بالبحث هنا في أثر الاقتصاد في تحرير القيم الدينية لا العكس. والثانية هو أننا لن نقع في خطأ فيبر في المفاضلة المذهبية كما فعل هو بين مسيحية بروتستانتية وأخرى كاثوليكية، فمثل هذه المقاربة تظل خطيرة من حيث الدلالات الاجتماعية والسياسية ويمكن جرها إلى ميدان الحرب الزائفة المؤسفة بين المذاهب. وإننا إذ نحاول تجنب المنزلق الذي وقع فيه فيبر فإننا سنتجنب كذلك تلك الاقتصادوية الماركسية التي طغت على تناول علاقة الاقتصاد بالدين بعد ماركس وبخاصة على يد إنجلس والماركسية اللينينية وما بعدها التي تعيد كل ما يحدث في العالم إلى الاقتصاد والصراع على الربح ومراكمة رأس المال.
تقوم أطروحتي هنا على فكرة أن الدولة الوطنية الحديثة الحريصة على تنمية اقتصادها وتطويره وازدهاره تحتاج، من أجل هذا الهدف، إلى سن وتشريع أنظمة وقوانين سلِسة، مرنة، حديثة تضمن حركة رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات وحركة البضاعة وحرية التجارة وعمل البنوك ونظام الاقتراض المصرفي والتمويل وسهولة وسرعة الحوالات المالية ونظم الأتمتة المصرفية والرهانات والبورصة والبيروقراطية (بمعناها الإيجابي: أي المأسسة الإدارية الاختصاصية)،… إلخ. لا شك أن وجود مثل هذه الترسانة القانونية التشريعية ووضعها موضع تطبيق أمر حاسم وجوهري لا غنى عنه لحياة وتطور أي اقتصاد.
لكن وجود قوانين تسهل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات لا تكفي وحدها لازدهار الاقتصاد الوطني لأي بلد مهما كانت ثرواته الطبيعية أو البشرية أو موقعه الجغرافي أو الإستراتيجي إذا كانت تسوده اضطرابات أمنية داخلية أو صراعات دينية مذهبية أو طائفية أو عرقية أو تهيمن عليه منظومات قيم محافظة دينية ذات توجه زهدي عازف عن الدنيا، بل مستنكر لكل أشكال الحياة بما فيها الاقتصاد.
الحداثة والتحديث
وإذ تتحمل الدولة بشكلٍ أساسي مسؤولية توفير الأمن والسلم الداخليين ويتوجب عليها (إذا كانت ذات إرادة وطنية) خلق الأجواء المناسبة للتحديث الفكري والإصلاح الديني والانفتاح الاجتماعي فإن أكثر ما يمكن أن يساهم بمثل هذه المهمة الأخيرة هو النهوض الاقتصادي. وبمعنى أوضح -وهذه فكرتي الأساسية- ليس الإصلاح الديني شرطًا سابقًا على نمو الاقتصاد بالضرورة (كما رأى فيبر)، وإنما هو في الأغلب أحد النتائج المباشرة لنهوضه؛ فهو يقطره خلفه إذا ما توافرت الشروط الضرورية لنهوض الاقتصاد في ظل دولة قوية مستنيرة قادرة على ضمان الأمن ومحاربة قوى التخلف لفتح البلد والمجتمع على التحديث والحداثة.
لكن دعوني أميِّز هنا بيت التحديث والحداثة. فلا يكفي التحديث الذي قد يقتصر على إيجاد البنى التحتية والترسانات القانونية والمؤسسات الحديثة لولادة الحداثة التي تظل أكثر من التحديث المادي، وإنما هي روح هذا التحديث (لو استعرنا مصطلح فيبر) وجانبه الفكري/ الفلسفي القائم على خلق تصورات جديدة لعلاقة الإنسان بالآخرين وبالدولة، وبالوجود ككل. في العديد من البلدان الغنية قد نجد تحديثًا من دون حداثة، فنشهد فيها تطورًا في العمران والأبنية والجسور والقصور والمطارات والمؤسسات، لكن يظل البلد محكومًا بعقلية محافظة ما قبل حداثية. مثل هذا التحديث لا يتجاوز مستوى الشكل والمظهر، ينطبق عليه قول الشاعر السوري نزار قباني: «لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية». التحديث الحقيقي هو من يستطيع أن يغير في الذهنيات والعلاقات الاجتماعية ويفتح الأبواب أمام الوعي المحلي لتجاوز عوائقه بنفسه وتقديم قراءات جديدة للواقع وللنصوص الدينية ويضطلع بفهم جديد للدين بحيث يقطع مع القراءات الرجعية التي جمدت الشرع وعوَّقت سيرورة الحداثة والتحديث معًا.
قد تنجح دولة ما إذن في عمليات التحديث إذا توافرت لديها الموارد والثروات والإرادة الوطنية لقادتها، لكن الحداثة تحتاج إلى تضافر عوامل أخرى مثل حضور المفكرين والفلاسفة والمصلحين الدينيين. يتيح الاقتصاد الناهض والإدارة السياسية الوطنية المستنيرة إمكانية مستقبلية لسيرورة الحداثة إضافة إلى التحديث فمن مصلحة الاقتصاد والساسة (إذا تمتعوا ببعد نظر) فتح المجتمع وتحرير الدين من تصورات سابقة حجبت وجهه الحضاري الحقيقي.

أثر الاقتصاد في الدين
لا شك عندي أن الاقتصاد المنهار يشكل بيئة اجتماعية راكدة فقيرة تنتعش فيها قراءات متشددة تقيِّد الاقتصاد، أو في أقل الأحوال سوءًا، قراءات زهدية معرضة عن الحياة وفعالياتها. وقد بينت العديد من الدراسات والأبحاث أن الفقر والبطالة والتخلف في أوساط الشباب المُهملين التي انسدت أمامهم الآفاق هي من أبرز العوامل لتسليمهم دون مقاومة لقوى التطرف والتعبئة الأصولية؛ إذ تستغل هذه القوى الظلامية حاجتهم المادية وفقرهم بتجنيدهم في صفوف الإسلام السياسي برواتب ومغريات مادية، أو تعوض فراغهم وعطالتهم وخواء حياتهم بأن تمنح لوجودهم هدفًا ومعنى كأصحاب عقيدة ومجاهدين في سبيل تحرير السماء من انحرافات الأرض.
هكذا يتكرس الجمود العقائدي في زمن الركود الاقتصادي الطويل والمزمن الذي تنتعش فيه القراءات الظلامية بما تحمله من ثقافة الموت التي تصور الحياة بوصفها امتحانًا يوميًّا مرعبًا أو نفقًا مخيفًا تكفي زلة قدم واحدة فيه حتى يسقط المؤمن في قعر جهنم وتصور النشاط الاقتصادي وكأنه تناقض أنطولوجي أزلي مع الدين فتحث على الإعراض عن الدنيا الفانية الزائفة وتكريس حياة المؤمن للتنسك والعبادة انتظارًا ليوم الدينونة الأبدي والحياة الأخرى فيما وراء هذا العالم الزائف. هكذا تولد الظلاميات من رحم الفقر والبطالة والإهمال الاجتماعي وغياب المرجعيات التنويرية، ويصبح الدين عسرًا لا يُسرًا، وعقيدة موت لا عقيدة حياة. لا شك أن مثل هذه القراءات والتعاليم لا تضر فقط بالاقتصاد وإنما بحياة الفرد والمجتمع والدولة. لا شك إذن في أن هيمنة مثل تلك المرجعيات الدينية الرجعية المتخلفة تخلق في الدولة والمجتمع كثيرًا من الأمراض الاجتماعية التي لا تخنق أي اقتصاد وطني وتشلّ حركته فحسب وإنما تسيء إلى الدين والدنيا معًا.
في مقابل عقائد الموت تلك، يفتحُ الاقتصاد القوي الناهض الباب على مصراعيه أمام قراءات مستنيرة وإصلاح ديني وتحرر فكري وانفتاح اجتماعي تنمو فيه قيم التسامح والتعايش ليس فقط بين الناس في المجتمع وإنما أيضًا في العلاقة بين الدين والاقتصاد والقوانين التشريعية، حيث يقلُّ التعصب وتتفتح القيم الحديثة، ويعيش المؤمن بطمأنينة رُوحية واكتفاء مادي في عصره وفي دنياه بدل الإعراض عنها فيحيا فيها دون قلق وتوتر وخوف عصابي من الحياة والآخرة، ومن الدنيا والدين معًا. في مثل هذه الظروف الناهضة والحضارية نكتشف إذن الكامن الديني الإيجابي بوصفه دينَ يسرٍ لا عسرٍ، دينَ عملٍ وفاعلية لا دين تواكل وإعراض عن الحياة، ويتكشف الدين عن قدرته الكبيرة في التأقلم مع الاقتصاد، بل دفعه قدمًا إلى الأمام لا الاكتفاء بالسير خلفه كظله، وذلك بالحض على العمل والإنتاج والحياة.
هكذا يساهم الانتعاش الاقتصادي الوطني السليم والمعافى في محاربة الفكر الأصولي والرجعية الدينية، ويوصد الباب أمام الإرهاب فهو يُمهّد الطريق للإصلاح الديني والحداثة الفكرية والنهوض الاجتماعي ويبث قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف. هكذا وفي أثناء حفره مساره العريض الحر ينقي نهر الاقتصاد قوي التدفق المجتمعَ من الشوائب الحضارية التي علقت فيه. تُذكّرني حاجة الاقتصاد إلى تذليل القوانين والعقبات الاجتماعية وبنى المعتقدات التي تعوق حريته بما عُرف في الاقتصاد السياسي ﺑ«مبدأ عدم التدخل» الذي ساد النظريات الاقتصادية الفرنسية في القرن الثامن عشر والذي كان شعاره «دعه يعمل، دعه يمر»؛ إذ كان يدعو الدولة إلى عدم التدخل في الأمور الاقتصادية.

لكن حين يواجه الاقتصاد واقعًا دينيًّا محافظًا رجعيًّا متخلفًا نكون عندها أمام إمكانيتين اثنتين: فإما أن تنتصر قوى المحافظة الدينية على حركة التطور والتحرر التي يحبل بها الاقتصاد فتعوق حركته وتعطل تطور المجتمع، وإما أن تنجح رافعة الاقتصاد في حمل التحديث للقراءات الدينية فتغير بالتالي من نظرة الناس والمجتمع وتصوراتهم عن العالم والحياة. في الحالة الثانية لا يتراجع الدين أو ينحرف أتباعه، كما ينعق أصحاب المرجعيات الظلامية، وإنما يشهد حياة جديدة ويعطي أفضل ما فيه كاشفًا عن قدراته الحقيقية في الانفتاح على الآخر وثقافته واختلافه وتقبلًا لممارساته وطقوسه وتسامحًا معه والتعايش معه بما يضمن سلامة الاقتصاد وازدهاره. في «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» يذكر فيبر ملاحظة مهمة جدًّا في هذا السياق تؤكد أن العديد من العائلات والمدن والمناطق التي كانت غنية أصلًا قبل مجيء الإصلاح البروتستانتي راحت تتوجه بعد الإصلاح إلى الكنيسة الجديدة. بمعنى أن الثراء هنا لم يشكل مانعًا أمام ممارسة الدين والمحافظة على الجانب الرُّوحي أو العَقَديّ فيه، لكن الثراء ساعد تلك العائلات الثرية على اتباع طريق الإصلاح الديني الذي حررها من قيود الكاثوليكية التي تحجرت مع الزمن وصارت بحاجة إلى إصلاح.
ولعل معظم دول الخليج العربي الحديثة خير مثال على فكرتي عن مساهمة الاقتصاد الوطني الناهض في تقديم وجه حديث للإسلام كدين تسامح وتعايش ودين دنيا وإقبال على الحياة وتوازن نفسي وطمأنينة روحية. فنهوض الاقتصاد الوطني وما نتج عنه من رخاء اقتصادي للمواطن الخليجي الذي توافرت له ضمانات العيش المادي الكريم ووسائل الراحة وإمكانيات الاستثمار والعمل الذي تجيزه قوانين سلسلة تسهل من حركة المال والأعمال والتجارة والقوانين التشريعية التي تتجاوز العقبات الشرعية التي يمكن أن تعرقل خطوات الاقتصاد السريعة (مثل إيجاد البنوك الإسلامية لتجاوز مشكلات الفائدة التي تتعامل بها البنوك والمصارف الحديثة والتي قد تفهم إسلاميًّا بوصفها ربًا)، كل ذلك جعل من الدين الممارس هناك، دين يسر لا عسر، دين طمأنينة روحية لا دين قلق وخوف وتوجس وإحساس بالرقابة والتوتر.
سمح الاقتصاد إذن للمؤمن الخليجي بالاستمتاع بالدنيا والعيش فيها دون ذلك الشعور بالتناقض الأنطولوجي بين الدنيا والدين. وقد كان لتحرر الاقتصاد الخليجي أن رطّب من الجفاف الصحراوي وجعله أكثر تحررًا وخلصه من وهم الهوية القبلية للدين فانفتح المسلم أكثر على الآخر (الذي جاء الخليج مستثمرًا أو تاجرًا أو ناقلًا أو عاملًا إلخ). وقد ساهمت هذه الظروف الحضارية الإيجابية المحمولة على جناح الاقتصاد في الكشف مجددًا عن وجه التسامح والتعايش المشترك وقبول الاختلاف في الإسلام، وهو وجه حجبته طويلًا القراءات المتشددة المغلقة الرافضة للآخر، وهي -مرة أخرى- قراءات تولد في ظروف الفقر والقهر والانعزال الحضاري.
ولعل المملكة العربية السعودية، التي راحت تأخذ مسارًا منفتحًا، هي المثال الأبرز حاليًّا على معقولية هذا الطرح. بإرادة سياسية وطنية شابة وطموحة راغبة في التغيير وبوعيها بضرورة فك اعتماد اقتصاد ذلك البلد النفطي على البترول الذي لن يدوم إلى الأبد، وجدت السعودية ضرورة تحديث قوانين البلد لتسمح للاستثمارات الأجنبية بإمكانية الاستثمار وتوطين شركاتها في بلد كانت قوانينه الدينية تنفِّر رؤوس الأموال الخارجية. هكذا راح الإسلام في المملكة العربية السعودية بدوره يتحرر من القراءات المتشددة، بل يصفي حساباته معها لفتح الأبواب أكثر على الإصلاح الديني والفكر النقدي، والفلسفة والفنون أيضًا. فعندما تبدأ البلد في عملية البناء والنهوض تنهض معها أو خلفها، بقوة التغيير، روح الشعب وطرق التفكير والذهنيات وتتكسر قشور التشدد الصلبة ويتكشف الدين عن يسر حقيقي ويتحول إلى ممارسة حقيقية تعطي الدين أفقًا حضاريًّا جديدًا وعمرًا جديدًا يخرجه من مأزقه الحضاري المزمن الطويل.
أظن أن مفتاح التحرر الإسلامي كذلك في بلدان إسلامية غير عربية مثل إندونيسيا وماليزيا كان الاقتصاد أيضًا. فالطموحات الاقتصادية لبلد مثل ماليزيا أراد التشبه باقتصاد نمور آسيا الأربعة في العقد الأخير من القرن الماضي قد دفعته نحو تحرير الإسلام الشعبي البسيط من عقد الخوف من الحرية ورهاب الآخر.
هكذا يسهم الاقتصاد في مساعدة الدين على التجدد والانفتاح والتأقلم مع روح العصر، بل وصياغتها ضامنًا بذلك للإنسان حريته وتحقيق ذاته دون أن يتخلى بذلك عن دوره الجوهري كدين يضمن الطمأنينة الروحية والسلام الداخلي وتحقيق مكارم الأخلاق والهداية والتعايش والتسامح بين البشر.
الدين في الصين ومجتمع السوق والدولة[]

جاك بارباليت[] – عالم اجتماع أسترالي، ترجمة: حمدي عبدالحميد الشريف – كاتب ومترجم مصري
متى نظرنا إلى المناقشات السائدة حول العلاقة بين الدين والاقتصاد سنجد أن لها بعض التمثلات الرمزية في تفسيرات ماكس فيبر الكلاسيكية المتعلقة بالتقارب الانتقائي بين الكالفينية (Calvinism) وروح الرأسمالية الحديثة. ومع هذا، فإن عرض فيبر للدور الداعم للمعتقد الديني في صعود الرأسمالية وازدهارها قد انعكس في معالجته لتاريخ الصين حيث زعم أن الكونفوشيوسية والطاوية كان لهما تأثير تقييدي مقنع في الترشيد الاقتصادي. ولهذا التحول بعد إضافي، حيث إن النتيجة غير المقصودة لتطور اقتصاد السوق المتوسع والتصنيع المصاحب له في الصين منذ إصلاحات دنغ شياوبنغ في عام 1978م تمثلت في توفير مساحة للتعبير الديني لم يسبق لها مثيل منذ ظهور النظام الشيوعي في الصين عام 1949م، وربما حتى قبل هذا الوقت نظرًا للسياسات السلبية السائدة تجاه الدين من جانب الدولة في أثناء مدة الجمهورية منذ عام 1912م.

دنغ شياوبنغ
سوف يظهر في هذا المقال أن إحياء البوذية والطاوية، وهو إحياء يبدو على المستوى الظاهري أقل ارتباطًا بتعزيز اقتصاد السوق في جمهورية الصين الشعبية من المسيحية، هو آلية مهمة في توفير الاستثمار المطلوب للتنمية الاقتصادية في الصين. إن نمو البوذية والطاوية يجذب ويغذي المساهمين الصينيين المغتربين في اقتصاد البر الرئيس الصيني. ويثير هذا التطور الشكوك حول تفسير ماكس فيبر للتأثير السلبي للتوجهات الكونفوشيوسية والطاوية في النشاط الرأسمالي. وذلك لأن السكان الصينيين في الخارج الذين حققوا نجاحًا اقتصاديًّا يعتنقون بصفة عامة العقيدة الكونفوشيوسية والطاوية التقليدية التي رأى فيبر أنها مسؤولة عن تثبيط تطور التوجهات والممارسات الرأسمالية.
الحرية الاقتصادية أو سياسة عدم التدخل
في الاقتصاد والطاوية: حالة (وو وي[]) Wu Wei
أثبت جوزيف نيدهام، المؤلف المتميز لكتاب متعدد الأجزاء «العلم والحضارة في الصين» (1954-2004م)، أن كل الاختراعات المهمة في تاريخ البشرية تقريبًا نشأت في الصين: ولا تشمل هذه الاختراعات البارود والطباعة فقط، ولكن أيضًا المشروبات الكحولية، والمحامل الكروية، والبوصلة المغناطيسية، والورق، وورق التواليت، وفرشاة الأسنان، وما إلى ذلك.

جوزيف نيدهام
وفي هذا الصدد استعار الاقتصادي الفرنسي فرانسوا كيسناي، عقيدة عدم التدخل الصينية، عمدًا، في تطوير نظريته الفيزيوقراطية. والمغزى من هذه النصوص التي تركها لنا، هو أن الدولة التي تمارس (وو وي) تمارس سلطة أقل، ومع هذا يُنجَز كل شيء وفقًا لاحتياجات الدولة. وليس من الضروري بطبيعة الحال أن نعود إلى أسرة هان للعثور على أدلة تشير إلى ميول الصين قبل عام 1978م نحو مبدأ عدم التدخل أو رأسمالية السوق. فقبل أن تتبنى الصين اقتصاد السوق في الثمانينيات، كان المهاجرون الصينيون الجنوبيون إلى شرق وجنوب شرق آسيا منذ منتصف القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين منخرطين بنجاح في الأنشطة الرأسمالية. وسنبين في القسم الثاني من المقال أن رأسمالية الصينيين المغتربين كانت، وبشكل يثير التناقض، عاملًا فعالًا في التطور الأحدث لسوق رأس المال في جمهورية الصين الشعبية، بمساعدة الدولة الصينية. كذلك فإن الطاوية لا تزال تقوم بدور في نجاح الرأسمالية الصينية، كما فعلت في صياغة مبدأ عدم التدخل في عهد أسرة هان. ومنذ عام 2000م، ظهر في مجلات العلوم الاجتماعية والحزب الصينية عدد من المقالات التي تُطَبَّق فيها المفاهيم الطاوية، وبخاصة (وو وي) والمفاهيم الأخرى ذات الصلة، لفهم تطور وإدارة اقتصاد السوق الصيني.
إدارة الدولة للدين واقتصاد السوق في الصين منذ عام 1978م
من الملحوظ أن القبول المشروط الجديد للدين في جمهورية الصين الشعبية هو جانب من جوانب التحرير الأوسع الذي رافق اندماج الصين في الاقتصاد الرأسمالي الدولي ودخولها إلى المسرح السياسي العالمي. وبينما يستمر قمع الدولة للحركات الدينية مثل فالون غونغ وحركة دونجفانج شانديان الأصغر (والمعروفة أيضًا باسم «البرق الشرقي») في جمهورية الصين الشعبية، فإن الضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية أمور معترف بها لدى المنظمات البوذية والطاوية والكاثوليكية والبروتستانتية والإسلامية التابعة للهيئات الجامعة التي تسيطر عليها الدولة. إن العلاقة بين التحرر الديني في الصين، وبخاصة إعادة بناء المعابد البوذية والطاوية، وبين التنمية -والازدهار المندفع في واقع الأمر- لاقتصاد السوق في جمهورية الصين الشعبية يمكن العثور عليها في بُعد آخر ومتصل لإعادة توجيه الحكومة منذ منتصف الثمانينيات، أي الانقلاب في الموقف تجاه الشتات الصيني.

الرأسمالية والصين وماكس فيبر
ليس حجم نمو وقوة اقتصاد السوق في الصين هو الذي يثير الإعجاب فحسب، بل إنه اندلع ضد كل التوقعات. ويمكن القول: إن النمو الاقتصادي في الصين كان حتميًّا بالتخلي فعليًّا عن الاشتراكية، واحتضان السوق، والانضمام إلى العولمة الرأسمالية. وبوسعنا أن نرى القيود التي تعيب هذه الحجة جزئيًّا في فشل الهند في التمتع بمستويات التوسع الاقتصادي التي حققتها الصين. ومن المهم أن نلحظ، كما ذكرنا آنفًا، أنه في القرنين التاسع عشر والعشرين، شُكِّلَت سلالات تجارية ومالية داخل المجتمعات الصينية في الخارج، وهذا يدل على الطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق فرص السوق من جانب الأشخاص الذين يعتنقون الديانات الصينية. ومع هذا، وفي حجة لا تزال تحظى باهتمام العديد من علماء الاجتماع، أكد ماكس فيبر على أن الديانات الصينية التقليدية والالتزامات العائلية المرتبطة بها تتعارض مع تطور الرأسمالية. ومع هذا، وفي مواجهة النجاح الاقتصادي الصيني الأخير في كل من السكان الصينيين في الخارج وفي جمهورية الصين الشعبية بعد عام 1978م، يجب أن تكون المهمة هي التوضيح من جديد لمسألة كيف يمكن للدين في الصين والبنية الأسرية المرتبطة به أن يكونا مرتبطين بالتنمية الرأسمالية.
إن توصيف فيبر للدين في دولة الصين في كتابه «الدين في الصين» يعنى بإظهار الأساس الثقافي لإخفاق الإمبراطورية الصينية في تطوير الرأسمالية الصناعية العقلانية أو الحديثة. ويرى فيبر أن القيم الصينية التقليدية في العقيدة الكونفوشيوسية عززت توجيه المواهب نحو خدمة الدولة، وإلى المساعي العلمية التي تميل إلى الحفاظ على التقاليد وفي الوقت نفسه إلى ثني عزيمة المفكرين عن الابتكار والإبداع. وعليه؛ فإن الكونفوشيوسية، وفقًا لفيبر، تولد عقلانية تقود الأشخاص إلى التكيّف مع العالم بدلًا من تشجيعهم على تغييره.

فرانسوا كيسناي
إن الأدلة على القيود المؤسسية السياسية والاقتصادية تتحدى مدى كفاية حجة فيبر بأن «رأسمالية المشروعات العقلانية… قد عُوِّقَتْ [في الصين]… بسبب الافتقار إلى عقلية معينة». ومع هذا، ليس الغرض هنا الادعاء أن الكونفوشيوسية والطاوية لا علاقة لهما بفهم العمليات الاقتصادية، وبخاصة نشاط ريادة الأعمال في المجالات الثقافية الصينية. ولكن من المهم أن ندرك، خلافًا لنهج فيبر، أن النتائج الاجتماعية للثقافة، والقيم على وجه الخصوص، ليست داخلية بالنسبة للثقافة أو القيم نفسها ولكنها فعّالة من حيث السياق.
إن ميل فيبر إلى التعامل مع المؤسسات من حيث ما يراه من القيم المتأصلة فيها أدى إلى سوء فهم خطير فيما يتعلق بوظيفة المؤسسات الرئيسة، بما في ذلك الأسرة. ففي كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»، على سبيل المثال، كتب فيبر أن العقيدة أو الدعوة البروتستانتية تولد انفصالًا عاطفيًّا وتزيل شخصية العلاقات الأسرية، وبالتالي تقديم رواد الأعمال الأوربيين في أوائل العصر الحديث كأفراد متحررين من الروابط العائلية والالتزامات التقليدية. وقد ذكر فيبر هذا المنظور حول الأسرة بقوة أكبر في دراساته اللاحقة، وبخاصة في كتابه «الدين في الصين»، حيث قال: إن الأسرة والمجتمع مصدران للقيود التقليدية التي تمنع الروح الرأسمالية المتمثلة في تحقيق الربح في حد ذاته نتيجة للقيم الدينية. ومع هذا، فإن هذه الحجة خاطئة بشكل خطير، سواء للرأسمالية الغربية أو الرأسمالية الصينية. ويمكن القول بالنسبة لمسألة العلاقة في الصين بين الدين والرأسمالية: إن محرك النمو الاقتصادي هو رأسمالية العائلات وليس الأفراد المنعزلين اجتماعيًّا والمشبعين برغبة التملك في كل من أوربا، وفي الشتات الصيني منذ القرن التاسع عشر. ومن هنا كانت العائلات والأسر موردًا للتنمية الرأسمالية.
الدين في الصين وتوسيع هياكل الفرص والموارد
يؤكد العرض الذي قدمه فيبر للطاوية، في كتابه «الدين في الصين»، على ما يراه ثلاث سمات أساسية: نزعتها الصوفية، وتركيزها على الماكروبيوتيك Macrobiotics (= فن الصحة وطول العمر من خلال العيش بتناغم مع البيئة) والخلود، ونزعتها التقليدية- «فهي أكثر تقليدية من الكونفوشيوسية الأرثوذكسية»- المبنية على استخدام التقنيات السحرية. غير أن فيبر في تحليلاته، يخلط بين الطاوية التأملية والطاوية الهادفة والطاوية الهسينية، وهو ما يجعل تقييمه للعولمة لا يقوم على أسس راسخة. إن ادعاء فيبر أن تعاليم لاوتسي أو كتاب «داوديجنغ» تحتوي على «الصوفية التأملية» إنما يعكس ما وُصِفَ بأنه تفسير كونفوشيوسي عدائي الذي قبله على نطاق واسع المبشرون المسيحيون الذين كتبوا العديد من المصادر التي اعتمد عليها فيبر.
وهكذا، لقد أهمل فيبر العقيدة الطاوية نسبيًّا في اعتبارات الدين في الصين، ربما لأنها أضعف مؤسسيًّا من البوذية. ومع هذا، فإن الطبيعة المنتشرة للدين في الصين تعني أن أهميته وتأثيره لا يمكن قياسهما بعدد مؤيديه ولكن بمدى انتشار مفاهيمه. وعلى سبيل المثال، يعتمد النهج التقليدي لربط نجاح الأعمال الصينية في الخارج بالمبادئ الكونفوشيوسية على افتراض أن ديناميات الأسرة الصينية ذات أسس كونفوشيوسية. وهناك أكثر من عنصر من الحقيقة في هذا الافتراض، على الرغم من أنه يتجاهل أهمية الأفكار الطاوية فيما يتعلق بالأسرة والعلاقات الزوجية. وتعمل هذه الأفكار على تقريب وتعزيز المبادئ الكونفوشيوسية المرتبطة بمتانة الأسر الصينية، وبخاصة ما يتعلق بتشجيع الطاوية على اكتشاف المسار «الطبيعي» في العلاقات، وتأكيد أهمية الأنوثة، ومن ثَمّ تشجيع نوع معين من احترام المرأة.

خاتمة
من الممكن النظر إلى الدين في الصين واقتصاد السوق الصيني بوصفهما داعمين بعضهما الآخر بطرق عدة. أولًا، كان إحياء البوذية والطاوية في الصين ما بعد عام 1978م قناة مهمة للاستثمار في اقتصاد السوق لجمهورية الصين الشعبية منذ الشتات الصيني. وثانيًا، يشير نجاح الصينيين المغتربين منذ القرن التاسع عشر في المشروعات الرأسمالية في شرق وجنوب شرق آسيا إلى وجود علاقة إيجابية بين عقلانية السوق من ناحية والدين في الصين والأسرة من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن منظور فيبر الذي لا يزال مقبولًا. وثالثًا، أوضحنا نهج التعامل مع الدين كجزء من جهاز ثقافي فعال في فهم هياكل الفرص للنشاط الرأسمالي، وهو الأمر الذي يشير إلى أهمية عدم التفرد الديني للأديان في الصين عامةً والطاوية خاصًة بالنسبة لارتباطات السوق الناجحة من خلال إدراك الفرص. وقد أشرنا إلى أهمية العلاقة بين السلطة السياسية للدولة والدين. كما وصفنا العلاقة التاريخية الطويلة في الصين بين الدولة والدين بأنها علاقة تنظيم الدولة للدين، وهي علاقة تسودها حلقات قصيرة متفرقة من المحسوبية أو الحظر. وكثيرًا ما تضمنت العلاقات التنظيمية خيارًا مشتركًا للقوى الدينية لأغراض الدولة. ويتجلى هذا في مرحلة ما بعد عام 1978م الحالية من خلال برنامج إعادة ترميم المعابد وتجديدها الذي ترعاه الدولة ولكن بتمويل خاص، الذي يعدّ قناة لاستثمار رأس المال في جمهورية الصين الشعبية من جانب الصينيين المغتربين.
في المقارنة بين الدين في الصين والدين في الغرب، ظهر أن المصطلح الصيني للدين، زونغ جياو، اختُرعَ في القرن التاسع عشر لأنه لم يكن موجودًا من قبل. فلقد كان الدين بالمعنى الغربي الحديث لنظام عَقَديّ مدعوم بالعقيدة والتنظيم والقيادة غائبًا ببساطة عن المجتمع الصيني. وترتبط التقاليد الصينية للمعابد وممارسات الطقوس وممارسي الاحتفالات بالمجتمعات المحلية وإيقاعات احتياجاتهم في أماكن متعددة الوظائف حيث لا يكون لشعائر الدينية سوى القليل من الأهمية وتسود فيها الأصول الأدائية. وفي هذا السياق، فإن إدخال مفهوم «الدين»، كنظام عقائدي لجماعة يقوم على تنظيمها رجال دين محترفون، إنما يتحدى طقوس وممارسات المجتمع التقليدية من خلال فصل «الخرافة» وكذلك «الثقافة» عن «الدين» على حساب الأشكال التقليدية (Ashiwa and Wank, 2009: 9–12; Dean, 2009: 188–91). وعلى هذا فإن اختراع الدين في الصين في القرن التاسع عشر، الذي استند إليه فيبر وساهم فيه، كان بهذا المعنى أداة أخرى لتنظيم الدولة في خدمة التحديث. وأحد جوانب الدين في الصين، إذا استخدمنا المصطلح بفطنة، الذي ظل بشكل أو بآخر خارج نطاق تنظيم الدولة وسيطرتها، وقد أشرنا إليه آنفًا على أنه جوانبه «المنتشرة». وهذا يشمل الأصول المفاهيمية والتنظيمية للتراث الثقافي الموجود في اللغة والمفاهيم. ويُعَدُّ هذا الجانب من الدين في الصين مؤشرًا على فطنة منظومة الأعمال الصينية في توليد هيكل فرص موسع ضروري للمشاركة في السوق.
السوق حقلًا جديدًا للصراع الأيديولوجي
من خلال ابتكار «المنتج حلال»

شهاب اليحياوي – باحث تونسي
تستدعي إستراتيجيات الانتشار الديني الحديثة، بحثًا عن عودة الديني أو اختراقه للمجال العام الذي طالما تحصن تدثرًا بمعقولية الحداثة والعلمنة في وجه الحيز الديني المخصوص[]، مجالات المشترك اليومي في توظيف جديد يعيد ترتيب العلاقة بين الخطاب التجاري والخطاب الديني والأخلاقي أيضًا. فهذه المجالات التي أبرزها اللباس والموضة والاستهلاك اليومي أو المناسباتي للسلع الغذائية، تشكل عوالم ثقافية تشي رساميل اجتماعية وثقافية ورمزية[] تحرك وتبرر السلوك والأفعال الفردية وتمنحها عمقها الجماعي وتجذرها المجتمعي. وقد شكل هذا المنحى إستراتيجية تسويقية للخطاب الديني الإسلاموي اتخذ من اللباس أو الأكل بدرجة أولى والمواد الصحية والصيدلانية والتجميلية والسياحة بدرجة ثانية منفذًا لتسلل الديني إلى التجاري أو استدعاء التجاري إلى عالم الديني في مزيج يستشكل بعمق هذا التوجه التجاري الجديد الذي نشهده منذ مدة والمسمى بالتجارة الحلال أو باختراق يتجاوز اللفظ (العلامة التجارية/حلال)[] إلى توظيف مفاهيم واصطلاحات دينية ضمن مجال البيع والشراء ومنطق جديد للتسويق والترويج يحيلنا إلى معقولية رأسمالية مبتكرة تقوم على تتجير الديني في اتجاه يوسع دائرة وفئات المستهلكين ويخلق سوقًا ومعاملة تجارية مبتكرة ذات فاعلية ومردودية تجارية عالية.
فهل نحن أمام إستراتيجية رأسمالية تسويقية وبالتالي حركة تتجير للدين بغاية تتجاوز دائرته؟ أم إننا أمام ديناميكية جديدة لأدينة الحياة الاجتماعية تتخذ من السوق حقلًا جديدًا للصراع الأيديولوجي ولتنشيط صحوة جديدة بآليات مجددة؟
التجارة الحلال: بين تصور الذات والديناميكيات الاقتصادية
هل ظاهرة التجارة الحلال مصطلحًا وممارسة، هي فعل ديني أو مسيرة دينية كافرة بقناعة أوليفيه روا[] وجيل كيبيل تقبلها قيم السوق أو تلبسها بقيم العلمنة هو أساس فشل ما يسمى بالصحوة الإسلامية في تقديم خطاب هووي ديني نقي؟ أم إننا أمام ديناميكية أدينة للنشاط التجاري في سياق حركة مصالحة المسلم مع سياقه المعيشي الذي يطرح عليه إشكالات يومية تربك فعله وتواصله مع ذاتيته وتمثلاتها ومع وضعياتها الحياتية التي تحكمها قيم ومعانٍ لا تمنح لبعد الهوية في الإنتاج والترويج والتسويق للسلع الاستهلاكية بالذات أهمية؟ فيستشعر المسلم شديد التدين أو المتدين القلق أن مجاله الاجتماعي المشترك يتغافل أو يتجاهل اختلافه وقلقه الهووي، ويجبره على بذل جهد أكبر في فهم بيئته الاجتماعية أو ترغمه بمنطق الحاجة على قبوله والتأقلم مع أشيائه وقيمه.
من هذا المنطلق قد يبدو هذا المدخل القيمي والهووي (هوية دينية للبضاعة) جسر مصالحة المتدين القلق[] مع سياقه الاجتماعي المقلق، أو أنه نافذة المتدين للمجال العام وحضور في حضرة التمايز الذي يرضي صورته لذاته[] ولمنظوره المخصوص للعلاقة بالعالم. فالجاليات المسلمة في البلدان الغربية خاصةً، وفي سائر البلاد الإسلامية عامةً، تعيش قلقًا وحيرة في التعامل مع المنتجات الغذائية الحيوانية بالخصوص لجهلهم بطريقة ذبحها التي تتناقض مع الشروط والنواهي الإسلامية التي تحلل وتحرم استعمالها؛ لذلك فإن حضور التاجر المسلم في الفضاء التجاري أو أفراد هذه الجالية بعلامة «حلال» أو «ذبح على الطريقة الإسلامية» هو خلاص للمسلم من حيرة وتردد يلازمانه معيشيًّا واستبدال تردده ونفوره الاستهلاكي من هذه المنتجات بتبضع مطمئن يطلق ميوله الاستهلاكية ويوسع دائرتها.

أوليفيه روا
أليست، إذًا، كلمة «حلال» التي توضع على غلاف منتج، هي حيلة تجارية تسويقية وتوسيع دائرة الاستهلاك والمستهلكين لا تشكل القيمة الدينية غاية ضمن دينامية أدينة للمجال العام بغاية رسم الفواصل الأيديولوجية وتوسيع حضور المجال الديني الخاص، كما يجوز أن تقرأ الظاهرة ذاتها في منظور تفهمي آخر. فاستدعاء الديني ضمن حقل الاقتصادي يجوز فهمه على أنه ابتكار بمفهومه الشومبتري[] الذي يجعل من التاجر المسلم أو التاجر المتأسلم[] أو الموظف للخطاب الديني في التجارة والمعاملات التجارية مقاولًا يلتقط بذكائه التجاري ومعقوليته الاقتصادية الرأسمالية فكرة جديدة ينجح في تسويقها لخلق ممارسة جديدة (تجارة متأدينة) أو فكرة جديدة أو منتج جديد (بضاعة إسلامية) أو تغيير موقف المستهلكين من منتج ما يمنحه مجالًا جديدًا للانتشار والرواج أو قد يخلق عنصرًا جديدًا في السوق (التاجر المسلم) وخلق مؤسسات اقتصادية وتجارية جديدة (صناعة الحلال) أو في كثير من الأحيان خلق أسواق جديدة لم تكن موجودة وذات قدرة تنافسية وتسويقية عالية.
فسوق الحلال تجاوز بُعده المحلي الموصول بالجاليات الإسلامية ليتوسع إلى البلدان الإسلامية ذاتها، وليشكل سوقًا عالمية للحلال كقطاع اقتصادي جديد موسوم بالقدرة السريعة على النمو وتحقيق أرباح ضخمة. فصناعة الحلال العالمية أضحت من القطاعات الأسرع توسعًا مجاليًّا وتنمويًّا يقدر سنويًّا بـ20٪ مما يبوّئها المراتب الأولى عالميًّا في سرعة النمو. فسوق الحلال العالمي تجاوزت دائرته الزبونية أو الاستهلاكية مليار وثمانمئة مليون مسلم في مختلف بلاد العالم، ولم يعد ينحصر في الغذاء والمنتجات الغذائية، بل توسعت إلى صناعات الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية، ومستلزمات وأجهزة طبية والأزياء، والسياحة الحلال، ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، والعلامات التجارية. وتشير تقديرات تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017/2018م إلى أن الإنفاق الإسلامي العالمي على قطاعات الحلال بلغ تريليونَيْ دولار في عام 2016م. وتستأثر المواد الغذائية والمشروبات بالنصيب الأوفر حظًّا في إنفاق المسلم بمبلغ 1.24 تريليون دولار، تليها الأزياء بمبلغ يصل إلى 254 مليار دولار، و198 مليار دولار على الإعلام والترفيه والإنفاق على المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل بقيمة 83 مليار دولار و57.4 مليار دولار.
لا يستقيم إقصاء تأويل أن تكون الظاهرة وتوسعها في المجتمعات الغربية تعبيرًا عن عودة الديني وتوسع الصحوة الدينية للجالية المسلمة بهذه المجتمعات، أو كذلك بالمجتمعات المسلمة ذاتها في حركة تبحث عن مصالحة السوق (الحقل الاقتصادي) للهوية وقلقها الذي يدفعها إلى البحث فيما يمثل، ضمن عالم السوق والتبضع، خصوصيتها[] الثقافية. فتتمسك بنظام البيع الحلال هذا وتصنع منه ما يسيج وعيها بهويتها أو يمنحها عنوانًا هوويًّا في المجال العام الذي تتحرك وتتفاعل ضمنه مع المختلف والمغاير. فالمسألة إيمانية بالنسبة للمتبضع لكونها تصالحه مع ذاته ومع صورته ومع المنظومة القيمية للدين، لكنها ليست دائمًا كذلك بالنسبة للمقاول المنخرط ضمن هذه السوق أو الصناعة المتدينة أو المتأسلمة. فهو تاجر وصانع يحتكم فعله أساسًا إلى القيم الربحية لنشاطه وإلى المردودية السوقية لاختياراته. إننا هنا أمام سردية دينية جديدة (برجوازي متدين أو متدين برجوازي)، لا تمثل أدينة السوق غاية لديها، بل إن التداخل بين الديني والاقتصادي يحمل معه تجربة نجاح بما أنها تخلق من الدين وقيمه رافعة روحية للفعل الاقتصادي (الناجح أو الرائج)، وتجعل من السوق أو النشاط التجاري رافعة مادية لتوطين رابطة بالهوية الدينية.
على أن تخالف معايير الحلال بين المجتمعات ضمن الأسواق العالمية للحلال، لا يتسيج دائمًا بمضمونه وبعده الاقتصادي، بقدر ما يشي تأثير الاختلافات المذهبية والتنوع الإثني للمجتمعات، وما تحمله من أفهام وتموقعات فقهية متباينة ومتخالفة، تجد في الحقل الاقتصادي رافعة مادية (السوق)[] لفرض اختلافها، واستقطاب المتدين عبر سلوكه الاستهلاكي. وبناءً عليه فإن صراع شهادات الاعتماد الحلال للمنتجات تشتغل كدينامية لعب، تتخذ من تداخل وتنافذ الاقتصادي والديني خطابًا أخلاقيًّا يجسر بين معقولية السوق (المنطق التجاري) والمعقولية الدينية (رابط الفرد بالهوية) وتؤسس لديناميكية اقتصادية للتسرب الديني؛ أي تمرير مضامين دينية عبر المنتجات المتصالحة ظاهريًّا مع الحداثة والموصولة بأشكال متنوعة ومتعددة بالخلفيات الدينية، أو الرسائل والسرديات الإسلامية حتى المذهبية منها.
تشفير الهوية الدينية:[] نحو خطاب أخلاقي أكثر مقبولية في السياقات الجديدة للمنتج
إن اختراق الخطاب الديني للمجال العام الاقتصادي عبر منتج «الحلال» أو منتج ديني لا يستطيع أن يحافظ على عذرية الرباط بالديني في ظل سوق ينجح بعامل توسع دائرة الاستهلاك وظهور مستهلكين جدد غير إسلاميين، في إضعاف السياج الروحي الذي يحيط به الخطاب التسويقي للمنتج الحلال نفسه. فظهور مستهلكين للمنتجات الحلال لا ينتمون للدين الإسلامي ولا يدينون بقيمه يستدرج هذا الخطاب إلى مراجعات تفتح لقيم السوق التجارية اللادينية منفذًا أو طريقًا إلى مضمونه. فكيف لخطاب تسويقي لمنتج تمجده هوية دينيةٌ ما تصنع زبائنها، أو هي تستدرجهم بسردية رُوحية تُجَسّر بين الحاجات والرغبات الاستهلاكية للمتدين، وهويته أو رأسماله الثقافي؛ أن يحتمل إكراهات المجال العالمي الذي انفتح لهذا المنتج الجديد؟ فتوسُّع دائرة المستهلكين للمنتج الحلال من خارج دائرة الديني فتَحَ للعلمنة ولقيمها جيوبًا في المجال الأصلي والحيوي لهذا المنتج الديني بالأساس. أصبح لزامًا على معقولية التتجير والتسويق أن تخفف من قوة حضور الديني في التجاري والبحث عن سردية جديدة قادرة على المحافظة على الرباط الأصلي بمستنداتها ومقوماتها الدينية كمنتجات موجهة أساسًا لإشباع حاجات غير تجارية أو استهلاكية (دينية/ مخصوصة). فالمستهلك غير المسلم لمنتج مسلم اتخذ أبعادًا عالمية في تسويقه كجديد مغاير لا تعنيه القيمة الثقافية المولدة للمنتج بقدر ما تعنيه أبعاد الجدة والتفرد والابتكار والجودة والاختلاف في هذا المنتج الجديد.
 أحرج توسع حضور ومقبولية المنتج الإسلامي في المجتمعات الأوربية خلفيته الأصلية الهووية على نحو أجبره على تشفير هذا الرابط بالهوية الدينية أو تخفيف بعده المرئي أو قوة رابطه الهوياتي. وأصبح الدافع الاقتصادي والتجاري هو السياق الجديد للفعل التسويقي لهذا المنتج الإسلامي موضوع تزايد الطلب عليه في مجال غير إسلامي أو مجال معولم تحكمه معقوليات مغايرة للسياقات الأصلية لنشأة فكرة المنتج «حلال». غير أن المنتج لا يمكن له أن ينقطع عن عمقه الديني وعن تواصل رباطه بالجمهور المسلم وفي الآن ذاته هو مدفوع بعامل الرغبة في استثمار إعجاب وإقبال غير المسلم على البعد الجمالي والابتكاري في هذا المنتج الجديد والمغاير لخصائصه الثقافية، على صياغة خطاب جديد أقدر على امتصاص هذا التناقض أو هذه المعادلة الصعبة بين الديني والتجاري، الهووي والاقتصادي، الأسلمة والعلمنة.
أحرج توسع حضور ومقبولية المنتج الإسلامي في المجتمعات الأوربية خلفيته الأصلية الهووية على نحو أجبره على تشفير هذا الرابط بالهوية الدينية أو تخفيف بعده المرئي أو قوة رابطه الهوياتي. وأصبح الدافع الاقتصادي والتجاري هو السياق الجديد للفعل التسويقي لهذا المنتج الإسلامي موضوع تزايد الطلب عليه في مجال غير إسلامي أو مجال معولم تحكمه معقوليات مغايرة للسياقات الأصلية لنشأة فكرة المنتج «حلال». غير أن المنتج لا يمكن له أن ينقطع عن عمقه الديني وعن تواصل رباطه بالجمهور المسلم وفي الآن ذاته هو مدفوع بعامل الرغبة في استثمار إعجاب وإقبال غير المسلم على البعد الجمالي والابتكاري في هذا المنتج الجديد والمغاير لخصائصه الثقافية، على صياغة خطاب جديد أقدر على امتصاص هذا التناقض أو هذه المعادلة الصعبة بين الديني والتجاري، الهووي والاقتصادي، الأسلمة والعلمنة.
لم يجد المسوق للمنتج الحلال، الذي لم يعد الباعث المسلم بل الشركات الكبرى غير المسلمة، غير ما أسماه باتريك هايني بتشفير الهوية، أي إعادة التمفصل بين العلامة التجارية والمضمون الديني للمنتج الإسلامي في اتجاه يحافظ على البعد الهووي الديني (يصبح لا مرئيًّا أو أقل مرئية) من جهة ويخلق خطابًا ذا مقبولية أوسع عند غير المسلم المستهلك للمنتج «الحلال» بمعقولية مختلفة جرت هذه السلعة الدينية أن تتخفف من حمولتها الدينية وجسورها الأيديولوجية؛ لذلك وقع الاستعاضة عن الخطاب الديني بخطاب أخلاقي غير إثني أي غير مرتبط بالخصوصيات الدينية، حسب باتريك هايني، يكف عن صلابة القيود الدينية ويستبدل بها المضامين الأخلاقية (الحشمة مثلًا) ويمزج بين القيم الدينية والموضة العالمية (حدود جديدة رخوة بين المسلم وغير المسلم) عبر شعارات وعلامات تجارية تحيل بشكل غير صريح إلى معانٍ دينية أو طقوس تعبدية أو أسماء تاريخية أو رموز. فالحمولة الدينية للمنتجات الثقافية المتعولمة تغادر الخطاب المعلن لتعود بأشكال ترميزية ومدلولات رمزية تعيد صناعة الرابط الهووي للمنتج بالمستهلك الرئيس أي المسلم.
الخاتمة
ينكشف في هذا التراوح بين المعقولية التجارية ومنطق التسويق وبين البعد الهوياتي المولد لفكرة المنتج الحلال، ازدواجية خطاب يريد أن يطوع عالم التجارة (كمجال عام معلمن ومعولم) إلى قيم الدين (كمجال مخصوص موصول إلى معقولية مغايرة) أو ينفذ من خلاله إلى ممارسة الدعوة الدينية بأشكال مخاتلة ومجددة عبر منتج جديد يصالح بين المسلم في مجال غير مسلم مع عمقه الديني (الهوية) عبر أسلمة الموضة أو السياحة أو المنتج الغذائي أو المعاملات المالية أو البيع والشراء. غير أنه يفاجأ بتوسع مجتمعه الاستهلاكي نحو غير المسلمين وهو ما أرغم مقاولي المنتج الحلال على أن يسقطوا فيما أسماه هايني بإسلام السوق؛ أي تبنّي خطابٍ إدماجيّ بين الأسلمة والعلمنة وبين التجاري والديني عبر إستراتيجية التخفي وراء الجمالي والرمزي اللذين يمنحان الخطاب التسويقي الجديد ديناميكية أقدر على استيعاب تناقض مرجعيات المستهلكين للمنتج الحلال. أم إننا أمام تحولات حقيقية تكشف أو تعاظم علاقة رخوة بالدين تجسر نحول توسع حضور إسلام السوق في الممارسة الثقافية للدين وبخاصة المسلمون ضمن سياقات مجتمعية غير إسلامية؟ أم إننا أمام ما يسميه برغر Berger بإعادة السحر إلى العالم[] أي تحول المتعهد الاقتصادي إلى متعهد ديني يتخذ من الأشكال الثقافية المعولمة جسرًا نحو خطاب إسلامي متحجب بمعنى أنه يحتجب خلف منتجات ثقافية تنكر حمولتها الدينية.
المراجع:
– أبو العلا. محمد عبده، العلمانية وجدل العام والخاص، مؤمنون بلا حدود، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، إبريل 2016م. www.mominoun.com.
– بتلر. جوديث، الذات تصف نفسها، ترجمة: فلاح رحيم دار التنوير، ط 1، بيروت، 2014م.
– بدوي. أحمد موسى، ما بين الفعل والبناء الاجتماعي، بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديو، مجلة إضافات، العدد الثامن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009م.
– روا. أوليفيه. تجربة الإسلام السياسي، ترجمة نصيرة مروة، دار الساقي، بيروت، 1996م.
– شومبيتر.جوزيف.أ، الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2011م.
– غيرتز.كليفورد، تأويل الثقافات، ترجمة محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2009م.
– المعموري. ناجح، القرابات المتخيلة، دار تموز، ط 1، دمشق، 2012م.
– هايني. باتريك. «إسلام السوق»، ترجمة عومرية سلطاني، مدارات للأبحاث والنشر، الدار البيضاء، 2016م.
– Berger.Peter, Le Réenchantement du monde, paris, Bayard, 2001.
دور الدين في مواجهة أزمات العصر

علي محمد فخرو – كاتب بحريني
لا يمكن الحديث عن القيم والمبادئ التشريعية الدينية الضرورية والقادرة على تصحيح نواقص الفكر الاقتصادي العولمي الحالي وعلى مواجهة فواجع تطبيقاته في الواقع الإنساني الحديث، إلا إذا سبقه، ولو باختصار شديد، إبراز الفكر السياسي الذي يحكم بصور مشوشة الواقع الاقتصادي ويحدد له أهدافه وحدوده وعلاقته بعوالم الاجتماع البشري، التي يقبع الدين في قلبها. هذا الفكر السياسي هو في الواقع حصيلة مدارس فكرية متعددة تفاعلت وتصارعت عبر قرون عدة، خصوصًا ما بين شتى صور الفكر الليبرالي الديمقراطي من جهة، وشتى صور الماركسية الاشتراكية والشيوعية من جهة أخرى؛ ليصل لأسباب تاريخية متعددة ومعقدة، إلى صورته الحالية العولمية المهيمنة تحت شعار: النيوليبرالية العولمية، الذي يضيف إليه بعضٌ شعارَ الرأسمالية بحيث أصبح غير ممكن الحديث عن أحدهما من دون الحديث عن الآخر الملازم له فكرًا وممارسة ليصبح تحت اسم النيوليبرالية الرأسمالية العولمية.
باختصار شديد تطرح النيوليبرالية، وإلى حد ما يشاركها في كثير مما تطرح الفكر المحافظ الجديد، الأفكار والشعارات الأيديولوجية التالية:
أولًا- أن فكرة الأمة، التي تطلبت سلطة حكم قوية تنظم أغلب نشاطات مجتمع الأمة، هي فكرة قديمة ما عادت تصلح لهذا العصر، عصر العولمة، الذي يتطلب حرية تبادل الأسواق من دون عوائق تفرضها السيادة الوطنية للأمة.
ثانيًا- وبالتالي فإن مسؤوليات سلطات الحكم الوطنية وعلى الأخص ما عرف منذ نهاية الحرب الثانية بالالتزام بدولة الرعاية الاجتماعية، وعلى الأخص، في حقول التربية والتعليم والصحة والبطالة والإسكان والمواصلات العامة، يجب أن يقلّص ويتراجع، ليفسح المجال أمام خصخصة تلك الحقول الاجتماعية لتقوم بها شركات خدمات خاصة ربحية. وبالتالي فهي ليست حقوق بمقدار ما هي امتيازات على الإنسان أن يشتريها كسلعة.
ثالثًا- أما الاقتصاد فإن تلك النيوليبرالية الرأسمالية قد همشت جانبه الإنتاجي، الذي عدَّتْه الرأسمالية الكلاسيكية الكينزية هدف النشاط الرأسمالي الأساسي المنتج لمزيد من الثروة والمؤدي إلى زيادة أعداد أفراد الطبقة الوسطى، قد همشته ليصبح اقتصادًا ريعيًّا وافتراضيًّا وهميًّا يدور في فلك المراهنات والمبادلات المالية، وعلى الأخص فيما بين من يمتلكون المال الوفير، والتي بدورها قادت إلى تقليص حجم الطبقة الوسطى، وإلى زيادة فاحشة في غنى الأغنياء وتركز الثروة في أيدي أقلية صغيرة منهم من جهة، وفي الوقت نفسه أدت إلى زيادة مهولة في عدد الفقراء وفقرهم المدقع من جهة ثانية.
ولقد قاد كل ذلك إلى زيادة كبيرة في نسب البطالة الظاهرة والمقنعة، وإلى تراجع مأساوي في أعداد وقدرات وحقوق النقابات العمالية، وإلى رؤية الملايين المشردين النائمين في الشوارع، وإلى التفكك الأسري.
رابعًا- وما كان لتلك النظرة السياسية الاقتصادية إلا أن تقود إلى عَدّ ما يرسم صورة الإنسان الحديث يجب أن يتمثل في، أولًا، فردية منغلقة على الذات وأنانية وممارسة لحرية شخصية وسلوكية منفلته، من دون مراعاة لأعراف أو دين أو وجود معنوي لآخرين، وثانيًا يتمثل في ممارسة مجنونة قصوى لمنافسة الآخرين وسلبهم ما لديهم كلما أمكن. فجأة وجد الإنسان نفسه محصورًا في فرديته المطلقة وفي تنافسه الأناني المجنون مع الآخر. وأصبحت البشرية مكونة من رابحين وخاسرين، والمجتمعات تدار كمؤسسات تجارية، والعلاقات بين البشر هي علاقات مصالح أنانية متنافسة، وأصبح الفرد يسمى رأسمالًا، وأن أي حدّ وتنظيم لذلك التنافس هو اعتداء على مبدأ الحرية، ويقصد به بالطبع حرية السوق المنفلتة والحرية الذاتية المنغمسة في الاستهلاك النهم.
وما كان لتلك الصورة البائسة لعالمي السياسة والاقتصاد، التي وضع أسسها في أوربا الفيلسوف والناشط السياسي النمساوي فريدريك حايك، وانتقلت بعد ذلك للولايات المتحدة الأميركية ليتسلم لواءها الفيلسوف والناشط الأميركي ملتون فريدمان، ولتتبناها قوى هائلة من أصحاب الثروات وبعض الجامعات ومراكز البحوث الممولة من المليارديرات والإعلام المجيش ببراعة لينشر تعابير وشعارات وخفايا النيوليبرالية الرأسمالية، وليطرحها ويزينها كدين جديد… ما كان لتلك الصور البائسة إلا أن تنتهي مؤخرًا بهجمة شرسة على القيم الدينية والأخلاقية والعلاقات الأسرية وأساسيات الزواج، حتى على التركيبة الإنسانية الجنسانية.
من هنا الأهمية القصوى لإبراز الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه الدين، وبالنسبة لنا الدين الإسلامي بالطبع، فيما لو استعين بتوجيهاته العقيدية الربانية وتشريعاته وقيمه الأخلاقية لمواجهة الكثير من الانحرافات الفكرية والسلوكية التي حلت بعالمي السياسة والاقتصاد النيوليبرالي. وبالمناسبة فإن الكتابات الناقدة لذلك الوضع البائس، التي تتزايد بصورة ملحوظة في بلدان الغرب تنتهي دومًا بوضع اللائمة لحدوث الأزمات الحالية على غياب القيم أو التلاعب بها وعلى المبالغة في تمجيد نسبية القيم ورفض اعتبار أي منها كقيمة مطلقة.
في وقتنا الحاضر، ومع انفجار الصراعات العسكرية، وعودة التنافسات الاقتصادية غير المنضبطة وما يصاحبها من أزمات مالية وتضخم، وتفشي الأوبئة الغامضة في العالم كله، وإمكانية انقلاب التقنية إلى كابوس في المستقبل المنظور، دخلت الحضارة، وعلى الأخص الغربية، في عدم اليقين وفي الشك في كل مسلماتها السابقة.
هناك شكوك حول صحة وصدق مسلّمات حتمية التقدم، وحول صعود وهيمنة العقلانية، وحول كثير من أنواع الحريات الفردية والجمعية، وحول النظام الديمقراطي، وحول إمكانيات العلوم المطلقة في حل مشكلات البشرية، وحول مستقبل البيئة الطبيعية وكوارث تقلباتها، وحول الكثير مما في مختلف الديانات من شرائع وقيم، بل حتى حول الأيديولوجيات السياسية الليبرالية الكلاسيكية ومصادرها الفلسفية.
نحن أمام حقبة اضطراب ذهني ونفسي وروحي بالغ التعقيد؛ بسبب غياب أية مرجعية يوثق فيها ويستجار بها. لكن الجميع يتفق على أنه لن يوجد حل صلب ودائم لتلك المشكلات المعقدة إلا إذا رافقه حل لأخطر وأشمل علله: وهو المتمثل في موضوع عودة القيم والأخلاق والفضائل إلى عالمنا، وعلى الأخص إلى عالمي السياسة والاقتصاد.
وفي اعتقاد كثيرين فإن الدين الإسلامي، كما سنبيّن، هو أحد أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في مسيرة تلك العودة.
جدلية الدين الإسلامي والاقتصاد وخلفيته السياسية
بالنسبة للدين الإسلامي هناك تناقضات عميقة، غير قابلة لأية مقاربة، فيما بين ما يدعو له ويسمح به أو يرفضه وما بين ما تدعو له وتمجده الأيديولوجية النيوليبرالية الرأسمالية.
ويجمع كثيرون على أن الثورة في القيم أكثر ضرورة من أي ثورة أخرى؛ لأنها ليست شيئًا مجردًا وقائمًا بذاته، وإنما هي منصهرة في السلوك والنشاطات الإنسانية برمتها. وتكمن قيمة تلك القوى في أن المجتمع الدولي العولمي برمته سيحتاج، إضافة للقوانين والتنظيمات والعقوبات، التوجه نحو ضمير الإنسان وأعماق داخله إذا كان يريد لتلك القوانين والتنظيمات النجاح والاستقرار والديمومة في الحياة الإنسانية.
إن المدخل الإسلامي لذلك هو ما أكده القرآن الكريم مرارًا وتكرارًا من أن الإيمان يكسب صدقه وحيويته فقط إذا اقترن بالعمل الصالح. ولأن الإيمان مدخل للأخلاق والفضائل يخلص الكاتب المغربي طه عبدالرحمن إلى أنه خلافًا لما يقوله الغرب من أن ما يميز الإنسان من الحيوان هو العقل، فإن ما يميزه حسب النظرة الإسلامية تلك هو الأخلاق، وينتهي إلى أنه لا إنسان بغير أخلاق، ولا أخلاق بغير دين.
وينظر الكاتب الدكتور علي عيسى عثمان إلى الموضوع الأخلاقي من زاوية أخرى مكملة؛ إذ إن الأخلاقية الإسلامية تستطيع إيصال الإنسان، بما تقتضيه فطرته من مسؤوليات أخلاقية واجتماعية وعقلية، إلى عزله وحمايته من سيطرة الجماعة وسلطان الظروف والأوضاع التي تمثل العصر والمكان الذي يعيش فيه.
ويضيف المستشار محمد سعيد العشماوي من زاوية النظر إلى ما سبق لينتهي إلى أنه عندما يستقيم الضمير وتنقى النفس ويرقى العقل وتقوى الروح، فإن الإنسان يقيم النظم على أفضل ما تكون ويطبق القواعد أسلم تطبيق، وهو ما فشلت النيوليبرالية الرأسمالية في الوصول إليه عندما جعلت النظم الاقتصادية تنبع من حرية الأسواق ومن التنافس الانتهازي فيما بين أصحاب الثروات، وتوزع الثروة لما تمن عليه الظروف من انسياب بعض تلك الثروة المتذبذب القليل مما تتفضل به جيوب الأغنياء إلى أفواه من يكدّون ويعملون ليلًا ونهارًا ليسدوا رمقهم ويطعموا عائلاتهم. ويخلص إلى أنه عندما يتكون الإنسان الرباني الذي يسمو بنفسه وبواقعه فإنه يضع أفضل النظم ويطبقها أصدق تطبيق. وهنا يجب أن نذكر أنفسنا دومًا بما قاله المفكر علي شريعتي من أن الأرض يرثها الصالحون… الصالحون قولًا…. والصالحون فعلًا…. والصالحون فكرًا.

ولعل أهم ما يميز الصالحين هو عيشهم، فكرًا وسلوكًا ونضالًا، حسب أهم شعار قيمي يطرحه القرآن الكريم وأسمى فضيلة يكررها، عيشهم حسب متطلبات وطروحات دعوة الحق والقسط والميزان، أي دعوة العدالة. ويشرح المفكر فهمي جدعان الأهمية الكبرى لذلك عندما يذكرنا بأن القرآن الكريم نفسه قد خص هذا المفهوم بمكانة مركزية وجعله موضوع أمر إلهي وصفة ثبوتية من صفات الله نفسه ففي القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية يتكرر الأمر بالعدل، والحكم بالعدل، وبالحق، وبالقسط، وبالميزان، مثلما يتكرر النهي عن الظلم والجور، وتنزيه الله عن أن يتصف بهما. وهو العدل الذي ينشد تحقيق مكارم الأخلاق والخير العام والمساواة في الكرامة الإنسانية وتأكيد مصلحة الجميع.
وليس من قبيل المصادفات أن يصبح العدل، الذي أعطاه الإسلام كل تلك الأهمية المركزية، هو المبدأ الأسمى الذي تطلبه مجتمعات ومؤسسات العصر الذي نعيش، كما أكده العديد من فلاسفة العصر وكُتّابه، من مثل الفيلسوف الأميركي جون رولز الذي عَدّ العدالة الفضيلة الأولى التي تحتاجها مؤسسات العصر لتواجه بها الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعصف بالإنسانية حاليًّا.
ولا من قبيل المصادفات أن تكون العدالة الاجتماعية في الإسلام هي من أبرز الموضوعات التي طرحها كثير من المفكرين الإسلاميين طيلة القرن السابق إلى يومنا الذي نعيش. ولقد شدّد كثيرون منهم على أن العدالة الاجتماعية في الإسلام التي يتحدثون عنها هي عدالة إنسانية شاملة وجامعة، وليست اقتصادية فقط، تختلط فيها الأهداف الربحية المادية بالقيم الأخلاقية والروحية، وهي نظام تكافلي تضامني يتغير بتغير الأزمنة ولكن يجب أن يسمو بمرورها. وهي عدالة تلح على المساواة في الحقوق والواجبات، وبينما تقر الحرية الفردية إلا أنها تعدّ المصلحة العليا للمجتمع هي الحاكمة لتلك العلاقة فيما بين الفرد والمجموع. وبينما تقر حق الملكية الفردية فإنها تضع لها محددات وشروطًا تبعدها من الشطط والاستغلال.
أهداف السلام والتكافل والرخاء
ويستطيع الإنسان أن يرى في تلك النظرة الإسلامية لهذه الفضيلة الأخلاقية وما يتفرع عنها تحقيق أهداف السلام والسعادة والتراحم والتكافل والرخاء الاجتماعي، ورفضًا لكل علاقة تؤدي إلى مشهد الأزمات المختلفة والمتعاقبة التي برع الإنسان العصري وبرعت تنظيماته في تفجيرها. ولعل أسطع مثال على ذلك قصص الأنظمة والممارسات البنكية في إقراض القروض السكنية للأفراد التي فجرت العديد من الأزمات والإفلاسات في العقود الأخيرة بسبب التلاعب بمقدار وتذبذب وشروط فوائدها الربوية الفاحشة، من دون تدخل وضبط مبكّر من جانب سلطات الحكم لمنع الوصول لتلك الكوارث.
هنا يقدر الإنسان الموقف الإسلامي الأخلاقي الحقوقي من موضوع الربا لمنع كوارثه.
وإنه من الضروري الإشارة إلى أن تلك الصورة التي أبرزت بشأن إمكانية أن يكون هناك دور للقيم الإسلامية في مسيرة الاقتصاد والسياسة والاجتماع لا دخل لها بالمناقشات حول موضوعات الموقف من مثل الثيوقراطية أو العلمانية أو الحاكمية أو الديمقراطية أو العولمية أو كثير من الأيديولوجيات؛ ذلك أن موضوع نقاشها له مكان آخر ومقاييس أخرى خارج ما تطرحه هذه المقالة.
وأخيرًا، ففي كتاب صدر مؤخرًا في إنجلترا عن «الأخلاقية» بقلم جوناثان ساكز، يعيب على العالم الغربي كونه قد أوصل حضارته الحديثة إلى استهتار مخيف بالقيم الأخلاقية وبالعلاقات الإنسانية الذي يقف وراء أزماته الكثيرة الحالية. ما يلفت النظر هو أنه يختم كتابه بفصل كامل عما تستطيع الديانة التي ينتمي إليها فعله في عملية انبعاث جديد لتلك القيم والعلاقات.
ونحن بدورنا حاولنا تأكيد أن للديانات دورًا يمكن أن تلعبه، كما حاولنا إظهاره بوضوح بالنسبة للدين الإسلامي الحنيف، خصوصًا إذا تذكرنا أنه رسالة موجهة للإنسانية جميعها التي قالت عن هذا الحق: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾، وأنه ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾.
إعلاء الحق والقسط والميزان الرباني، قيمًا وعلاقات والتزامات ومكونات من الضمير والنفس والسلوك، يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في مواجهة كوارث الاقتصاد وغير الاقتصاد.
الاقتصاد والدين: علاقة جدلية أم تكامل؟
الاقتصاد ما بين الدين والإلحاد

شادي أرشيد الصرايرة – أستاذ الاقتصاد بكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية
الاقتصاد من العلوم الحديثة التي تعتمد على العلوم الرياضية والإحصاء وتقنيات تحليل البيانات؛ لذا لا يمكن الركون إلى النتيجة التي توصل إليها العلماء والمفكرون عن ماهية مسببات النمو واستدامة الازدهار الاقتصادي، دون اختبارها ضمن منهجيات وأساليب رياضية مقننة وموثوقة. وبناءً عليه؛ فقد فحص الاقتصاديون وحللوا بيانات يعود تاريخها إلى أربعين سنة مضت في عشرات الدول، وذلك في محاولة لاستكشاف الأثر الاقتصادي للمعتقدات أو الممارسات الدينية، ووجدوا أن الدين له تأثير ملموس في الاقتصادات النامية.
يقلل من الفساد
كذلك؛ قدم الاقتصاديون الإيطاليون نتائج تفيد بأن الدين يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة الثقة داخل المجتمع، كما أظهر باحثون في الولايات المتحدة أن الدين «يقلل من الفساد، ويزيد من احترام القانون بطرق تعزز النمو الاقتصادي العام». وقد جمع روبرت بارو، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، وراشيل ماكليري، الباحثة في مركز توبمان بجامعة هارفارد أيضًا، بياناتٍ من تسعة وخمسين بلدًا، يدين أغلبية سكانها بواحدة من الديانات الرئيسة الأربع، وهي الإسلام والمسيحية والهندوسية والبوذية، وذلك في المدة من 1981م إلى 2000م، وقاسوا متغيرات مثل: «مستويات الإيمان بالله، ومعتقدات الآخرة، وإقامة الشعائر الدينية»، ووضعوا كل تلك البيانات في نماذج إحصائية، لتظهر النتائج وجود علاقة قوية بين النمو الاقتصادي وبعض التحولات في المعتقدات. وفي ضوء ذلك تقول ماكليري: إنها ترى أن الدين يغير السلوك الاقتصادي للناس. وعلى الرغم من نمو عدد الملحدين عالميًّا في القرن العشرين، فإن تلك الزيادة لم تسر بمعدلاتها الطبيعية في الأعوام القليلة الماضية، التي تشير إلى نتيجة ربما لم تكن متوقعة، أو صادمة لمن يدعي غلبة الإلحاد على المستوى العالمي بحلول عام 2038م، وهي أن أعداد الملحدين في العالم قد تتناقص. فقد وجد الاستطلاع الذي أجراه معهد وين غالوب عام 2012م أن 13% من سكان العالم ملحدون، وبحلول عام 2015م انخفض عدد الملحدين بمقدار نقطتين مئويتين. وربما تثير تلك الإحصائية تساؤلًا منطقيًّا؛ إذ كيف يتراجع الإلحاد مع هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي وصل إليه العالم الآن؟ وبخاصة مع ربط اللادين العام والشعبوي بشكل ما بالتقدم الاقتصادي، إلا أنه ربما تتكشف في الأعوام القادمة بشكل أكبر درجة التفاعل بين الإلحاد والدين وتأثيرهما في الوضع الاقتصادي.
مبادئ وقوانين الاقتصاد الإسلامي
صلاح الحمادي – أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالجامعة العربية المفتوحة بالكويت
الدين الإسلامي له علاقة مباشرة بالاقتصاد من خلال توجيهاته وقوانينه الاقتصادية الخاصة. ومن أهم مبادئ وقوانين الاقتصاد الإسلامي تحريم الربا، أو الفوائد المفرطة، حيث يُعَدّ الربا أو الفوائد المفرطة محرمًا في الإسلام. وهذا يؤثر في نظام التمويل والقروض في الاقتصاد الإسلامي الذي يشجع على الصيرفة الإسلامية وممارسات التمويل الخالية من الربا، والزكاة التي هي صدقة مفروضة على الأثرياء، لتوزيع جزء من ثرواتهم على الفقراء والمحتاجين. وتُعَدّ الزكاة جزءًا من النظام المالي الإسلامي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفقر. ثالث هذه المبادئ هو العدالة الاجتماعية، حيث يشدد الإسلام على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة على نحو عادل. وهو ما يؤثر في السياسات الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة. وخامسها هو المشاركة في المخاطر والأرباح، فنظام الصيرفة الإسلامي وأسواق المال الإسلامية تشجع على المشاركة في المخاطر والأرباح بين الجميع، ويتجنب المشاركة في الأنشطة المحرمة.
ومن ثم فإن الاقتصاد الإسلامي يهدف إجمالًا إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والامتناع عن الممارسات المحرمة والمعاملات غير العادلة والربا. هذه المبادئ والقوانين تشكل جزءًا أساسيًّا من العلاقة بين الدين الإسلامي والاقتصاد الإسلامي.
الأديان لم تضع نظامًا اقتصاديًّا للمؤمنين

عبيد خليفي – باحث تونسي
ليس للدين في الاقتصاد من شيء. هذه مصادرة يثبتها تاريخ الأديان، فالأديان جاءت لتحدد طبيعة العلاقات العمودية بين الذات البشرية والذات الإلهية، بين الأرض والسماء، وتنعكس على الحالة السلوكية الفردية القائمة على الأخلاق، أما الاقتصاد فهو علاقة أفقية بين البشر. في علاقة تقوم على العدل والظلم والاستغلال والربح والخسارة. أثبت تاريخ الأديان استغلالًا فاحشًا للدين في ممارسة النشاط الاقتصادي، وتحديد طبيعة علاقات الإنتاج من الريع والإقطاع والرأسمالية. في الأديان التوحيدية كان هناك تداخل وظيفي بين الاقتصاد والدين، ليس أقلها البحث عن بركة الكنيسة والبيعة والمسجد ورجال الدين، وليس أكثرها الحروب الدينية التي تخفي مصالح اقتصادية، فما يُسَمَّى الفتوحات الدينية هي رغبة لتحول الدول إلى إمبراطوريات اقتصادية تسيطر على مصادر الثروات والطرق التجارية الدولية، على الرغم من الصيغة التضامنية لمعاش الناس في الأديان فإن هذه الأديان لم تضع نظامًا اقتصاديًّا للمؤمنين، وقد حاول كهنة الدين ورجاله استنباط نظام اقتصادي في ظاهره تضامني، لكنه يحافظ على طبيعة علاقات الإنتاج الراهنة، ففي السياق الإسلامي مثلًا رفعت الصحوة الإسلامية شعارًا مركزيًّا «الإسلام هو الحل»، وكتب منظرو التيارات الإسلامية كتبًا تحت عناوين: «الاقتصاد الإسلامي»، ولكن هذه النظريات لم تصمد أمام النظم الاقتصادية سواء الاشتراكية أو الرأسمالية أو النيوليبرالية. فالصحوة قدمت نظريات التوفيق والتلفيق لرؤية سطحية ساذجة في تصور طبيعة علاقات الإنتاج، ومن ثم يقع تركيزها على مفهوم الاقتصاد التضامني الذي هو مفرزة لتلطيف وحشية النظام الاقتصادي الرأسمالي.
ماكس فيبر والنظام الرأسمالي الحديث
وقد اعتقد ماكس فيبر أن النظام الرأسمالي الحديث الذي تطور في القرنين السادس عشر والسابع عشر في أوربا يعود في روحه إلى الذهنية البروتستانتية التي أنتجت قيمًا ومعايير عقلانية جديدة، شجعت على العمل الحر والتنسك والادخار، وخلقت مناخًا فكريًّا ساعد بدوره على تطور النظام الاقتصادي الحر، وبالتالي على تطور ونمو الرأسمالية في أوربا، وهو في النهاية مرتبط بعملية إصلاح ديني لم تحدث في بقية الديانات، والحقيقة أن هذا الإصلاح كان دافعًا لخروج الاقتصاد من التوظيف الديني التقليدي إلى قيم الحرية والعقلانية والمبادرة.
والعالم العربي لم يشهد إصلاحًا دينيًّا عميقًا، فقط كانت هناك محاولات لتحريك الإسلام في بعده الوظيفي السياسي، فنشأ الإسلام الحركي السطحي على قبور المصلحين الكبار، وأفشلوا مشروعاتهم في تجديد الخطاب الديني. وهذه المجتمعات العربية سواء زمن الاحتلال أو تأسيس الدولة الوطنية كانت عاجزة على تجذير علاقات اقتصادية لا تخضع للتبعية، فتكاسلت وراحت تبحث عن نماذج اقتصادية اشتراكية ورأسمالية مشوهة.
لا علاقة بين الدين والاقتصاد
أيمن رفعت المحجوب – أكاديمي مصري
على الاقتصاديين الذين يشكلون النظام الاقتصادي الإسلامي أن يتذكروا أن مبادئ الإسلام تتفق مع العقل وتحرص على خير المجتمع، وأن يتصف هذا النظام بالمرونة الكافية لكي يتلاءم ويتعايش مع الظروف العالمية المحيطة والعولمة، والترابط الشديد في المعاملات التجارية والمالية مع الآخر، شريطة ألا يعارض ذلك نصًّا إسلاميًّا. وإذا راجعنا تاريخ النظام الاقتصادي الإسلامي نجد أنه قد مر بتطورات كثيرة استجابة للضرورات، وأذكر منها التطورات التي مرت بالضرائب، وبخاصة في عهد خلافة عمر بن الخطاب، فقد أعاد تنظيم الضرائب، كما استحدث ضرائب أخرى لم يأتِ بها نص القرآن أو السنة، من بينها ضريبة العشور على أموال التجارة المتنقلة بين أقاليم الدولة الإسلامية.
نظام اقتصادي مرن
وهذه التعديلات التي أدخلت تؤكد أن نظام الاقتصاد الإسلامي ليس نظامًا جامدًا (كما يتصور بعض) بل نظام مرن؛ يستجيب للضرورات، وأن المبادئ والقيم الإسلامية لم تكن حائلًا دون ذلك، وأن هذه التطورات كانت في مصلحة المجتمع، ويجب أن تظل هكذا حتى آخر الزمان؛ لتحقق مصلحة المجتمع والأفراد، واحترام حقوق الدولة. فقراءة التاريخ واجبة إن أردنا أن نكون دولة حديثة متقدمة. والحق أنه ليس هناك اقتصاد إسلامي وآخر مسيحي، مثلما أنه ليس هناك طب إسلامي وطب مسيحي، فالعلم علم. وأقصى ما يمكن قوله: إن هناك دراسات اقتصادية في النظام الإسلامي.
هوامش:

بواسطة الفيصل | يناير 1, 2024 | الملف
يكاد الدكتور سعد البازعي، الناقد والمفكر والمترجم والأكاديمي والناشط الثقافي، أن يتحول إلى ظاهرة ثقافية غير مسبوقة. فهو يمارس أدوارًا عديدة في وقت واحد، أدوارًا صعبة وشاقة، وكل دور يحتاج إلى الانقطاع لوقت يطول. ومع ذلك استطاع بقدرة لافتة أن يمارس هذه الأدوار كلها مجتمعة، سعيًا إلى إنتاج معرفة ريادية متشابكة، وإلى أن يمارس دورًا مركزيًّا سواء فيما مضى أو في اللحظة الراهنة، حيث تعيش السعودية تحولات ثقافية واجتماعية، ما برحت تلفت أنظار العالم.
يمارس البازعي النقد ويخوض في مجالات الفكر النقدي ويترجم، ما يروق له وما يلبي في الوقت نفسه حاجة معرفية ملحة، من كتب ومقالات مهمة، ويقوم بمسؤولياته أستاذًا جامعيًّا غير متفرغ، كما يدير حلقة نقدية وملتقى ثقافيًّا بانتظام، يناقش فيهما موضوعات وقضايا ثقافية وفكرية مهمة، إضافة إلى كونه كان ولا يزال عضوًا فاعلًا في مجلس إدارة أكثر من هيئة وجهة ثقافية وشوروية. وقد استطاع، بصورة تسترعي الانتباه، تلمس وحدة عضوية تشد هذه الانشغالات، بعضها بعضًا، في نسيج واحد ومتماسك.
يواصل البازعي إعطاء حياته معنى عميقًا، من خلال أداء هذه المهام والوظائف، التي لا يشعر أنها وظائف، في المعنى الضيق للكلمة، بقدر ما تحولت إلى نشاط يومي يتحقق وجوديًّا من خلاله كطاقة إبداعية خلاقة، لا تكف عن الإنتاج والبحث وإثارة الأسئلة. يتمرد البازعي باستمرار على شرط المفكر، المنقطع لمشروع واحد، على شرط الناقد المتخصص في حقل أدبي وحيد، على شرط الأكاديمي المنغلق على نفسه في قاعة التدريس. قدم البازعي دراسات مهمة في الرواية وخطابها، في الشعر وقضاياه. أنجز أيضًا مقاربات جيدة في السينما. طبعًا، عدا انشغالاته الفكرية العميقة التي عبرت عن نفسها من خلال عدد من الكتب التي تحولت إلى علامات في مشواره الطويل، وعلى صعيد الممارسة النقدية والثقافية في العالم العربي.
كان البازعي سباقًا بالدفاع عن الحداثة الأدبية، والاحتفاء بالاشتغالات الجديدة، سواء في كتبه أو في ملتقاه الثقافي، الذي تنقل بين أماكن عديدة. احتفى البازعي بقصيدة النثر، مثلًا، والدفاع عن حقها وحق شعرائها في الوجود، واستطاع أن يقدم إسهامًا نقديًّا في المستوى نفسه، من الجدة والجدية، اللتين ميزتا بعض نماذج هذه القصيدة. دافع عن هذه القصيدة أمام من سبق له أن نافح عنهم من شعراء قصيدة التفعيلة، عندما كان هؤلاء في مرمى الاتهامات.
يفعل كل ذلك، من دون أن يقدم نفسه بطلًا أسطوريًّا، أو مناضلًا لا يشق له غبار ضد السائد وثقافة القطيع، يفعل كل ذلك بلا لافتات أيديولوجية، أو تعمد المواجهة، من أجل المواجهة، وليس من أجل المعرفة. إنما هو يفعل كل ذلك بشغف فريد واهتمام منقطع النظير ونشاط لا يعرف الفتور، وجل تفكيره الإصغاء إلى أصوات الحاضر، ودفع المعرفة بأنواعها إلى وجهات جديدة. في اشتغالاته النقدية والفكرية يعمد إلى لغة تنأى بنفسها، منذ وقت مبكر، عن اللغة المدرسية الجافة، باصطلاحاتها ومفاهيمها، التي يعرفها جيدًا بحكم تخصصه الأكاديمي، لغة استوعبت المنهج وخرجت عليه، كي تخاطب شريحة واسعة من القراء، دون أن تسقط في الاستسهال.
في مناسبة احتفاء الكويت بالدكتور سعد البازعي، وتكريمه بإعلانه شخصية العام الثقافية في معرض الكويت الدولي للكتاب، تنشر «الفيصل» ملفًّا عن صاحب «قلق المعرفة» و«استقبال الآخر» و«المكون اليهودي في الحضارة الغربية»، وسواها من كتب أساسية. يضم الملف شهادات لعدد من النقاد والشعراء والكتاب، تناولوا تجربة البازعي ومشواره الطويل، من زوايا مختلفة، مؤكدين تفرد مشروعه المتعدد، وأهمية جهوده في كل المجالات التي يواصل إنتاج معرفة جديدة فيها.
شخصية مُحلّقة في فضاءات الثقافة
سيف الرحبي – شاعر عماني
خيرًا فعلت إدارة معرض الكويت الدولي للكتاب في تكريم الدكتور سعد البازعي، هذا المثقف الناقد والأكاديمي النوعي، الذي أعطى الثقافةَ في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي بُعدَها العربي والإنساني الشامل والعميق. لقد تابعت الدكتور البازعي منذ بداياته وقرأت معظم إنجازات متنه الثقافي والنقدي، التي هي إضافة نوعية لإنجازات الثقافة العربية من محيطها إلى خليجها، حتى إن أحد كتبه التي هي محاضرات على طلبته في الجامعة، ثري وغني بالرؤى. وهذا الجيل الذي يتتلمذ على يد الدكتور البازعي وأمثاله سيكون جيلًا واعدًا ومثريًا للحياة المعرفية. حتى الكتب التي لا يعُدُّها هو ضمن سياق متنه الأساسي والمرجعي هي من الثراء بمكان، وهذا يدل على مسؤوليته الجدية والصارمة تجاه ما يطرح ويمارس ثقافيًّا وإبداعيًّا تجاه طلبته وفي كتبه المقروءة على نطاق واسع. وحسنًا فعلت إدارة المعرض في اختيارها لهذه الشخصية المحلّقة في فضاءات الثقافة الإنسانية الشاسعة.
متعة اللعب عند أقاصي الأدب والفكر

محمد المسعودي – ناقد مغربي
من يطلع على نتاج الناقد والمفكر السعودي والأستاذ الجامعي سعد البازعي يجد كتابته النقدية تتخذ لبوسًا فكريًّا فلسفيًّا واضحًا، فهو من النقاد العرب المعاصرين -المعدودين على أصابع اليد الواحدة- الذين تتميز كتابتهم بهذه القدرة على اللعب عند أقاصي الأدب بما يتطلبه الأدب من فهم وتحليل لكشف جمالياته، وإبراز خاصياته انطلاقًا من أجناسه الإبداعية المختلفة، وفي أفق ثقافي شامل؛ والجمع بين هذا البعد واللعب عند أقاصي الفكر وما يتطلبه من تأمل وتساؤل وبناء منطقي وقدرة على الكشف عن الحقائق الوجودية والرؤى الفكرية، والبرهنة العقلانية لإيصال وجهة نظر الباحث حول قضايا ثقافية وفكرية إنسانية راهنة.
ومن هنا، فإن قراءة كتب البازعي تلفت نظر المتلقي بجمعها بين الأدبي والفكري، وهي تتناول الشعر أو الرواية أو السينما أو جوانب من الثقافة الشعبية، أو وهو يخوض في قضايا تتصل بالفكر والثقافة عامة. وخير ما يمثل هذا المنحى في كتابته الآسرة ما خطه حول «المكون اليهودي في الحضارة الغربية» و«هجرة المفاهيم» و«قلق الهيمنة» و«قلق المعرفة» و«ثقافة الاختلاف».. وغيرها من القضايا الفكرية الأدبية التي خاض فيها، وكانت عناوين لأبرز كتبه.
إن المجال الذي اشتغل في سياقه الناقد والمفكر سعد البازعي متسع ومتشعب يبين عن معرفة واسعة بالأدب والفكر في العالمين الغربي والعربي المعاصرين، كما يكشف عن تمثل معرفي مكين للفلسفة الغربية الحديثة وما نتج عنها من مناهج نقدية أتاحت له إمكانات الخوض في الآداب المعاصرة في الجزيرة العربية وفي البلاد العربية الأخرى، وفي عمق الثقافة الغربية الحديثة؛ كما مكنته من تناول إشكالات تقع، كما أشرت آنفًا، عند الأقاصي العليا من الآداب والفكر معًا.
والمتابع لكتابات البازعي لا يجد عنتًا ولا مشقة في التفاعل مع كتابته وفهم أبعادها ومراميها، بحيث تتصف كتابته بالقدرة على إيصال رؤاه وتصوراته وتحليلاته العميقة والمهمة في صياغة أدبية مشرقة. وأنا كقارئ وباحث متابع للنقد العربي المعاصر، ومشتغل به في بعض مناحيه أجد لذة في قراءة كتب الدكتور سعد البازعي، هذا فضلًا عن الفائدة الكبيرة التي أجنيها من قراءة أعماله، وبخاصة ما تناولت فني الرواية والشعر، أو ما أثارت قضايا تتصل بالنقد الأدبي وتياراته المتنوعة والمختلفة، وما يتصل بالدراسات الثقافية في مجالاتها المتعددة وانشغالاتها الواسعة التي تتقاطع فيها حقول معرفية وعلوم إنسانية عدة. ولا شك أن موسوعية الناقد والمفكر سعد البازعي تجعل انتقاله بين هذه المعارف والعلوم الإنسانية سلسة طيعة، كما تجعل تفاعل القارئ معها تفاعلًا سلسًا يسيرًا، ولكنه مع ذلك يتطلب من هذا القارئ مقدرة وكفاءة قرائية تمكنه من اقتفاء آراء الكاتب ورؤاه، وفهم مقاصده الظاهرة والخفية، وهي مقاصد تنتصر للعمق الفكري والترفع عن الاستسهال والضحالة التي صارت عملة رائجة في الكتابة النقدية والفكرية في كثير من بقاع وطننا العربي.
ومما لا شك فيه أن الاحتفاء بتجربة البازعي هو احتفاء بالقيمة الفكرية والإبداعية التي تتطلع إلى اللعب عند أقاصي المتعة الفكرية والأدبية؛ متعة تشرب الأدب المسكون بالفلسفة، وبالروح القلقة المتسائلة دومًا عن كل مناحي الحياة، الروح المسكونة بقلق المعرفة التي هي ضالة كل مبدع حقيقي في هذا الوجود.
البازعي.. المنارة التي نصعد إليها لكي نرى!

عادل الزهراني – أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز
في جدة كنا، وكان سعد البازعي قد نشر للتو كتابه «استقبال الآخر»، وكنت أنتظره بتوجس، وتحفز، يذكرني كثيرًا بتحفّز حسين البيشي في مواجهة ماجد، هل تذكرونهما؟ المهم أني قرأت «استقبال» البازعي، وصدمني، كما قرأت من قبل «ثقافة الصحراء» و«المكون اليهودي» وأعمالًا أخرى. لم يكن سعد البازعي ممن يمرون مرورًا سريعًا، ولذلك كان انتظاري له انتظار لهفة، وعناد. في المحاضرة ليلتها في أدبي جدة، خلت أني سمعت من البازعي ما أعرفه، وما حملته كتبه. وعندما حانت مداخلتي، هجمتُ -هجمة مرتدة مثل هجمة البيشي في نهائي كأس الملك- بالأسئلة والملحوظات. المفاجأة كانت في رد البازعي. الدرس كان في رد البازعي. حين أخذني بحلمه، وسمته، ومنطقه العقلاني المتزن يناقشني في نقاطي نقطةً نقطة، وورق التوت يسّاقط عن اندفاعي ورقةً ورقة. تعلمت درسًا منهجيًّا سيظل معي حتى اليوم، وأنا أعد نفسي صديقًا وقريبًا من سعد، وكتبِ سعد.
في بريطانيا، وصلتني نسخة من «قلق المعرفة»، وكانت نسخة مثل صفعة إيقاظ؛ بناء الكتاب كاملًا على منهجية القلق نقطةٌ سلبتني، وجعلتني أعيد التفكير في كثير من قناعاتي. هذا الهاجس القلِق هو القوة الحقيقية المحركة للمعرفة والاكتشاف، هي الروح التي لخصها شوبنهاور في «إرادة الحياة»؛ لذلك لم أستطع منع نفسي من مراسلته، مسلّمًا ومناقشًا ومشاكسًا. قلت:
 «دكتور سعد. أشعر نحوك بامتنان متواصل لا ينقطع، لعلك تعلم السبب، ولعلك لا تعلم. أنا تلميذك عادل خميس، سبق لي أن تشرفت بلقائك مرات عدة.. في جدة والرياض وغيرهما. منذ زمن بعيد وأنا أستنير برؤاك الثاقبة، أنا متابع دقيق لقلمك، وأشعر وأنا اقرأ كتابًا لك أني بين يدي أفلاطوني الخاص.. إن كنت تؤمن أن لكل شخصٍ أفلاطونًا على مقاسه. وإن كنت تعتقد أن هذا غزلٌ صريح. فأنت على حق: هو كذلك. للتو انتهيت من كتابك القلِق: «قلق المعرفة»، طلبته من أحد الإخوة، فأوصله لي، والتهمته في يومين، ثم عدتُ لـ(أعرمشه) على روقان. واليوم إذ أنتهي من العرمشة، أكتب لك لأقدم شكرًا جزيلًا بحجم قامتك، وحجم تقديري. أخذتني فكرة القلق الذي بُني عليه الكتاب، تحضّـر القارئَ ليظل حبيس شعرة معاوية وهو يشق صفوف أفكارك بين مُشكـكٍ ومتسائل، حالة التوتر التي تحرص عليها مهمة جدًّا -في رأيي- ليصل قارئك لمرادك، قارئك أنت بالذات؛ الإثنية والفكر، وعلاقتهما المشبوهة: ماهية الفلسفة طُعمًا، وهْمُ الموضوعية المقدس الذي أسقطه المسيري رحمه الله، أشياء كثيرة.. كثيرة.. أخذتني أخذًا في كتابك، وكتبك السابقة. وغيرتي على قلمك جعلتني لا أرتاح للمقالات الصغيرة التي ضمنتها الكتاب، على رغم اتفاقها في الخط العام، لكنها تتحدث عن نقاط كبيرة وحساسة. وتحتاج لجهد أكبر وتحليل أوسع؛ لتضمها دفتا كتاب قيم كهذا. أطلتُ عليك أستاذي، لكني حفي بك، وأشعر بشهية مفتوحة لنقاشك، والسماع منك، فسامحني».
«دكتور سعد. أشعر نحوك بامتنان متواصل لا ينقطع، لعلك تعلم السبب، ولعلك لا تعلم. أنا تلميذك عادل خميس، سبق لي أن تشرفت بلقائك مرات عدة.. في جدة والرياض وغيرهما. منذ زمن بعيد وأنا أستنير برؤاك الثاقبة، أنا متابع دقيق لقلمك، وأشعر وأنا اقرأ كتابًا لك أني بين يدي أفلاطوني الخاص.. إن كنت تؤمن أن لكل شخصٍ أفلاطونًا على مقاسه. وإن كنت تعتقد أن هذا غزلٌ صريح. فأنت على حق: هو كذلك. للتو انتهيت من كتابك القلِق: «قلق المعرفة»، طلبته من أحد الإخوة، فأوصله لي، والتهمته في يومين، ثم عدتُ لـ(أعرمشه) على روقان. واليوم إذ أنتهي من العرمشة، أكتب لك لأقدم شكرًا جزيلًا بحجم قامتك، وحجم تقديري. أخذتني فكرة القلق الذي بُني عليه الكتاب، تحضّـر القارئَ ليظل حبيس شعرة معاوية وهو يشق صفوف أفكارك بين مُشكـكٍ ومتسائل، حالة التوتر التي تحرص عليها مهمة جدًّا -في رأيي- ليصل قارئك لمرادك، قارئك أنت بالذات؛ الإثنية والفكر، وعلاقتهما المشبوهة: ماهية الفلسفة طُعمًا، وهْمُ الموضوعية المقدس الذي أسقطه المسيري رحمه الله، أشياء كثيرة.. كثيرة.. أخذتني أخذًا في كتابك، وكتبك السابقة. وغيرتي على قلمك جعلتني لا أرتاح للمقالات الصغيرة التي ضمنتها الكتاب، على رغم اتفاقها في الخط العام، لكنها تتحدث عن نقاط كبيرة وحساسة. وتحتاج لجهد أكبر وتحليل أوسع؛ لتضمها دفتا كتاب قيم كهذا. أطلتُ عليك أستاذي، لكني حفي بك، وأشعر بشهية مفتوحة لنقاشك، والسماع منك، فسامحني».
كتبت هذه الرسالة قبل اثني عشر عامًا، ورد عليّ ناقدنا الملهم سريعًا، يناقش بهدوء، ويوجه بتواضع، ويسأل.. يسأل عن عملي في الدكتوراه، وما أنجزت منه. في هذه الأثناء واصل البازعي رحلته الفكرية بألق يبعث على الغبطة.
واليوم، يختار معرض الكويت سعد البازعي شخصيته الرئيسة، هذا بعض ما يستحق. تختار الكويت منارة عربية، لطالما أدمنّا صعودها، لكي نتنفس أكثر، ونرى أبعد.. أبعد بكثير مما يمكن أن نرى.
هكذا تورد الإبل يا سعد!
يعرف كيف يجد مورد الماء للعطش العربي
قاسم حداد – شاعر بحريني
فمن كتب عن الكتابة في صحراء العرب. يعرف العرب والصحراء معًا، ويدرك الماء لهما.
* * *
أعتبرُ الناقد ضربًا من قارئ يتميز بموهبة الكتابة. كتابة الرأي النقدي والتقدير الأدبي. وأعتبر سعد البازعي من بين أهم النقاد العرب الذين يقرؤون لما يجعل كتابتهم ضربًا من الحوار، حوار بين القارئ والنص. وكم نحن بحاجة لشتى أنواع الحوار في حياتنا.
* * *
أما عندما يترجم سعد البازعي فهو يترجم ما يحب للقارئ أن يفهمه ويتفهمه. أراه كما الصديق أمين صالح مترجمًا ما يحب.
* * *
أشكر معرض كتاب الكويت لاختياره سعد البازعي شخصية المعرض لهذا العام، ففي هذا الاختيار تكريم مضاعف للكتاب والكتابة، ليس في السعودية فقط، ولكنه تكريم لنا جميعًا في هذه النواحي من العالم.
* * *
سيجد القارئ في كتابة سعد البازعي الدليل الأكيد على أن كاتبًا مثل سعد، يعرف كيف يجد مورد الماء للعطش العربي في هذه الصحراء.
المثقف المدهش

صالح المحمود – أكاديمي سعودي ورئيس النادي الأدبي بالرياض
حين يُذكر اسم الدكتور سعد البازعي فإن سياق الحديث يبدو في حيرة من أمره؛ إذ تتعدد سياقات حضور هذا الرجل بشكل مدهش وعميق، فهو المثقف، وهو الناقد، وهو المؤلف، وهو المترجم، وهو الناشط في المشهدين الثقافي والنقدي، سواء في وطنه السعودية أم في وطنه العربي الكبير طيلة عقود مضت. فهذا الرجل يعد علامة بارزة ومضيئة في السياق الثقافي العربي، تشهد له بذلك إسهاماته المعرفية المدهشة، ومواصلته العمل كتابةً ونشاطًا ومبادرةً وإنجازًا دون توقف، في حين توقف كثير من مجايليه وتلاشوا من المشهد، ولا يبدو هذا الحضور الطاغي للبازعي غريبًا؛ فالرجل شغوف بالمعرفة، يتنفس الكتابة والقراءة، ويجدد طاقاته المعرفية دومًا دون أن يكلّ أو يملّ، ولديه التزام أخلاقي مع المعرفة لا يحيد عنه، كما أنه مملوء متخم بالاحترام، احترام العلم، واحترام الآخر المثقف، واحترام منجزات الآخرين المعرفية، وهذه الصفات نصّبته رمزًا من رموز المعرفة العربية، وأيقونة من أيقونات النقد الأدبي العربي، وسيظل كذلك.
لقد أسهم هذا الرجل في صناعة مشهد ثقافي في وطننا ينمو ويتكامل من خلال مسيرة معرفية طويلة، أنفق فيها الكثير من الجهد والوقت والحرص والعناية والمتابعة والإخلاص، مؤمنًا بأن الثقافة فعل إنساني نبيل، وأن الوطن يستحق من أبنائه وبناته المبادرة والعمل الجاد المخلص الذي تتوارى فيه الشخصيات الذاتية، ويلمع فيه اسم الوطن بأطيافه ومؤسساته ومبدعيه، هكذا كان البازعي منذ أن شارك بشكل فاعل في تأسيس المشهد النقدي السعودي في الثمانينيات الميلادية وما بعدها، واستمر بعدها صائغًا ماهرًا وفنانًا مبدعًا يعيد بالمعرفة وبالنشاط العلمي والثقافي كتابة ذلك المشهد، ويجدد فيه سنة تلو سنة بمنجزات معرفية هائلة يقدمها بشكل لافت ومستمر إلى يومنا هذا ولم يزل. ولهذا لم يكن أمرًا غريبًا أو مفاجئًا أن ينال الدكتور البازعي جائزة السلطان قابوس أو أن يكون شخصية العام الثقافية في معرض الكويت الدولي للكتاب، أو أن ينال تكريمًا في هذا المحفل أو ذاك؛ ذلك لأن الرجل ظل ملتزمًا بميثاقه مع المعرفة إنجازًا وحضورًا وتأليفًا وتوهجًا وتفاعلًا منذ الثمانينيات الميلادية حتى يومنا هذا وما زال حفيًّا بكل هذا، تتجدد طاقته، ويأبى أن يتوقف عن القراءة والكتابة والحضور الثقافي المبهر، منذ «ثقافة الصحراء» و«إحالات الكتابة» ومرورًا بعدد كبير وعميق من المؤلفات، وحشد ضخم من المشاركة والحضور النوعي في الفعاليات الثقافية المختلفة.
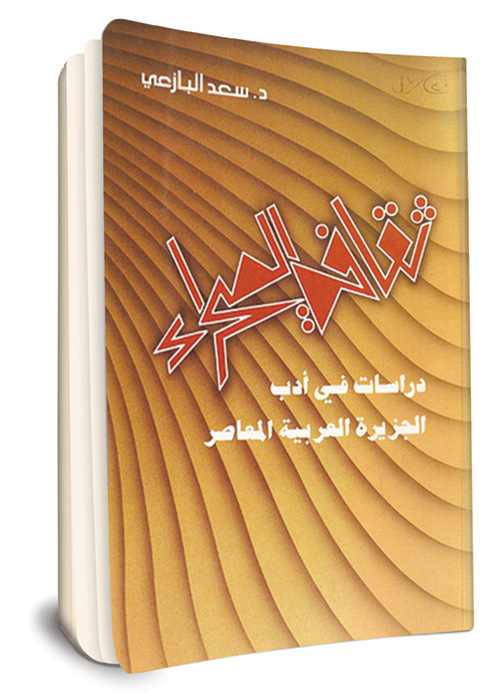 وحين يريد امرؤ ما أن يكتب عن البازعي مثقفًا وناقدًا ومؤلفًا ومترجمًا وناشطًا في حقول المعرفة فلن يقدم في الغالب معلومات جديدة؛ لأن الذين كتبوا ويكتبون عنه كثيرون، وهم يتجددون بتجدد منجزات هذا الرجل التي لا تتوقف، وستتقاطع الكتابات عنه في هذه السياقات مع بعضها. واللافت أن تلك الكتابات تتأسس في حقيقتها على مرتكز رئيس وعميق، بيد أنه يبدو غائبًا ومتواريًا لم يقبض على جمرته أحد ممن كتب عن البازعي، واستهدف شخصيته العلمية ومنجزاته المعرفية. والحديث هنا عن الشخصية الإنسانية لهذا الرجل، وهي شخصية غنية جدًّا؛ إذ يتدفق الحس الإنساني منها بشكل مدهش، ويبدو ذلك ظاهرًا في التعامل مع الآخرين، واحترام حضورهم ومنجزاتهم وتقديرها دون أن يكون ذلك سببًا للتنازل عن الجودة والعمق المعرفي، ودون أن يفضي به ذلك إلى المصانعة والمجاملة الممجوجة.
وحين يريد امرؤ ما أن يكتب عن البازعي مثقفًا وناقدًا ومؤلفًا ومترجمًا وناشطًا في حقول المعرفة فلن يقدم في الغالب معلومات جديدة؛ لأن الذين كتبوا ويكتبون عنه كثيرون، وهم يتجددون بتجدد منجزات هذا الرجل التي لا تتوقف، وستتقاطع الكتابات عنه في هذه السياقات مع بعضها. واللافت أن تلك الكتابات تتأسس في حقيقتها على مرتكز رئيس وعميق، بيد أنه يبدو غائبًا ومتواريًا لم يقبض على جمرته أحد ممن كتب عن البازعي، واستهدف شخصيته العلمية ومنجزاته المعرفية. والحديث هنا عن الشخصية الإنسانية لهذا الرجل، وهي شخصية غنية جدًّا؛ إذ يتدفق الحس الإنساني منها بشكل مدهش، ويبدو ذلك ظاهرًا في التعامل مع الآخرين، واحترام حضورهم ومنجزاتهم وتقديرها دون أن يكون ذلك سببًا للتنازل عن الجودة والعمق المعرفي، ودون أن يفضي به ذلك إلى المصانعة والمجاملة الممجوجة.
ويتصل بهذا الأمر في شخصية البازعي احترامه العميق للطاقات الشبابية المثقفة التي تشق طريقها في رحلة المعرفة، وأراه في هذا السياق شخصية استثنائية نادرة لا يشابهها أحد، فهو يحتفي بالشباب، ويدعمهم، ويحفزهم، ويحرص على منحهم مساحات من الضوء والحضور، في الوقت الذي يحب غيره من (الكبار) أن يستأثروا بالضوء معوّلين على أسمائهم ومنجزاتهم، لكن البازعي الذي ظل وفيًّا للإنجاز العلمي حتى اللحظة يخالف قاعدة الضوء، ويحرص أن يمنحه للشباب المتلهف، وقد أنشأ مبادرات عديدة قبل رئاسته النادي الأدبي بالرياض وفي أثنائها وبعدها، وجعل تلك المبادرات فضاءً ثقافيًّا للشباب المتوثب إبداعًا ونقدًا. وأذكر من ذلك قبل رئاسته النادي مبادرة (الاثنينية) أيام الشيخ ابن إدريس، وكانت بإشراف الدكتور سعد، وفيها استضاف عددًا كبيرًا من الشباب المتوثب إبداعًا ونقدًا. وفي أثناء رئاسته النادي لا يمكن أن أنسى مبادرة (الحلقة الفلسفية) التي منحها ومنح شبابها دعمًا غير محدود حتى كبرت وأصبحت اليوم جمعية متخصصة على مستوى الوطن.
وبعد تركه النادي، ظل البازعي وفيًّا لشغفه المعرفي، وكانت مبادرته المتميزة (الملتقى الثقافي) إحدى أهم المبادرات الثقافية التي عرفها المشهد السعودي بانتظامها وطرافة موضوعاتها، وفي كل هذه المبادرات وفي غيرها كان البازعي يراهن دائمًا على الشباب، ويمنحهم الفرصة، ويستثمر شهرته وحضوره الواسع في صنع دعاية وإعلان لهم، وأندهشُ حين أراه مرارًا يقدّم هذا المبدع الشاب أو ذاك، ويتقاسم معه طاولة الإلقاء معرّفًا به، ومديرًا لمحاضرته أو أمسيته، وقد جرت العادة أن تنعكس الصورة، فيكون المثقف الكبير صاحب الحضور والمحاضرة، ويكون مدير الجلسة شابًّا في بداياته، ولا يكتفي البازعي بذلك، بل يتجاوزه إلى دعم وحَفْز يبدأ به مقدمته، ويختم به الجلسة، ثم لا يفوته أن يشكر كل من يسهم في نجاح الفعاليات التي يشرف عليها، ويحرص على ألا ينسى أحدًا، ثم تراه في حسابه على مواقع التواصل يعيد الشكر والامتنان.
ويجدر بي في سياق المبادرات الثقافية أن أضيف مظهرًا تفرّد به البازعي دون سائر النقاد السعوديين -وربما العرب- وهو تلك الهمة والنشاط والشغف المعرفي الذي يقوده من مبادرة إلى مبادرة، فهو يؤسس المبادرة، ويحضر جميع فعالياتها، ويدعو المتحدثين، ويدير بعض الندوات، ويعلن عن الفعاليات في حساباته الخاصة، ويعلّق ويداخل في اللقاءات، ويدعم ويحفز المشاركين، وأين تجد اليوم مثقفًا مخضرمًا لديه هذه الهمة الوقّادة وهذا الشغف المعرفي؟ إنه أشبه بالتزام أخلاقي مع المعرفة يترجمه عمليًّا بتلك المبادرات ونشاطه المتجدد والمدهش فيها.
الفكرُ مُكرَّمًا

سهام العبودي – كاتبة سعودية
أتذكَّر على وجه اليقين المرَّة الأولى التي قرأت فيها للأستاذ الدكتور سعد البازعي. في مقتبل المساس بالنصوص وجدت في كتبه: «إحالات القصيدة» و«قراءات في الشعر المعاصر»، و«ثقافة الصحراء- دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصر»، القراءة التي ألهمتني الوعي بالنص عالمًا متعدِّد الأبعاد. ولطالما قلت في عقلي- آنذاك: أود أن أقترب من النص هذه المسافة الممكِّنة من رؤية رؤاه العميقة تحت سطح التشكيل، ومحاورةِ مجازاته المضمِرَة معانيَها تحت أجنحتها. القراءة الناقدة المختلفة هي معمار فنيٌّ خاصٌّ، ولها نصيبها من فعل الدهشة، ولا يمكن -قطعًا- أن تصل القراءة النقدية إلى هذا الحد من الإبداع والتأثير والإلهام لولا أن توفَّرت لمقدِّمها الأدوات، والإجادة اللازمة للتوفيق في استعمالها؛ وهو ما يؤول -في النهاية- إلى تعديد أبواب الدخول إلى النص، وتحقيق تحوُّلات في تصورات القارئ، ومنح النص حيواتٍ محتملة بفعل الحرث المستمرِّ في أرضه الخصبة.
إن المقدار الذي تضيفه هذه القراءة المنتجة في العقل القارئ هو الفعل الخالد الذي نسمِّيه (الأثر)، وما زالت عطاءات الدكتور سعد الفكرية تصنع أثرها المختلف البين في قرائه ومستمعيه ومتابعيه؛ مشكِّلًا وجودًا ثقافيًّا فكريًّا ملهمًا ومستحقًّا للإشادة والتكريم.
في المسافة بين «ثقافة الصحراء» تأليفًا حتى «بومغارتنر» و«الشعب الدَّمويِّ» ترجمةً، وفي كمٍّ يصعب إحصاؤه من المقالات والمحاضرات واللقاءات، وإدارة المشروعات الثقافية والملتقيات، والحضور الحيِّ في وسائل التواصل على اختلافها؛ في هذا كله تتحقق صورة شخصية المفكر بمقاربتها الشاملة المتوازنة لمجالات مختلفة تُشكِّل في مجموعها المعطياتِ اللازمةَ لصنع المعرفة وتقديمها، ولقراءة الحالة الثقافية وتشريحها، ولفهم الواقع وإشكالاته، ورصد تحوُّلاته. يؤمن الأستاذ الدكتور سعد البازعي بالزخم المضاعف الذي يحققه اتصال العلوم والفنون، وفتح مسارات تقود إلى اشتراك بانٍ بين الأدب والتاريخ والفلسفة والموسيقا وسواها من حقول المعرفة الإنسانية. نقاطُ الالتقاء تلك هي منافذ استكشاف لممكن مستجدٍّ، ومحتملٍ ولَّاد؛ وهي أيضًا مقاربة لحقيقة الإنسان الفرد المتعدد، المتجدد، ولمرايا وعيه المختلفة الانعكاسات.
تشكِّل الترجمة جزءًا مهمًّا في مشروع الأستاذ الدكتور سعد البازعي الفكري، وأتذكَّر شهودي حديثًا له بعنوان «معابر القراءة»، وهو حديث في موضوعَي (النقد والترجمة)، وتستوقفني من هذا الحديث -ضِمنَ الكثير الذي استوقفني- جملةٌ يشير فيها إلى: «أن اختيار كتاب من على رفٍّ هو فعل نقدي، وأن إعادته -انصرافًا عنه دون قراءته- هو فعل نقدي أيضًا». فلا شك إذن أن اختيار مدونة للترجمة هي «فعل نقدي» هائل متعدد الأبعاد؛ إذ تتحقق بالترجمة جملة مدخلات متنوعة من ثقافة إلى أخرى، مدخلات قد تكون محوِّلة بعيدة التأثير، وفي تاريخ العلوم والآداب أمثلة كثيرة لمدخلات معرفية وثقافية مؤثِّرة تحققت بفعل الترجمة. وفي مقدمة كتابه «معالم الحداثة» يشير الدكتور سعد البازعي إلى جوهرية هذا الفعل، واقتضائه عمليتي بحث واختيار عميقتين؛ فيقول: «فالانتخاب بحد ذاته فعل أو تدخل فكري وثقافي بقدر ما هو شخصي ذوقي. إنه تدخل في حراك الثقافة والفكر من خلال الانتقاء من حيث هو استدعاء للمختلف من زاوية مختلفة أيضًا،
وإنْ في بعض وجوهها». («معالم الحداثة، الحداثة الغربيَّة في ستين نصًّا تأسيسيًّا»، اختيار وترجمة وتقديم: سعد البازعي، مجموعة كلمات، الشارقة، ط1، 2022م. ص23 ).
وفي المقابل يملك الدكتور سعد حِسًّا عاليًا بالمسؤولية تُجاه (اللغة العربية)، وهو في مواقف كثيرة مسجَّلة ومتداولة يرفض استبدال لغة أخرى باللغة العربية دون مسوغ مقبول، ويرى الإنجليزية -وهو العارف بها والمترجم عنها- لغةَ آخَر، وحاملة ثقافة آخر، ولا ينبغي أن تحل لغة تواصل أو إعلام أو إعلان في أرض عربية. هذا الاتجاه التأصيلي الباني هو المعوَّل عليه لرسم معالم ثقافة محلية أصيلة، ترسِّخ هُويَّتها صورةً ولغةً وإبداعًا، وتفتح -في الوقت عينه- ذراعي قبولها للآخر، القبولِ الواعي بمواضع ضرورته ونفعه، وبكونِه آخَر لا ينبغي أن يزيح ما هو متجذِّر وأصيل.
جاء اختيارُ الأستاذ الدكتور سعد البازعي شخصية معرض الكويت الدولي للكتاب لهذا العام 2023م إضافةً مهمَّة إلى سجلات تقدير لمفكر واعٍ بمعالم مشروعه الفكري والثقافي والنقدي، ليست مرة أولى لكنها مؤكدة، وذات معنى في حق الصوت الثقافي السعودي المنتج المعتدل، المنتمي دون إقصاء، الأصيل دون انعزال، البالغ تأثيرًا متجاوزًا الحدود. إن تجربة فردية تحمل هذا التنوع والعمق والحضور والتجدد هي حالة ثقافية تستحق التقدير، وتستحق أن تكون موضع قراءة، أن تكون نموذجًا للوعي، لإحسان وفادة المعرفة عبر استثمارها، وتوظيفها لتحقق اندماجها المثالي المنتج، ونفعها الفكري العام. كل تكريم مستحقٍّ لمثقَّفٍ مفكِّر منتجٍ هو تكريمٌ للثقافة، وتقديرٌ للمعرفة، وإشادةٌ عالية الصوت بالفكر والذوق والجمال.
ثروةٌ فكرية حقيقية

نورة القحطاني – ناقدة وأكاديمية سعودية
الدكتور سعد البازعي يعد مثقفًا حقيقيًّا وثروة فكرية تمثل الثقافة السعودية في أفضل صورها، ومشاركاته العلمية والثقافية المتنوعة في المناسبات الثقافية والمؤتمرات العلمية قدمت الثقافة السعودية والأدب السعودي بصورة مشرقة إقليميًّا وعربيًّا، وعالميًّا أيضًا من خلال المحاضرات والترجمات لنصوص شعرية ونثرية ساهمت في خدمة المنتج الثقافي السعودي ونشره قدر الإمكان خارج حدوده المحلية. ومن أهم ما يتميز به الدكتور البازعي إضافة إلى العمق والأصالة تلك الاستمرارية والعمل الجاد الرصين في مجالات متنوعة، فلم يحصر نفسه في دائرة التخصص الضيقة بل خرج منها إلى أفق ثقافي فكري واسع يستمد عمقه من خلفية علمية متمكنة ومن اطلاع قرائي واسع وخبرة طويلة في التعامل مع النصوص، ومن تأمل مختلف في الثقافة العربية بدءًا من كتابه «ثقافة الصحراء» مرورًا بقراءاته العميقة للشعر المعاصر، والقصيدة الشعبية والرواية العربية، ولم يقف اهتمامه عند هذا بل قدّم للمكتبة العربية مجموعة فريدة من الكتب الفكرية التي تحمل طابعًا تأمليًّا فلسفيًّا ككتابته عن «المكون اليهودي في الحضارة الغربية» وعن «الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف» وعن «معالم الحداثة» و«هجرة المفاهيم»، وغيرها من الموضوعات الشائكة التي تدفع القارئ إلى التأمل والسؤال والبحث، وهو بهذا يضيف بالتأكيد للمكتبة العربية كثيرًا في جوانب ثقافية غير مألوفة تحفز الفكر وتثير الشك الذي هو طريق الوعي والبحث عن الأجوبة.
 ويحسب كذلك للدكتور البازعي تناوله للعلاقة المتوترة بين ثقافتين مختلفتين هما الثقافة العربية والثقافة الغربية، في مقارنة ترصد أوجه التشابه والاختلاف في طبيعة هذه العلاقة المأزومة وتمظهرات المواجهات بينهما. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في مؤلفاته ومحاضراته ذلك الحرص على استخدام اللغة العربية السليمة والأساليب الجيدة التي تؤكد اعتزازه بثقافته العربية ورفضه للألفاظ الأعجمية الدخيلة، وكم مرة قرأت له كتابًا أدهشتني فيه تلك القدرة الهائلة على السرد بأسلوب جاذب وسلاسة متماسكة على الرغم من ضخامة حجم العمل في أحيان كثيرة. ولا يمكن للقارئ أن يطوي غلاف أي من كتبه قبل أن يشيد بقيمته التي تكمن -من وجهة نظري- في الطابع الموسوعي الذي يقدم للقارئ نماذج مختلفة من الثقافة من جهة، وفي التحليل والمقارنة والربط بين هذه النماذج بشكل منطقي لافت للنظر من جهة أخرى.
ويحسب كذلك للدكتور البازعي تناوله للعلاقة المتوترة بين ثقافتين مختلفتين هما الثقافة العربية والثقافة الغربية، في مقارنة ترصد أوجه التشابه والاختلاف في طبيعة هذه العلاقة المأزومة وتمظهرات المواجهات بينهما. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في مؤلفاته ومحاضراته ذلك الحرص على استخدام اللغة العربية السليمة والأساليب الجيدة التي تؤكد اعتزازه بثقافته العربية ورفضه للألفاظ الأعجمية الدخيلة، وكم مرة قرأت له كتابًا أدهشتني فيه تلك القدرة الهائلة على السرد بأسلوب جاذب وسلاسة متماسكة على الرغم من ضخامة حجم العمل في أحيان كثيرة. ولا يمكن للقارئ أن يطوي غلاف أي من كتبه قبل أن يشيد بقيمته التي تكمن -من وجهة نظري- في الطابع الموسوعي الذي يقدم للقارئ نماذج مختلفة من الثقافة من جهة، وفي التحليل والمقارنة والربط بين هذه النماذج بشكل منطقي لافت للنظر من جهة أخرى.
نحن أمام نموذج لمثقف موسوعي لا يمكن أن نحصر إنجازاته في مؤلفاته فقط، إنما يجمع إلى جانب ذلك توليه لمهام عديدة في مجالات مختلفة سعى من خلالها إلى المساهمة في خدمة ثقافته ومجتمعه ووطنه، فرأس تحرير صحف، ومجلات، ورأس لجان تحكيم لجوائز دولية، وتولى رئاسة نادي الرياض الأدبي وكان أيضًا عضو مجلس شورى سابقًا. واستمر عطاؤه ممتدًّا من خلال تأسيسه لملتقى ثقافي نصف شهري تشرف عليه جمعية الثقافة والفنون قدّم من خلاله محاضرات وأمسيات وفتح باب الحوار حول موضوعات فكرية وثقافية واجتماعية وفنية مهمة، ودعا للمشاركة معه في هذا الملتقى أسماء ثقافية سعودية وعربية أضاءت بفكرها ومناهجها المتنوعة قضايا تشغل المشهد الثقافي العربي في الوقت الراهن. ذلك هو المفكر والناقد والمترجم البروفيسور سعد البازعي الواجهة المشرفة للثقافة العربية وسفير الثقافة السعودية الجادة التي مثّلها خير تمثيل في محافل دولية كثيرة.
البازعي ومسعى التأسيس
فخري صالح – ناقد ومترجم أردني من فلسطين
الصديق الدكتور سعد البازعي، هو بلا شك، واحد من النقاد العرب البارزين في اللحظة الراهنة، ومن الباحثين المنخرطين في شرح النظرية الثقافية المعاصرة، وتأويلها، والتعريف بها، والنظر في انعكاساتها، وطرق اشتغالها في النقد، والفكر، والحياة العربية المعاصرة. فهو، إلى جانب انشغاله بنقد الشعر والرواية والفكر النقدي في الثقافة العربية، أنجز عددًا من الترجمات المهمة التي تسلط الضوء على النقد والنظرية والفكر في العالم، وخصوصًا الجانب الغربي منه، ساعيًا، في العقد الأخير، إلى تقديم معالم الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر الغربي المعاصرة، وذلك من خلال الترجمة والاختيار، والبحث عن النصوص التأسيسية لهذه الحداثة. ولا شك أن هذا الاهتمام المنهجي، لرصد ما يمكن وصفه بأنه «العلامات الأساسية» لتطور الفكر والثقافة في العالم في القرن العشرين، أو أن «المكون الصلب» لحداثة القرن العشرين، يندرج في الكشف عما يؤثر في ثقافتنا وفكرنا العربي المعاصر، وما ينفعنا من هذا الفكر، وما يمكن لنا أن نستبقيه ونطوره في معرفتنا، في جزء من العالم يعاني مشكلات حداثة مأزومة، وتبحث لها عن طريق ثالث بين التراث والحداثة.
ينطوي مشروع البازعي، إذن، على مسعى التأسيس للنقد والنظرية والفكر، عبر الترجمة، والتعليق، وتقديم الآخر، للكشف عن هوية الذات في مرآة الآخر. وهو، انطلاقًا من تخصصه في الأدبين الإنجليزي والمقارن، يبحث عن نقاط التقاطع والافتراق بين ثقافتهم وثقافتنا، مشكلات حداثتهم ومشكلات حداثتنا المعوقة، التي ما فتئت تبحث لها عن طريق في مفترق العلاقة مع الذات ومع الآخر.
«الدكتور سعد» خارج الكتب
سماهر الضامن – ناقدة وأكاديمية سعودية
تلقيت في بدايات سنة 2019م بعد عودتي من ولاية آركنسا، دعوة من الأستاذ الدكتور سعد البازعي لأشارك في الحلقة النقدية التي كان قد أسسها قبل أعوام، وما زالت مستمرة حتى وقت كتابة هذه الأسطر. كان الدكتور قد حضر ندوة شاركت فيها مع لجنة الندوة العلمية في الجامعة، ولفت انتباهه الموضوع الذي طرحته فطلب مني عرضه في الحلقة. حين انتهيت من عرض الورقة علق بأنه أراد أن يستمع للأطروحة بشكل جيد، وبأنه طلب مني عرض الورقة نفسها في تلك الجلسة لأنها تمثل برأيه نموذجًا جيدًا لما يمكن أن تكون عليه المعالجة النقدية المنهجية لموضوع جديد، ونسبيًّا حساس. لفتني اهتمامه بأن يستمع للورقة بحرص، ويناقش محاورها مع مجموعة من الزملاء والزميلات، وينتبه للمنهج والأمثلة والتفاصيل والنتيجة. ولا يتردد في إبداء إعجابه بعمل باحثة مبتدئة ومغمورة، وهذا ما أسميه التواضع للعلم والشغف بالمعرفة، وبخاصة حين يأتي من باحث منجز ومنتج ومطلع وحاضر في المشهد الأكاديمي والثقافي محليًّا ودوليًّا. باحث تتلمذت على كتبه في مرحلة الماجستير وواصلت الاستفادة منها في مرحلة الدكتوراه، وما زلت وأنا أستاذة جامعية أنهل من إنتاجه ومساهماته المعرفية التي تصب في مشروعه الفكري والنقدي الأشمل حول المثاقفة والبحث في جذور المعرفة الإنسانية الحديثة والتبادل الحضاري بين الشرق والغرب، ضمن إطار فكري يقوم على فهم الخصوصيات الثقافية والسياقات الاجتماعية والتاريخية، وتتبع طرق تحولاتها واستخداماتها في سياقات متنوعة بتنوع الأزمنة والبيئات.
كان لقائي الأول بالدكتور سعد من خلال كتبه التي عبرت بي دروب المصطلحات والمناهج النقدية النظرية وأنا أعد رسالة الماجستير في النقد الأدبي الحديث، في وقت كانت تفتقر فيه المكتبة العربية إلى كتب ومداخل محكمة تقدم المصطلحات وتترجمها، وتضبط حدودها، وترسم خريطة تعالقاتها، وتؤصل لها؛ ضالة وجدتها في كتاب «دليل الناقد الأدبي» (إضاءة لأكثر من سبعين تيارًا ومصطلحًا نقديًّا معاصرًا) وهو تأليف مشترك بين الدكتور سعد والدكتور ميجان الرويلي؛ كتاب، كما يكشف عنوانه، مرجعي لا غنى عنه للباحثين في مجال الدراسات الأدبية والنقدية خاصة في مرحلة التأسيس والتعرف إلى المصطلحات والمفاهيم الكبرى في مجال النقد وما يتصل به من نظريات.
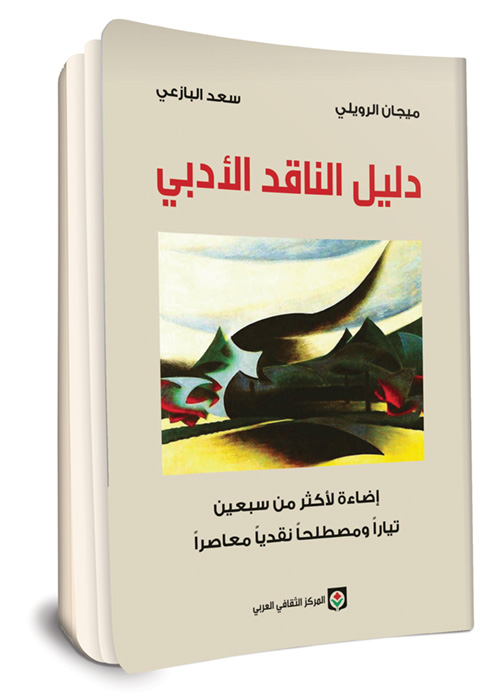 أما في مرحلة دراسة الأدب المقارن، فقد كان من ضمن عدتي المعرفية والمنهجية كتب مثل «استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث»، و«المكون اليهودي في الحضارة الغربية»، وغيرها من مؤلفات الدكتور سعد التي يسعى فيها لتحليل وفهم العلاقات والتأثيرات بين الأقطاب الفكرية العالمية واللاعبين المؤثرين في الحضارة المعاصرة من خلال إطار منهجي متسق ومتماسك يسعى لفحص المفاهيم الكبرى ورحلتها بين الثقافات وتشاكلاتها التاريخية والجغرافية، وهو ما تجلى أيضًا في كتابه «هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة» الذي ينطلق فيه من تلك القاعدة الفكرية نفسها. هذا عدا عن مؤلفاته النقدية التطبيقية، وترجماته لعدد كبير من الكتب التي يظهر في اختياراته لها أن الخريطة المعرفية التي يسير في طرقها واضحة لديه، وهو في رحلته المعرفية هذه يركز على الأصول والمنهج العلمي في البحث، ولا يغفل الاطلاع على الجديد من إنتاج أدبي وأجناس فنية تتسع لتشمل السينما والموسيقا والثقافة الشعبية وسواها.
أما في مرحلة دراسة الأدب المقارن، فقد كان من ضمن عدتي المعرفية والمنهجية كتب مثل «استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث»، و«المكون اليهودي في الحضارة الغربية»، وغيرها من مؤلفات الدكتور سعد التي يسعى فيها لتحليل وفهم العلاقات والتأثيرات بين الأقطاب الفكرية العالمية واللاعبين المؤثرين في الحضارة المعاصرة من خلال إطار منهجي متسق ومتماسك يسعى لفحص المفاهيم الكبرى ورحلتها بين الثقافات وتشاكلاتها التاريخية والجغرافية، وهو ما تجلى أيضًا في كتابه «هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة» الذي ينطلق فيه من تلك القاعدة الفكرية نفسها. هذا عدا عن مؤلفاته النقدية التطبيقية، وترجماته لعدد كبير من الكتب التي يظهر في اختياراته لها أن الخريطة المعرفية التي يسير في طرقها واضحة لديه، وهو في رحلته المعرفية هذه يركز على الأصول والمنهج العلمي في البحث، ولا يغفل الاطلاع على الجديد من إنتاج أدبي وأجناس فنية تتسع لتشمل السينما والموسيقا والثقافة الشعبية وسواها.
لا شك أن الوقوف على تفاصيل المنجز المعرفي للدكتور سعد البازعي يحتاج مساحة، ومقامًا مختلفًا عن هذا المقام. فأستاذنا يكرم هذه الأيام، تكريمًا مستحقًّا، في دولة الكويت كشخصية معرض الكتاب الدولي 2023م، وهذه فرصة لمزيد من البحث في نتاجه البحثي ومراجعة كتبه ومشروعه الفكري، وهو ما بدأت شرارته في السنوات الماضية حيث كان مشروع الدكتور ومؤلفاته حاضرة في عدد من الرسائل الأكاديمية في عدد من الدول العربية، وحيث ترجمت بعض كتبه لعدد من اللغات من بينها الصينية، ككتاب «ثقافة الصحراء: دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصر»، كما حضر كموضوع لعدد من الندوات والمحاضرات التي تناولت مشروعه كاملًا أو مجزأً. هذا فضلًا عن مساهماته الفعالة والمتواصلة بكل وسيلة يمكنه من خلالها مد الجسور واستكمال مشروعه الذي لم يتوقف عند البحث ورفوف المكتبات.
وهذا يعيدني للحديث عن الدكتور سعد كما عرفته خارج الكتب. كانت تلك الدعوة التي ذكرتها هي أول فرصة لي للتواصل معه، وأسميها هنا «فرصة» بوعي تام؛ لأن لقائي بالدكتور سعد كان فاتحة مباركة لي للعبور إلى المشهد الثقافي المحلي من وجهة مشرقة، بعد غيابي الطويل عنه في أثناء بعثتي الدراسية. وبالنظر للتوقيت، فقد كانت فرصة لم أتوقعها ولم أخطط لها في وقت كان العالم فيه يتحضر لاستقبال الزائر الثقيل الذي عزلنا عن المجالات العامة، فأغلق قاعات الدراسة، وأقفل المراكز الثقافية، وعطل قوائم المهام التي كانت على صفوف جداولنا. وكانت نقطة الضوء الوحيدة في وقتها هي تلك الحلقة النقدية التي جمع فيها الدكتور سعد مجموعة من الباحثين والباحثات الذين يتشاركون الاهتمامات ذاته.
كنا نتناقش حول بعض الخيارات البديلة لاستمرار الحلقة، فطرحت إحدى الزميلات فكرة اللقاءات الافتراضية، وهي الفكرة التي تحمس لها الدكتور سعد وشجع على تنفيذها بأسرع وقت. بدا أن الدكتور كان أكثرنا ضجرًا بسبب توقف الأنشطة واللقاءات الثقافية. كانت الحلقة تعقد كل أسبوعين فإذا به يقترح جلسة كل أسبوع. وجميعنا نعرف أن الحلقة ليست مجال نشاطه ومشاركاته الثقافية الوحيدة. خصصنا جلسات عدة للحديث عن الجائحة وأثرها في المشهد الثقافي وامتدادته محليًّا وعالميًّا، قرأنا فصولًا في أدب العزلة والمرض والكوارث البيولوجية. عرفت حينها جانبًا آخر من الدكتور سعد؛ وهو أنه بالإضافة لعمله المؤسسي والبحثي في الجامعة وخارجها بين تحكيم وتأليف وعضويات، كان مشروعه الفكري مرتبطًا بواقعه ومتحققًا في شخصيته وأولوياته واهتماماته؛ ممتدًّا من خلال مواكبته لكل جديد، ومساهماته في تأسيس وإدارة عدد من المشروعات الثقافية والمؤسسية كالملتقى الثقافي بالرياض والحلقة النقدية، وصولًا إلى مشاركاته في اللقاءات والمقابلات والجلسات الحوارية الثقافية التي قل أن يعتذر عنها إلا بها. وهو وسط هذا كله لا يتأخر عن استشارة أو مساعدة علمية أو مشاركة مع أي جهة مهما كانت جديدة وغير معروفة، وأتذكر استجابته المتكررة حتى لدعوات الشباب وطلاب البكالوريوس لإجراء المقابلات والحوارات الثقافية، فلا يبخل بوقته ولا يتأخر عن مواعيده.
والأهم من هذا وذاك، حرصه على أن يقدم للمشهد الثقافي والفكري، لا نتاجه الخاص فحسب، بل يقدم الوجوه الجديدة أيضًا، ويحثها على المشاركة، ويحرص على حضورها، وعلى الحضور لها، فهو يرى في تعدد الأصوات والأفكار في الساحة الفكرية، واستمرار الحوارات والنقاشات المعرفية وتبادل الرؤى معينًا تذبل الحياة الثقافية بدونه. جمعنا الهم الثقافي والبحثي منذ أكثر من ثلاث سنوات في مجلس إدارة الجمعية السعودية للأدب المقارن، ولا أجد من أستاذنا إلا الالتزام والدعم والامتنان لجهود الأعضاء الفاعلين، فضلًا عن الرؤية الثاقبة والتخطيط الثقافي بعيد المدى.
آخر مشاركة حضرتها للدكتور سعد كانت في مؤتمر النقد السينمائي في الرياض قبل أسابيع عدة، حيث تحدث عن تخطي حاجز الوهم بين الرواية والسينما. وقد كان لافتًا في حديثه المركز تحديد فكرته، ووضوح منهجه، كما كان لافتًا حرص الحضور على التفاعل معه، بدءًا بأساتذة الجامعات وانتهاء بالشباب المهتمين بالفكرة التي كان يطرحها. قابلت العديد من المفكرين والمثقفين والمؤلفين، قلة منهم أثروا في تكويني المعرفي، لكن أقلية من تلك القلة امتد تأثيرهم ليكون دروسًا في الحياة والانضباط والإخلاص لما يسرنا له، والدكتور سعد البازعي هو من هذه الأقلية التي لا يمكن لأثرها أن يتوقف بين صفحات الكتب.
مشروع ثقافي مستمر
ميساء الخواجا – ناقدة وأكاديمية سعودية
الأستاذ الدكتور سعد البازعي كاتب وناقد موسوعي متعدد المواهب والاهتمامات، ولعل هذا أحد مكامن الاختلاف والتفرد في تجربته التي تمتد بين النقد والترجمة والكتب الفكرية. إنه أحد مؤسسي الحداثة في المملكة العربية السعودية، وكان اهتمامه بالشعر السعودي المعاصر وقصيدة التفعيلة والنثر تحديدًا أحد مداخلي إلى التجربة السعودية في المملكة ولا سيما كتابيه «ثقافة الصحراء: دراسات في أدب الجزيرة المعاصر» و«إحالات القصيدة: قراءات في الشعر المعاصر». ولعل ما يلفت النظر في تعامله مع النص الأدبي هو الجمع بين السلاسة والعمق في قراءة القصيدة، وهو في ذلك يتعامل مع النظرية دون تصلب أو جمود، فتأتي القراءة كتابة على الكتابة ونصًّا جديدًا في الوقت نفسه. وأرى أن هذا الالتفات المبكر للقصيدة الحديثة في المملكة يحمل دورًا مؤسسًا ومركزيًّا ولا سيما في وقت نالت فيه القصيدة الحداثية ما نالته من هجوم حاد في حقبة السبعينيات والثمانينيات.
وقد استمر هذا الاهتمام بالقصيدة ومحاورة النص بهدوء الناقد العارف مما يحيل إلى مشروع نقدي متكامل يؤسس لتلك القصيدة كما سبقت الإشارة، ويلتفت أيضًا إلى التجارب الجديدة عند جيل الشباب ليضع تلك التجربة في إطارها من المشهد الإبداعي المحلي والعربي، وهو ما نجده في عدد من مؤلفاته المتأخرة مثل: «جدل التجديد: الشعر السعودي في نصف قرن» و«جدل الألفة والغرابة: قراءات في المشهد الشعري المعاصر» وغيرها. الإطار الثاني الذي يمكن الوقوف عنده هو تجربة كتاب «دليل الناقد الأدبي»، حيث صدر هذا الكتاب بالاشتراك مع الدكتور ميجان الرويلي ليشكل مرجعية مهمة لطلاب الأدب والنقد، ويقدم لهم تعريفًا بأهم المناهج والنظريات النقدية بموضوعية وعمق وبساطة في الوقت نفسه. وهذا مشروع تأسيسي أيضًا يفيد منه المتخصص والمبتدئ في مجال النقد الأدبي على حد سواء. وهو مرجع علمي رصين يبتعد من العمومية والسطحية ويتسم بالغنى والعمق.
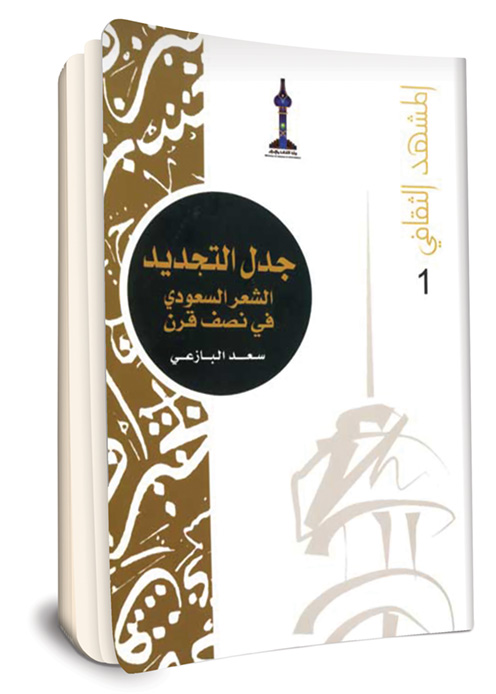 الحوار مع الآخر ومخاطبة فكره وثقافته نقدًا وتحليلًا وتفكيكًا لبعض مقولاته المهيمنة، جوانب لا يمكن إغفالها في تجربة البازعي. فإن كانت كتاباته النقدية تسائل القصيدة والإبداع في عمومه وتحاور النص شعرًا ونثرًا، فإن كتاباته الفكرية تثير تساؤلات فكرية مهمة جدًّا في المشهد المحلي والعربي والعالمي. ويبدو أن نقاش فكر الآخر والحفر فيه يعد محورًا رئيسًا في مشروع البازعي، وهو مشروع قديم ومتجدد، فالآخر يظل دومًا قضية حساسة ومهمة في أية ثقافة، منها تقارب وعيك بذاتك وثقافتك وفي الوقت نفسه تحاور وعي الآخر وثقافته. وبذلك استطاع البازعي مقاربة قضايا حساسة جدًّا في المشهد الثقافي العربي وحواره مع الآخر ولا سيما في «المكون اليهودي في الثقافة الغربية» الذي يسعى إلى إبراز الدور الذي لعبه اليهود في تاريخ الحضارة الغربية ابتداءً من القرن السابع عشر حتى اليوم. ويبرز الكتاب ضمن هذا الإطار التأثير المتعاظم لدور الجماعات اليهودية في مختلف مناطق أوربا وأميركا الشمالية على مستويات ثقافية مختلفة، متناولًا أعمال عدد من المفكرين والعلماء والمبدعين الذين تركوا أثرًا بالغًا في تطور الحضارة الغربية، وصار جزءًا من نسيجها في الوقت الذي عبرت أعمالهم عن أفكار جماعتهم ورؤاها وهموم وتطلعات الجماعات اليهودية التي ينتمون إليها، ومنهم مفكرون مثل: سبينوزا وماركس ودريدا، وشعراء مثل: هاينه وتسيلان، وروائيون مثل: دزرائيلي وروث، ونقاد مثل: هارولد بلوم، وعلماء مثل: فرويد.
الحوار مع الآخر ومخاطبة فكره وثقافته نقدًا وتحليلًا وتفكيكًا لبعض مقولاته المهيمنة، جوانب لا يمكن إغفالها في تجربة البازعي. فإن كانت كتاباته النقدية تسائل القصيدة والإبداع في عمومه وتحاور النص شعرًا ونثرًا، فإن كتاباته الفكرية تثير تساؤلات فكرية مهمة جدًّا في المشهد المحلي والعربي والعالمي. ويبدو أن نقاش فكر الآخر والحفر فيه يعد محورًا رئيسًا في مشروع البازعي، وهو مشروع قديم ومتجدد، فالآخر يظل دومًا قضية حساسة ومهمة في أية ثقافة، منها تقارب وعيك بذاتك وثقافتك وفي الوقت نفسه تحاور وعي الآخر وثقافته. وبذلك استطاع البازعي مقاربة قضايا حساسة جدًّا في المشهد الثقافي العربي وحواره مع الآخر ولا سيما في «المكون اليهودي في الثقافة الغربية» الذي يسعى إلى إبراز الدور الذي لعبه اليهود في تاريخ الحضارة الغربية ابتداءً من القرن السابع عشر حتى اليوم. ويبرز الكتاب ضمن هذا الإطار التأثير المتعاظم لدور الجماعات اليهودية في مختلف مناطق أوربا وأميركا الشمالية على مستويات ثقافية مختلفة، متناولًا أعمال عدد من المفكرين والعلماء والمبدعين الذين تركوا أثرًا بالغًا في تطور الحضارة الغربية، وصار جزءًا من نسيجها في الوقت الذي عبرت أعمالهم عن أفكار جماعتهم ورؤاها وهموم وتطلعات الجماعات اليهودية التي ينتمون إليها، ومنهم مفكرون مثل: سبينوزا وماركس ودريدا، وشعراء مثل: هاينه وتسيلان، وروائيون مثل: دزرائيلي وروث، ونقاد مثل: هارولد بلوم، وعلماء مثل: فرويد.
ومثل هذا الكتاب يضع يده على نقطة مهمة في تكوين ثقافة الآخر أولًا، وفي طبيعة الفكر الفلسفي وتكوين المناهج الفكرية عنده ثانيًا، فلا يغدو التعامل مع تلك الأفكار أو نقلها بصورة حرفية أمرًا من السهولة بمكان. هذا الحفر المعرفي والفكري الذي استمر مع «هموم العقل» و«مواجهات السلطة»، و«هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة» يؤكد الهم المعرفي الذي يحمله المؤلف، كما يؤكد عمق المعرفة وأن وعي الذات لا يمكن أن يكون منفصلًا عن الوعي بالآخر، وأن حصيلة هذين الوعيين هي ما تجعل الفرد قادرًا على المشاركة الحقيقية والفاعلة في الثقافة الإنسانية.
وهنا تأتي الترجمة شيئًا مكملًا لهذا الحفر المعرفي بكل ما فيها من حوار ضمني مع ثقافة الآخر وانفتاح على تجربته في الوقت نفسه. واختيار موضوعات الترجمة وعناوينها عند البازعي يؤكد تكامل التجربة وتنوعها في الوقت نفسه، المثقف المسؤول يحاور ويناقش الإبداع ويحمل رؤيته مشروعًا متكاملًا، ولا يقف عند المعرفة المتخصصة ورفوف المكتبات فقط، بل ينشر الثقافة ويفعل دور المثقفين عبر منابع متنوعة، وهو ما نراه عند البازعي الذي أسس الحلقة النقدية منبرًا تحاول فيه المثقفون والأدباء في قضايا متنوعة، وشارك المختصون وغير المختصين في حلقات نقاش ثرية، إضافة إلى النشر في الصحف والمشاركات المتنوعة في مَنَاحٍ مختلفة. كل ذلك يقول: إن الثقافة عنده ليست خطابًا عارضًا أو كتابة في قضية واحدة بل هي هم وجودي وفعل كينونة ومشروع مستمر قولًا وفعلًا، وهو ما يجعله شخصية ثقافية وفكرية بامتياز.
جسر للتواصل مع الآخر
محمود الضبع – ناقد مصري
يقال: إن شهادة الأصدقاء مجروحة، غير أن الأمر يختلف في حالة الدكتور سعد البازعي، فحين التقينا للمرة الأولى في جلسة بحثية في إحدى دورات الملتقى الدولي للرواية بالقاهرة، وكان يرأس الجلسة آنذاك الراحل الدكتور صلاح فضل، حينها لم يكن الدكتور البازعي غريبًا عني فكريًّا، وإن كنت أخاله قبلها طاعنًا في السن كما تدل عليه كتاباته.
كانت مؤلفاته وترجماته تسبقه في معرفتنا به شخصيًّا، وبخاصة: دليل الناقد الأدبي، وما فيه من عرض لتيارات ومصطلحات النقد الأدبي الحديث، وقد تكررت اللقاءات وفي كل مرة كان لدى الدكتور البازعي إنتاج جديد يمكننا التحدث حوله، لكن ما كان يلفت الانتباه أكثر لمشروعه النقدي هو أمران:
أولهما، توسيعه مفهوم النقد الأدبي ليتجاوز مجرد حدود النصوص الأدبية، ويصبح قراءة في الحياة والمنجز الفكري والثقافي والتطور الحضاري على نحو عام.
وثانيهما، اهتمامه بالآخر، وهو ما تجلى عبر كتب ومؤلفات ودراسات وأبحاث متعددة، منها: مقاربة الآخر (1999م)، واستقبال الآخر: النقد في النقد العربي الحديث (2004م)، والاختلاف الثقافي وثقافة الآخر (2008م)، وغيرها مما لم يتضمن عنوانه مباشرة مفردة الآخر، لكنه يعالج القضية بأشكال متعددة.
كانت تلك هي البداية فقط لجعله يحتل مكانته في عوالم الثقافة والأدب والنقد، وقد استمرت المسيرة لتكشف عن جهود مستمرة وإنتاج يستحق التقدير؛ إذ مما يمكن التوقف أمامه في كتابات الدكتور البازعي بعد ذلك هو رافد آخر له أهميته الراهنة، وهو وقوفه أمام تحولات الثقافة، وبخاصة في المرحلة الأخيرة المتزامنة مع فيروس كورونا- 19، وما يصاحبه من محاولات لقراءة واقع الحياة من حولنا، ودور الثقافة، وأهميتها، ومصير الأدب، وتحولاته، والبحث عن أبعاد الحياة الفلسفية، وعلى رأسها قضايا: المعنى والمفهوم ومحاولة لمّ شتات العالم من حولنا.
سعد البازعي… المفرد المتعدّد

مصلح النجار – ناقد وأكاديمي أردني
عرفت الدكتور سعد البازعيّ معرفتين: واحدةً في التسعينيات، حين اطّلع المثقفون العرب والمهتمّون بالأدب والنقد على موسوعته «دليل الناقد الأدبي» التي أعدّها مع ميجان الرويلي. والأخرى بعد ذلك بعقد من الزمن؛ إذ التقيته في محافل ثقافية عدة، وجمعتنا صداقة، أعتز بها أيما اعتزاز.
في التسعينيات، كانت الثقافة السعودية قد تعمدت تجاوز حدود المملكة، بشكل جماعي، لا على مستوى الأفراد فحسب، لتصل إلى القارئ العربي حيث هو، بعد مرحلة كان ممثلو هذه الثقافة في الخارج قليلين، ممن عاشوا أو درسوا في مصر، أو سوريا، أو ممن صادفناهم في بيروت، أو في زياراتنا إلى دول المغرب العربي العزيز. وكان عدد الأسماء محدودًا، وعلى وجه الخصوص في مجالي الحداثة وشعر الحداثة اللذين أهتم بهما.
ويمر الزمن، لألتقي البازعي في مؤتمر فكري مهتم بشؤون السياسة، ونحن وافدان إلى السياسة من عالم الأدب، والعمل الأكاديمي، ولعل ذلك النسغ الذي اسمه الأدب هو ما جمع النفوس، فوجدنا أنفسنا في الإسكندرية نأتلف في مجموعة من أصحاب الخلفيات الأدبية، وكنا مدعوين إلى مؤتمر تعقده مكتبة الإسكندرية حول الحريات في العالم العربي، وكان البازعي واسطة عقدنا.
ومنذ ذلك الحين ربطتني صداقة بالدكتور سعد، وتكررت لقاءاتنا، وتزاورنا، وما فتئ الرجل يكشف لي، كما يكشف للثقافة العربية، ذلك العمق، وتلك التجربة الثقافية الثرية، التي تأتت للرجل من دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، التي أتاحت له أن يقرأ الثقافة الغربية في مظانها الأصلية، وأن يعيش اللحظة الثقافية الغربية بُعيد منتصف سبعينيات القرن العشرين، ومطلع الثمانينيّات، ففهم بعين المراقب الحصيف، ما ينبغي للمثقف الشاب العربي أن يفهم، وكون حالة من التعاطي الأصيل مع الآخر، من موقف المثقف العصري، الذي يفتح صدره، وذراعيه لكل ما يمكن أن يتساوق ومكوناته الثقافية، من دون إقصاء، أو محددات مجتلبة إلى حقل الثقافة. وصار بجهد متواصل، ومؤلفات ثرة ضاربة العمق في الثقافات المقارنة والآداب التي تمثلها، علمًا من أعلام الفكر التي تجاوزت الجغرافيا السعودية والخليجية، لتحضر في الثقافة العربية خارج الخليج، إلى جانب رصيد ثقافي قدمه كل من الأمير الشاعر عبدالله الفيصل، وغازي القصيبي، وحمد الجاسر، وحسن عبدالله القرشي، وعبدالله الغذامي، وعبدالعزيز السبيل والتي يشير حضورها إلى حيوية الثقافة العربية في هذه المرحلة.
 انماز البازعي بشخصية بحثية متماسكة، ديدنها الاستقصاء، فنجده يتتبع تحولات المفاهيم خلال عملية تأصيلها، ليتوقف عند محطات مجهولة من المثاقفة الحضارية، أو من عملية التأثر والتأثير ليكشف عن المغالطات التاريخية أو المجهول في الثقافة الذي غيبته الرغبات الاستعمارية أو الأنظمة السياسية الحاكمة، أو حورته لصالح ما، كما يكشف عن الاختلافات التي يعيشها المفهوم نفسه بانتقاله إلى سياقات ثقافية جديدة. لم يركن البازعي إلى واحدية فكرية، بل عاش جملة من الازدواجيات الغنية، فكان بنفسه لحظة اتصال بين الثقافتين العربية والأميركية، كما كان بذاته قِرانا بين اللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك وقف على جسر واصل بين عالمي السياسة والأدب. ومن هذا وذاك، ومن تلك القِرانات، ومن فطنة السعودي الذي أحسن استثمار ما أُتيح له من فضاءات ثقافية، قرنها بجدية واضحة، ودأب لا يخفى على ذي بصر؛ صنع البازعي فضاءه المعرفي والثقافي.
انماز البازعي بشخصية بحثية متماسكة، ديدنها الاستقصاء، فنجده يتتبع تحولات المفاهيم خلال عملية تأصيلها، ليتوقف عند محطات مجهولة من المثاقفة الحضارية، أو من عملية التأثر والتأثير ليكشف عن المغالطات التاريخية أو المجهول في الثقافة الذي غيبته الرغبات الاستعمارية أو الأنظمة السياسية الحاكمة، أو حورته لصالح ما، كما يكشف عن الاختلافات التي يعيشها المفهوم نفسه بانتقاله إلى سياقات ثقافية جديدة. لم يركن البازعي إلى واحدية فكرية، بل عاش جملة من الازدواجيات الغنية، فكان بنفسه لحظة اتصال بين الثقافتين العربية والأميركية، كما كان بذاته قِرانا بين اللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك وقف على جسر واصل بين عالمي السياسة والأدب. ومن هذا وذاك، ومن تلك القِرانات، ومن فطنة السعودي الذي أحسن استثمار ما أُتيح له من فضاءات ثقافية، قرنها بجدية واضحة، ودأب لا يخفى على ذي بصر؛ صنع البازعي فضاءه المعرفي والثقافي.
ومن ذلك الدأب، أنتج البازعي مجموعة من الدراسات والكتب النفيسة في مجالات الدراسات الثقافية، منذ منتصف التسعينيات، أهمها: «إحالات القصيدة» 1998م، و«مقاربة الآخر» 1999م، و«استقبال الآخر» 2004م، و«أبواب القصيدة» 2004م، و«المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية» 2007م، وقدم للقارئ العربي الثقافة الغربية، والفكر والفلسفة الغربيين في موسوعته «معالم الحداثة»، ثم أهدى المكتبةَ العربية كتابه «هجرة المفاهيم» 2021م، وخرج علينا بسِفره النفيس «مواجهات السلطة» 2018م، مستعرضًا فيه فكرة الهيمنة عبر الثقافتين الغربية والعربية، بتصور كرونولوجيّ واعٍ، ومنطلِق من لحظة إحاطة وفهم عميقين.
وما زالت الثقافة العربية تنتظر من البازعي مزيدًا من النتاجات النوعية التي تضيف للثقافة العربية رصيدًا من الوعي الحضاري، وبعد النظر المجبول بعاملي الخبرة والفطنة.
النقد بما هو مسؤولية حضارية

محمد الحيرش – أكاديمي مغربي
ما من شك في أن ثراء المنجز الفكري والنقدي للدكتور سعد البازعي يضعنا من الوهلة الأولى أمام مطلب إيجاد المداخل المناسبة لرصد توجهاته واستقراء مداراته. إنه منجز واسع ومركَّب يستند إلى برنامج بحثي تتداخل فيه انشغالاتٌ متعددة، وتتشابك فيما بينها إلى الحد الذي يتعذر معه الفصلُ بين ما يعود منها إلى مجال الدراسات الأدبية والفلسفية، وبين ما يعود إلى مجال الدراسات الترجمية والثقافية.
غير أن النواة المعرفية الناظمة التي تتقاطع عندها هذه الانشغالات تستمد مشروعيتَها من الحوافز والإمكانات التي يتسع لها النقد ما بعد الكولونيالي؛ إذ يوظف البازعي هذا النقد في كتاباته، ويستثمر إستراتيجياته على نحو أخص في تقويض العلاقة التراتبية التي تقيمها الذاتُ الغربية مع الآخر، ووضعِ تمثلاتها الاستعلائية المتوارية في الآداب والثقافات موضعَ مساءلة وتفكير. وبذلك كانت طريقةُ تفاعله مع مرجعيات النقد ما بعد الكولونيالي لافتة؛ لأنه لم يشتغل به كما لو أنه عبارة عن أطروحة نقدية جاهزة يتعين الدفاعُ عنها والنضال من أجلها ضد أطروحات أخرى أقل وجاهة وكفاية، أو كما لو أنه عبارة عن نزعة «فكرية» ناجزة تغري بالاعتناق والتعميم. ما يلفت الانتباه حقًّا في عمل البازعي أن الحس النقدي تغلب على الحس النضالي؛ لذلك نجده يختار الاشتباك النقدي الهادئ مع أعمق النقاشات الدائرة في الفكر الكوني المعاصر بين أقطاب الدراسات اللاكولونيالية، وينخرط بوعي حضاري في محاورة وعودها النظرية، وفحصِ مرتكزاتها الفلسفية. وهو الأمر الذي مكَّنه من اتخاذ المسافة الإبيستيمولوجية الضرورية التي بقدر ما أتاحت له التعمُّقَ في طبيعة التحولات المعرفية الناجمة عن انتقال المفاهيم من تربة ثقافية إلى أخرى، سمحت له أيضًا بتهذيب هذه المفاهيم وتبيِئة تداولها في سياقاتنا العربية بصيغة منتِجةٍ وفعالة.
لا يتردد البازعي في القول بأن اهتمامه بالآداب الأجنبية وبنصوصها الكبرى لا يتوقف عند حدود الاستفادة منها أو مقارنتها بنصوص الآداب العربية؛ إنه اهتمام من أجل التعرف إلى الحضارة الغربية، وفهمِ جذورها بنحو تنجلي معه المنازعُ المركزية التي تستتر فيها، وتتكشَّف فيه مظاهرُ الهيمنة والاستعلاء الثقافي التي تتخفّى داخلها. ولذلك نجده يتوسل بجملة من المفهومات التي تساعده على ذلك كمفهوم الخطاب بالمعنى الذي أصَّله ميشيل فوكو، ومفهوم الآخر بالمعنى الذي طوره إدوارد سعيد.
ومن ثم فلئن جاز لنا في حدود هذا المقام إطلاق وصف جامع على منجز الأستاذ سعد البازعي، فإنه يمثل واحدًا من أبرز المنجزات الفكرية والنقدية العربية؛ إذ ما إنْ نبدأ في قراءته وتتبُّع الخيط الناظم لانشغالاته حتى تجذبنا رصانتُه، وتحملنا على الإصغاءِ الجيد إليه وتقديرِ انشغالاته واجتهاداته.
«كتب وإشكالات»
إستبرق أحمد – كاتبة كويتية
في فوضى إدراك الكنه الواضح لبعض المصطلحات النقدية في بدايات الكتابة الأدبية لدي، أشارت صديقة إلى كتاب يتتبع خلفية بعض المصطلحات النقدية ومفاهيمها. كان كتابًا لاحق بنسخته الأولى 30 مصطلحًا، وفي الثانية عالجت المزيد، واستقرت النسخة الأخيرة عام 2002م على 70 مصطلحًا، فكانت النصيحة تتناول هذه النسخة بالذات، التي أتت لتبعد صعوبة استيعاب بعض الكتب النقدية التي كنت أتعثر بها بموضوعاتها في ظل ازدحامها بلغة أكاديمية ثقيلة أو استعراضية في إحالاتها الدسمة. فكان كتاب «دليل الناقد الأدبي» المنقذ؛ حيث سلاسة الجملة وغناها بالمعلومات. إصدار مشترك واضح دأب الباحثين الدكتور ميجان الرويلي والدكتور سعد البازعي فيه. كتاب مساند لكل من يرغب في إضاءة أسئلته بإجابات ضافية تنحو إلى العلوم الإنسانية في تتبع المفهوم. كانت هذه اللحظة بداية تعرفي إلى اسم الدكتور سعد البازعي، أما تعرفي الآخر فكان عبر كتاب عن الحداثة لدكتور آخر عاصر البازعي وله علمه ورأيه هو الدكتور عبدالله الغذامي، وكلاهما نثق أنه قامة مشغولة بمشروعها، وإن اختلفت الطريقة والمسارات بين نقد أدبي وآخر ثقافي وكيفية معالجتهما لموضوعات مهمة، فيبقى الاحترام قائمًا لهما دون تقديس أحدهما.
 في كتب البازعي، الذي اختير شخصية معرض الكويت للكتاب الدولي، نرى أسباب اختياره؛ فهو شخصية دون شك متعددة المنجز له محاولاته الدؤوبة كناقد، مفكر ومترجم فاحص لأسئلته والاشتباك مع أسئلة وآراء أخرى ربما كانت مغايرة أو حتى على الضد معه. يظهر ذلك منعكسًا في خوضه مجالات مختلفة من مقاربة للنتاج الشعري والبيئة والسينما والرواية حتى أدب الجائحة وغير ذلك، حاملًا ميزة مهمة كونه مترجمًا يواكب الآخر في الدراسات الطازجة، منزويًا في مكتباته، مطلعًا، مزيحًا المكرس، الثابت، متجهًا ومترصدًا الجديد، ومحاولًا تقديم أطروحاته، فيما يدنو يعاين ويخاطر، كما نرى مثال ذلك كتابه «المكون اليهودي في الحضارة الغربية» الذي حلل ذلك المكون ومرجعيته وانفتاحه وتناميه كأقلية وتأثيره الكبير في المكون الغربي، متناولًا أسماء كانت إشكالية حتى في مجتمعاتها اليهودية، ومتعاونًا مع أسماء لها ثقلها منها عبدالوهاب المسيري مستخلصًا رأيه الخاص.
في كتب البازعي، الذي اختير شخصية معرض الكويت للكتاب الدولي، نرى أسباب اختياره؛ فهو شخصية دون شك متعددة المنجز له محاولاته الدؤوبة كناقد، مفكر ومترجم فاحص لأسئلته والاشتباك مع أسئلة وآراء أخرى ربما كانت مغايرة أو حتى على الضد معه. يظهر ذلك منعكسًا في خوضه مجالات مختلفة من مقاربة للنتاج الشعري والبيئة والسينما والرواية حتى أدب الجائحة وغير ذلك، حاملًا ميزة مهمة كونه مترجمًا يواكب الآخر في الدراسات الطازجة، منزويًا في مكتباته، مطلعًا، مزيحًا المكرس، الثابت، متجهًا ومترصدًا الجديد، ومحاولًا تقديم أطروحاته، فيما يدنو يعاين ويخاطر، كما نرى مثال ذلك كتابه «المكون اليهودي في الحضارة الغربية» الذي حلل ذلك المكون ومرجعيته وانفتاحه وتناميه كأقلية وتأثيره الكبير في المكون الغربي، متناولًا أسماء كانت إشكالية حتى في مجتمعاتها اليهودية، ومتعاونًا مع أسماء لها ثقلها منها عبدالوهاب المسيري مستخلصًا رأيه الخاص.
كما نرى الدكتور البازعي لا يتمركز في الجامعة وبحوثها فحسب، وإنما يخرج عن إطارها فيصبح مثلًا رئيسًا للنادي الأدبي بالرياض وعضوًا في حلقة الرياض الفلسفية ومشاركًا بأوراق في حلقتها أو مقدمًا كتابها «أوراق فلسفية» الحاوي لأوراق لباحثين آخرين. هذا النشاط في مواقع مختلفة، وهذه الاستمرارية وتشجيع مشروعات أخرى كمشرف على رسائل دكتوراه أو عضو فاعل، دون ركون لكسل الباحثين واستسهالهم وغرقهم بالمكرر، هي إضافة مهمة تمتاز بها أسماء قلّة، تدرك مخاضات الأدب والثقافة متطورة ومتورطة بالمسائلة الدائمة للأفكار، أحد أمثلة ذلك كتاب بعنوان «قلق المعرفة- إشكاليات فكرية وثقافية»، وغير ذلك من كتب جاوزت عشرين كتابًا لها أهميتها البارزة.

بواسطة الفيصل | يناير 1, 2024 | كاريكاتير

بواسطة الفيصل | ديسمبر 28, 2023 | مسرح
في أزمنة التحولات التي تعيشها المجتمعات، كل شيء جوهري يتحول بدوره، خصوصًا حين تأتي هذه التحولات بعد رغبات دفينة وأحلام كانت ضربًا من المستحيل. الفنون أيضًا يطولها التحول، وبالتالي فهي تذهب في التعبير عن تحول في التحول، ليس التحول الذي يحدث خارجها، إنما أيضا التحول في بنيتها نفسها ومنطوقها وشكلها ومراميها.
مسرحية «رسوم وطلل: جغرافيا القصيدة»، التي استمر عرضها طوال ثماني ليالٍ على مسرح ميادين بالدرعية، وسط جمهور كثيف، نموذج ساطع لهذا التحول في التحول، للمتحول الذي يمضي في صيرورة منسجمة، مع كل ما يحدث في مجالات متعددة، منفعلًا به وفاعلًا فيه، يلتمس منه شرارة الانطلاق، ثم يندلع في صورة حريق هائل، من التعبيرات المبهرة.
يجمع «رسوم وطلل»، للمسرحي الإشكالي صالح زمانان الذي يتمرد باستمرار على نفسه، بين الفائدة والمتعة، بين الماضي والحاضر، بين الجغرافيا والتاريخ، بين الإنسان والأرض، بين الشعر وثقافته، بين الشاعر ومأزقه الوجودي، بين الكرنفال والاستعراض، بين الغناء والفرجة في منتهى معانيها.

ويترافق مع كل ذلك، وعي شقيّ، هو وعي الشاعر زمانان، بالتاريخ والأرض والإنسان، وما ينبغي أن يكون عليه الحاضر، أو أن ما يبدو أن الحاضر انتهى إليه، ما هو إلا لحظة أصيلة جديرة بتاريخها في كل أطواره السابقة. تقول المسرحية المعلن من الجغرافيا والمضمر أيضًا. يفصح النص، الذي عبر عن مخيلة قادرة على عبور الأزمنة من دون أن تتخلى عن زمانها، عن جسد المكان وروحه، وعن امتداده فينا.
قد تكون فكرة النص بسيطة، مجموعة من الفتيات والشباب، يتتبعون؛ تلبيةً لاحتياجات بحثية طلبها منهم أستاذهم، وفي سياق حكائي متواتر، خريطة الشعر منذ القدم إلى زمن قريب. فهم يترحلون، كل فريق على حدة، إلى أجزاء من الوطن المترامي؛ للعثور على الشعراء الذين وسموا تلك الأمكنة بشيء من سيرهم، وطبعوها بما شهدته حيواتهم من منعطفات مهمة، سواءٌ كانت شعريةً أو موضوعيةً.
بالتأكيد، لم يكن المتفرج إزاء حلقة أخرى، من برنامج «على خطى العرب»، إنما كان أبعدَ من ذلك، أو على الأقل كان في مواجهة مع صورة أخرى تقولُ، بتعبيرية جارفة وبطريقة جديدة، موضوعَها، صانعة من الإبهار البصري والحركي جوهرا أساسيا لها.
هذه الإبهار في الحركة وفي الألوان بتعابيرهما الدقيقة، تفردت بإنجازه فرقة أورنينا وقائدها الفنان ناصر إبراهيم، الفرقة ذائعة الصيت التي اشتهرت بعروضها الضخمة والمبهرة، عربيًا وعالميًا، إضافة إلى مجموعة من الشابات والشبان السعوديين.
صنعت أورنينا نصًا حركيًا عميقًا وخاطفًا للأنفاس. نصًا موازيًا وفي الوقت نفسه معبرًا عن أدق مضمرات النص المكتوب، ومشتبكًا به على نحو فريد.
عكست المسرحية حال التنوع والاختلاف في مناطق السعودية؛ من حيث اللباس والألوان إلى منطوقها الشعري والحضاري. أنجز موسيقا العرض وألحانه بشار زرقان، الموسيقيّ الذي عُرِفَ باشتغالاته الطليعية والمفارقة، وأخرجه صبحي يوسف، المعروف جيدًا في المسرح السعودي.

فكرة مبتكرة
لكن كيف يمكن التعبير عن هذه الفكرة البسيطة، لكن المبتكرة بامتياز والخارجة عن مألوف الأفكار التي لها هذا الطابع؟ للتعبير عن هذه الفكرة احتاج المؤلف، الذي عُرِفَ بنصوصه المفارقة والعصية والمربكة، سواءٌ كانت مسرحية أو شعرية، إلى قوام يمزج بين أشكال وصيغ وتعبيرات؛ كي يعطي الفكرة حقها من التجلي، وينأى بها عن التبسيط والمباشرة، وبالتالي يستطيع المتفرج التقاط الفائدة، من دون أن ينتابه الملل.
ساعة كاملة، ربما تنقص أو تزيد بعض الدقائق، من المعرفة والبهجة والفرجة في أقصى درجاتها. مضى وقت المسرحية، بلا أدنى انتباه لسيولة الزمن، وكأن النص، قد «سرى» بنا، ولعل ذلك ما حدث فعلًا، إلى تلك الجغرافيات المتعددة والمختلفة، إلى تلك الكيانات الشعرية الهائلة، التي عاشت في أزمنة سحيقة، لكنها ما برحت تحضر وستحضر في ذاكرتنا، في خروج على الزمن، في صورته الحاضرة، إلى أزمنة ماضية، إلا أنها ما زالت تؤثث الراهن في كل مناحي الحياة، بصورة أو أخرى.
في المسرحية، التي توجت مبادرة عام الشعر العربي، وشهدت حضورًا وتفاعلًا لم ينقطع لحظة واحدة، سيرى المهتم، وغير المهتم، شعراء وشخصيات ميزوا الجغرافيا والتاريخ بملامحهم؛ مثل: امرئ القيس، طرفة بن العبد، ابن المقرب العيوني، عنترة بن شداد، زهير أبي سلمى، عبد يغوث، حاتم الطائي، وليلى الأخيلية.
سيرى الجمهور كل ذلك في نسيج مركب برهافة من القصائد والموسيقا والرقصات البارعة، الأقرب، في بعض ملامحها إلى فن باليه مبهر، بدقة الحركة ورشاقتها وتعبيرتها العميقة. أداء الفتيان والشبان جمع بين المسعى البحثي والاندهاش من النتائج، كانوا هم السبيل إلى الدهشة والدهشة معًا. كانوا صورة للمتفرج الذي لم يقع بعد على جغرافية الشعراء، فتمسه، لاحقًا، جمرة القصيدة وتشعل الأسئلة في خياله ووجدانه. الشابات والشبان جسدوا الشغف، في أبهى صوره، بالفن وبالشعر والجغرافيا.

رسوم وطلل يقعان في الحب
رسوم قائدة فريق الفتيات (أصايل محمد) وطلل قائد فريق الشبان (محسن بدر) سيعبران في ختام العرض عن ولع أحدهما بالآخر، عن نوع من العاطفة والشعور، الذي لن يفصح عن نفسه في سهولة، وكأنما قد تماهيا تمامًا مع ما عثرا عليه وكشفاه للمتفرج من علاقات محمومة، من غرام يفوق الوصف، بين كُثَيِّر عَزّةَ، وقيس وليلى، وعنترة وعبلة، وسواهم من العُشّاق. وكأنما العرض، في أحد وجوهه دعوة إلى الحب، الذي هو الحياة ومباهجها، في المعنى العميق للكلمة.
ترافق مع المسرحية، التي انطلقت عروضها في المدة (20: 27 ديسمبر 2023م)، معرض تشكيلي، شارك فيه عدد من الرسامين، وضم أعمالًا لهم إضافة إلى بعض المعلقات المكتوبة بخط بديع. كل رسام من هؤلاء حاول استلهام قصيدة أو تجربة أو شطرًا من حياة، تخص شاعرًا أو شاعرة، كان لشعره أو شعرها فعل السحر في الوجدان والذاكرة وفي الجسد أيضًا. كل شاعر، وفقًا إلى رؤيته وثقافته، استطاع تحويل ملمح سيروي لشاعر قديم، إلى «ملون» مثير للأسئلة والإعجاب، بل عمق من رؤيتنا لتلك القصيدة أو من نظرتنا لذلك الشاعر. في المعرض وجدت أعمالًا خلابة، لا تقلّ في حيويتها وفي قوة حضورها عما تحقق لبعض قصائد أولئك الشعراء العظام، من حضور وديمومة.


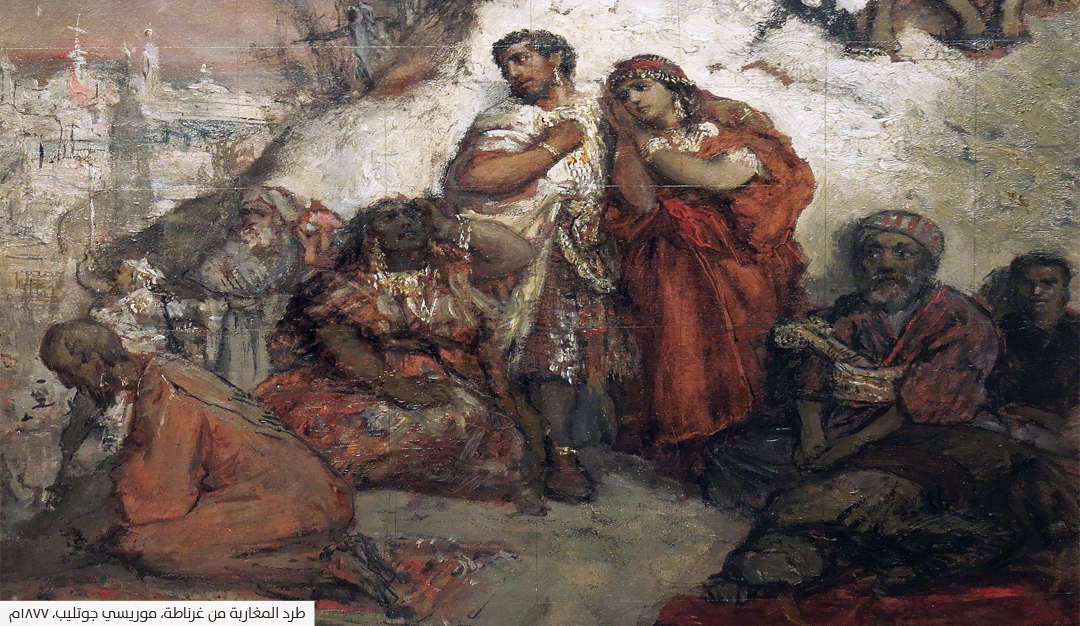
























 أحرج توسع حضور ومقبولية المنتج الإسلامي في المجتمعات الأوربية خلفيته الأصلية الهووية على نحو أجبره على تشفير هذا الرابط بالهوية الدينية أو تخفيف بعده المرئي أو قوة رابطه الهوياتي. وأصبح الدافع الاقتصادي والتجاري هو السياق الجديد للفعل التسويقي لهذا المنتج الإسلامي موضوع تزايد الطلب عليه في مجال غير إسلامي أو مجال معولم تحكمه معقوليات مغايرة للسياقات الأصلية لنشأة فكرة المنتج «حلال». غير أن المنتج لا يمكن له أن ينقطع عن عمقه الديني وعن تواصل رباطه بالجمهور المسلم وفي الآن ذاته هو مدفوع بعامل الرغبة في استثمار إعجاب وإقبال غير المسلم على البعد الجمالي والابتكاري في هذا المنتج الجديد والمغاير لخصائصه الثقافية، على صياغة خطاب جديد أقدر على امتصاص هذا التناقض أو هذه المعادلة الصعبة بين الديني والتجاري، الهووي والاقتصادي، الأسلمة والعلمنة.
أحرج توسع حضور ومقبولية المنتج الإسلامي في المجتمعات الأوربية خلفيته الأصلية الهووية على نحو أجبره على تشفير هذا الرابط بالهوية الدينية أو تخفيف بعده المرئي أو قوة رابطه الهوياتي. وأصبح الدافع الاقتصادي والتجاري هو السياق الجديد للفعل التسويقي لهذا المنتج الإسلامي موضوع تزايد الطلب عليه في مجال غير إسلامي أو مجال معولم تحكمه معقوليات مغايرة للسياقات الأصلية لنشأة فكرة المنتج «حلال». غير أن المنتج لا يمكن له أن ينقطع عن عمقه الديني وعن تواصل رباطه بالجمهور المسلم وفي الآن ذاته هو مدفوع بعامل الرغبة في استثمار إعجاب وإقبال غير المسلم على البعد الجمالي والابتكاري في هذا المنتج الجديد والمغاير لخصائصه الثقافية، على صياغة خطاب جديد أقدر على امتصاص هذا التناقض أو هذه المعادلة الصعبة بين الديني والتجاري، الهووي والاقتصادي، الأسلمة والعلمنة.






 «دكتور سعد. أشعر نحوك بامتنان متواصل لا ينقطع، لعلك تعلم السبب، ولعلك لا تعلم. أنا تلميذك عادل خميس، سبق لي أن تشرفت بلقائك مرات عدة.. في جدة والرياض وغيرهما. منذ زمن بعيد وأنا أستنير برؤاك الثاقبة، أنا متابع دقيق لقلمك، وأشعر وأنا اقرأ كتابًا لك أني بين يدي أفلاطوني الخاص.. إن كنت تؤمن أن لكل شخصٍ أفلاطونًا على مقاسه. وإن كنت تعتقد أن هذا غزلٌ صريح. فأنت على حق: هو كذلك. للتو انتهيت من كتابك القلِق: «قلق المعرفة»، طلبته من أحد الإخوة، فأوصله لي، والتهمته في يومين، ثم عدتُ لـ(أعرمشه) على روقان. واليوم إذ أنتهي من العرمشة، أكتب لك لأقدم شكرًا جزيلًا بحجم قامتك، وحجم تقديري. أخذتني فكرة القلق الذي بُني عليه الكتاب، تحضّـر القارئَ ليظل حبيس شعرة معاوية وهو يشق صفوف أفكارك بين مُشكـكٍ ومتسائل، حالة التوتر التي تحرص عليها مهمة جدًّا -في رأيي- ليصل قارئك لمرادك، قارئك أنت بالذات؛ الإثنية والفكر، وعلاقتهما المشبوهة: ماهية الفلسفة طُعمًا، وهْمُ الموضوعية المقدس الذي أسقطه المسيري رحمه الله، أشياء كثيرة.. كثيرة.. أخذتني أخذًا في كتابك، وكتبك السابقة. وغيرتي على قلمك جعلتني لا أرتاح للمقالات الصغيرة التي ضمنتها الكتاب، على رغم اتفاقها في الخط العام، لكنها تتحدث عن نقاط كبيرة وحساسة. وتحتاج لجهد أكبر وتحليل أوسع؛ لتضمها دفتا كتاب قيم كهذا. أطلتُ عليك أستاذي، لكني حفي بك، وأشعر بشهية مفتوحة لنقاشك، والسماع منك، فسامحني».
«دكتور سعد. أشعر نحوك بامتنان متواصل لا ينقطع، لعلك تعلم السبب، ولعلك لا تعلم. أنا تلميذك عادل خميس، سبق لي أن تشرفت بلقائك مرات عدة.. في جدة والرياض وغيرهما. منذ زمن بعيد وأنا أستنير برؤاك الثاقبة، أنا متابع دقيق لقلمك، وأشعر وأنا اقرأ كتابًا لك أني بين يدي أفلاطوني الخاص.. إن كنت تؤمن أن لكل شخصٍ أفلاطونًا على مقاسه. وإن كنت تعتقد أن هذا غزلٌ صريح. فأنت على حق: هو كذلك. للتو انتهيت من كتابك القلِق: «قلق المعرفة»، طلبته من أحد الإخوة، فأوصله لي، والتهمته في يومين، ثم عدتُ لـ(أعرمشه) على روقان. واليوم إذ أنتهي من العرمشة، أكتب لك لأقدم شكرًا جزيلًا بحجم قامتك، وحجم تقديري. أخذتني فكرة القلق الذي بُني عليه الكتاب، تحضّـر القارئَ ليظل حبيس شعرة معاوية وهو يشق صفوف أفكارك بين مُشكـكٍ ومتسائل، حالة التوتر التي تحرص عليها مهمة جدًّا -في رأيي- ليصل قارئك لمرادك، قارئك أنت بالذات؛ الإثنية والفكر، وعلاقتهما المشبوهة: ماهية الفلسفة طُعمًا، وهْمُ الموضوعية المقدس الذي أسقطه المسيري رحمه الله، أشياء كثيرة.. كثيرة.. أخذتني أخذًا في كتابك، وكتبك السابقة. وغيرتي على قلمك جعلتني لا أرتاح للمقالات الصغيرة التي ضمنتها الكتاب، على رغم اتفاقها في الخط العام، لكنها تتحدث عن نقاط كبيرة وحساسة. وتحتاج لجهد أكبر وتحليل أوسع؛ لتضمها دفتا كتاب قيم كهذا. أطلتُ عليك أستاذي، لكني حفي بك، وأشعر بشهية مفتوحة لنقاشك، والسماع منك، فسامحني».
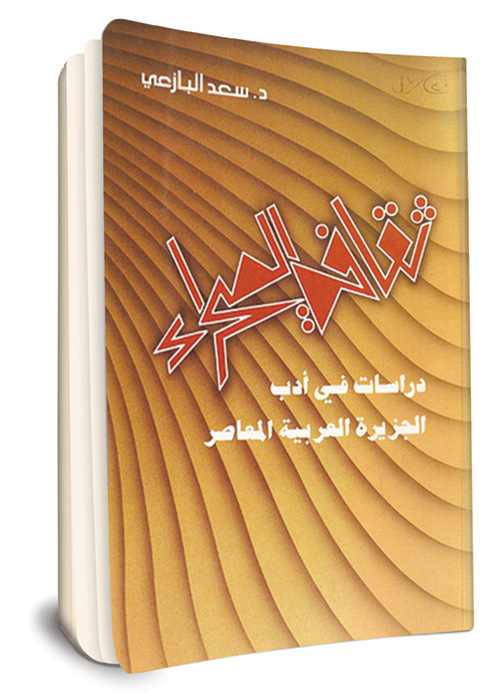 وحين يريد امرؤ ما أن يكتب عن البازعي مثقفًا وناقدًا ومؤلفًا ومترجمًا وناشطًا في حقول المعرفة فلن يقدم في الغالب معلومات جديدة؛ لأن الذين كتبوا ويكتبون عنه كثيرون، وهم يتجددون بتجدد منجزات هذا الرجل التي لا تتوقف، وستتقاطع الكتابات عنه في هذه السياقات مع بعضها. واللافت أن تلك الكتابات تتأسس في حقيقتها على مرتكز رئيس وعميق، بيد أنه يبدو غائبًا ومتواريًا لم يقبض على جمرته أحد ممن كتب عن البازعي، واستهدف شخصيته العلمية ومنجزاته المعرفية. والحديث هنا عن الشخصية الإنسانية لهذا الرجل، وهي شخصية غنية جدًّا؛ إذ يتدفق الحس الإنساني منها بشكل مدهش، ويبدو ذلك ظاهرًا في التعامل مع الآخرين، واحترام حضورهم ومنجزاتهم وتقديرها دون أن يكون ذلك سببًا للتنازل عن الجودة والعمق المعرفي، ودون أن يفضي به ذلك إلى المصانعة والمجاملة الممجوجة.
وحين يريد امرؤ ما أن يكتب عن البازعي مثقفًا وناقدًا ومؤلفًا ومترجمًا وناشطًا في حقول المعرفة فلن يقدم في الغالب معلومات جديدة؛ لأن الذين كتبوا ويكتبون عنه كثيرون، وهم يتجددون بتجدد منجزات هذا الرجل التي لا تتوقف، وستتقاطع الكتابات عنه في هذه السياقات مع بعضها. واللافت أن تلك الكتابات تتأسس في حقيقتها على مرتكز رئيس وعميق، بيد أنه يبدو غائبًا ومتواريًا لم يقبض على جمرته أحد ممن كتب عن البازعي، واستهدف شخصيته العلمية ومنجزاته المعرفية. والحديث هنا عن الشخصية الإنسانية لهذا الرجل، وهي شخصية غنية جدًّا؛ إذ يتدفق الحس الإنساني منها بشكل مدهش، ويبدو ذلك ظاهرًا في التعامل مع الآخرين، واحترام حضورهم ومنجزاتهم وتقديرها دون أن يكون ذلك سببًا للتنازل عن الجودة والعمق المعرفي، ودون أن يفضي به ذلك إلى المصانعة والمجاملة الممجوجة.


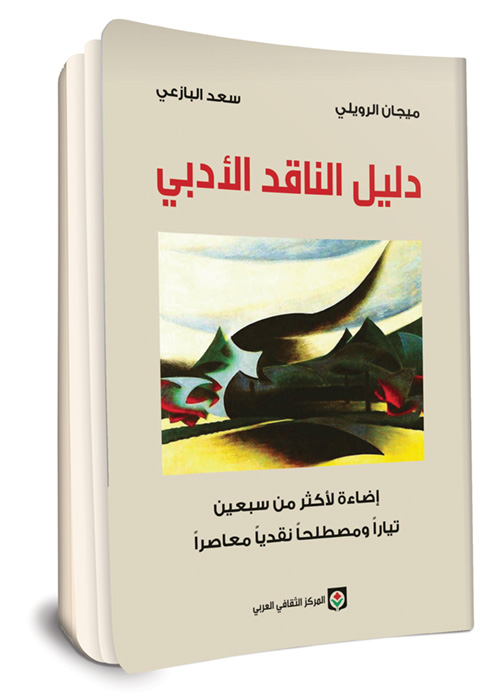 أما في مرحلة دراسة الأدب المقارن، فقد كان من ضمن عدتي المعرفية والمنهجية كتب مثل «استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث»، و«المكون اليهودي في الحضارة الغربية»، وغيرها من مؤلفات الدكتور سعد التي يسعى فيها لتحليل وفهم العلاقات والتأثيرات بين الأقطاب الفكرية العالمية واللاعبين المؤثرين في الحضارة المعاصرة من خلال إطار منهجي متسق ومتماسك يسعى لفحص المفاهيم الكبرى ورحلتها بين الثقافات وتشاكلاتها التاريخية والجغرافية، وهو ما تجلى أيضًا في كتابه «هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة» الذي ينطلق فيه من تلك القاعدة الفكرية نفسها. هذا عدا عن مؤلفاته النقدية التطبيقية، وترجماته لعدد كبير من الكتب التي يظهر في اختياراته لها أن الخريطة المعرفية التي يسير في طرقها واضحة لديه، وهو في رحلته المعرفية هذه يركز على الأصول والمنهج العلمي في البحث، ولا يغفل الاطلاع على الجديد من إنتاج أدبي وأجناس فنية تتسع لتشمل السينما والموسيقا والثقافة الشعبية وسواها.
أما في مرحلة دراسة الأدب المقارن، فقد كان من ضمن عدتي المعرفية والمنهجية كتب مثل «استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث»، و«المكون اليهودي في الحضارة الغربية»، وغيرها من مؤلفات الدكتور سعد التي يسعى فيها لتحليل وفهم العلاقات والتأثيرات بين الأقطاب الفكرية العالمية واللاعبين المؤثرين في الحضارة المعاصرة من خلال إطار منهجي متسق ومتماسك يسعى لفحص المفاهيم الكبرى ورحلتها بين الثقافات وتشاكلاتها التاريخية والجغرافية، وهو ما تجلى أيضًا في كتابه «هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة» الذي ينطلق فيه من تلك القاعدة الفكرية نفسها. هذا عدا عن مؤلفاته النقدية التطبيقية، وترجماته لعدد كبير من الكتب التي يظهر في اختياراته لها أن الخريطة المعرفية التي يسير في طرقها واضحة لديه، وهو في رحلته المعرفية هذه يركز على الأصول والمنهج العلمي في البحث، ولا يغفل الاطلاع على الجديد من إنتاج أدبي وأجناس فنية تتسع لتشمل السينما والموسيقا والثقافة الشعبية وسواها.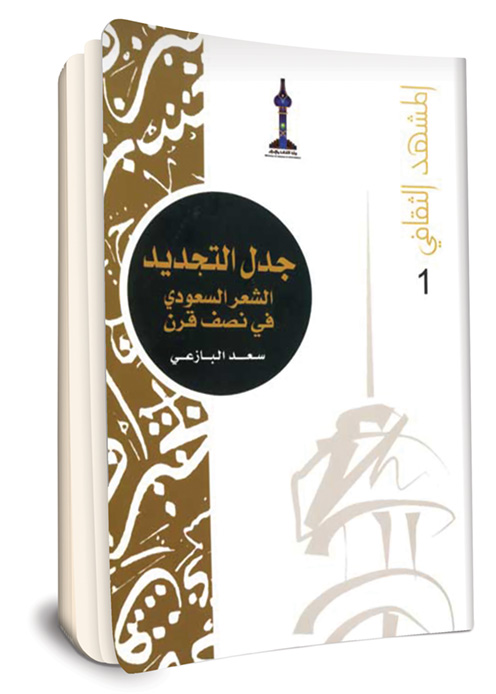 الحوار مع الآخر ومخاطبة فكره وثقافته نقدًا وتحليلًا وتفكيكًا لبعض مقولاته المهيمنة، جوانب لا يمكن إغفالها في تجربة البازعي. فإن كانت كتاباته النقدية تسائل القصيدة والإبداع في عمومه وتحاور النص شعرًا ونثرًا، فإن كتاباته الفكرية تثير تساؤلات فكرية مهمة جدًّا في المشهد المحلي والعربي والعالمي. ويبدو أن نقاش فكر الآخر والحفر فيه يعد محورًا رئيسًا في مشروع البازعي، وهو مشروع قديم ومتجدد، فالآخر يظل دومًا قضية حساسة ومهمة في أية ثقافة، منها تقارب وعيك بذاتك وثقافتك وفي الوقت نفسه تحاور وعي الآخر وثقافته. وبذلك استطاع البازعي مقاربة قضايا حساسة جدًّا في المشهد الثقافي العربي وحواره مع الآخر ولا سيما في «المكون اليهودي في الثقافة الغربية» الذي يسعى إلى إبراز الدور الذي لعبه اليهود في تاريخ الحضارة الغربية ابتداءً من القرن السابع عشر حتى اليوم. ويبرز الكتاب ضمن هذا الإطار التأثير المتعاظم لدور الجماعات اليهودية في مختلف مناطق أوربا وأميركا الشمالية على مستويات ثقافية مختلفة، متناولًا أعمال عدد من المفكرين والعلماء والمبدعين الذين تركوا أثرًا بالغًا في تطور الحضارة الغربية، وصار جزءًا من نسيجها في الوقت الذي عبرت أعمالهم عن أفكار جماعتهم ورؤاها وهموم وتطلعات الجماعات اليهودية التي ينتمون إليها، ومنهم مفكرون مثل: سبينوزا وماركس ودريدا، وشعراء مثل: هاينه وتسيلان، وروائيون مثل: دزرائيلي وروث، ونقاد مثل: هارولد بلوم، وعلماء مثل: فرويد.
الحوار مع الآخر ومخاطبة فكره وثقافته نقدًا وتحليلًا وتفكيكًا لبعض مقولاته المهيمنة، جوانب لا يمكن إغفالها في تجربة البازعي. فإن كانت كتاباته النقدية تسائل القصيدة والإبداع في عمومه وتحاور النص شعرًا ونثرًا، فإن كتاباته الفكرية تثير تساؤلات فكرية مهمة جدًّا في المشهد المحلي والعربي والعالمي. ويبدو أن نقاش فكر الآخر والحفر فيه يعد محورًا رئيسًا في مشروع البازعي، وهو مشروع قديم ومتجدد، فالآخر يظل دومًا قضية حساسة ومهمة في أية ثقافة، منها تقارب وعيك بذاتك وثقافتك وفي الوقت نفسه تحاور وعي الآخر وثقافته. وبذلك استطاع البازعي مقاربة قضايا حساسة جدًّا في المشهد الثقافي العربي وحواره مع الآخر ولا سيما في «المكون اليهودي في الثقافة الغربية» الذي يسعى إلى إبراز الدور الذي لعبه اليهود في تاريخ الحضارة الغربية ابتداءً من القرن السابع عشر حتى اليوم. ويبرز الكتاب ضمن هذا الإطار التأثير المتعاظم لدور الجماعات اليهودية في مختلف مناطق أوربا وأميركا الشمالية على مستويات ثقافية مختلفة، متناولًا أعمال عدد من المفكرين والعلماء والمبدعين الذين تركوا أثرًا بالغًا في تطور الحضارة الغربية، وصار جزءًا من نسيجها في الوقت الذي عبرت أعمالهم عن أفكار جماعتهم ورؤاها وهموم وتطلعات الجماعات اليهودية التي ينتمون إليها، ومنهم مفكرون مثل: سبينوزا وماركس ودريدا، وشعراء مثل: هاينه وتسيلان، وروائيون مثل: دزرائيلي وروث، ونقاد مثل: هارولد بلوم، وعلماء مثل: فرويد. 
 انماز البازعي بشخصية بحثية متماسكة، ديدنها الاستقصاء، فنجده يتتبع تحولات المفاهيم خلال عملية تأصيلها، ليتوقف عند محطات مجهولة من المثاقفة الحضارية، أو من عملية التأثر والتأثير ليكشف عن المغالطات التاريخية أو المجهول في الثقافة الذي غيبته الرغبات الاستعمارية أو الأنظمة السياسية الحاكمة، أو حورته لصالح ما، كما يكشف عن الاختلافات التي يعيشها المفهوم نفسه بانتقاله إلى سياقات ثقافية جديدة. لم يركن البازعي إلى واحدية فكرية، بل عاش جملة من الازدواجيات الغنية، فكان بنفسه لحظة اتصال بين الثقافتين العربية والأميركية، كما كان بذاته قِرانا بين اللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك وقف على جسر واصل بين عالمي السياسة والأدب. ومن هذا وذاك، ومن تلك القِرانات، ومن فطنة السعودي الذي أحسن استثمار ما أُتيح له من فضاءات ثقافية، قرنها بجدية واضحة، ودأب لا يخفى على ذي بصر؛ صنع البازعي فضاءه المعرفي والثقافي.
انماز البازعي بشخصية بحثية متماسكة، ديدنها الاستقصاء، فنجده يتتبع تحولات المفاهيم خلال عملية تأصيلها، ليتوقف عند محطات مجهولة من المثاقفة الحضارية، أو من عملية التأثر والتأثير ليكشف عن المغالطات التاريخية أو المجهول في الثقافة الذي غيبته الرغبات الاستعمارية أو الأنظمة السياسية الحاكمة، أو حورته لصالح ما، كما يكشف عن الاختلافات التي يعيشها المفهوم نفسه بانتقاله إلى سياقات ثقافية جديدة. لم يركن البازعي إلى واحدية فكرية، بل عاش جملة من الازدواجيات الغنية، فكان بنفسه لحظة اتصال بين الثقافتين العربية والأميركية، كما كان بذاته قِرانا بين اللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك وقف على جسر واصل بين عالمي السياسة والأدب. ومن هذا وذاك، ومن تلك القِرانات، ومن فطنة السعودي الذي أحسن استثمار ما أُتيح له من فضاءات ثقافية، قرنها بجدية واضحة، ودأب لا يخفى على ذي بصر؛ صنع البازعي فضاءه المعرفي والثقافي.
 في كتب البازعي، الذي اختير شخصية معرض الكويت للكتاب الدولي، نرى أسباب اختياره؛ فهو شخصية دون شك متعددة المنجز له محاولاته الدؤوبة كناقد، مفكر ومترجم فاحص لأسئلته والاشتباك مع أسئلة وآراء أخرى ربما كانت مغايرة أو حتى على الضد معه. يظهر ذلك منعكسًا في خوضه مجالات مختلفة من مقاربة للنتاج الشعري والبيئة والسينما والرواية حتى أدب الجائحة وغير ذلك، حاملًا ميزة مهمة كونه مترجمًا يواكب الآخر في الدراسات الطازجة، منزويًا في مكتباته، مطلعًا، مزيحًا المكرس، الثابت، متجهًا ومترصدًا الجديد، ومحاولًا تقديم أطروحاته، فيما يدنو يعاين ويخاطر، كما نرى مثال ذلك كتابه «المكون اليهودي في الحضارة الغربية» الذي حلل ذلك المكون ومرجعيته وانفتاحه وتناميه كأقلية وتأثيره الكبير في المكون الغربي، متناولًا أسماء كانت إشكالية حتى في مجتمعاتها اليهودية، ومتعاونًا مع أسماء لها ثقلها منها عبدالوهاب المسيري مستخلصًا رأيه الخاص.
في كتب البازعي، الذي اختير شخصية معرض الكويت للكتاب الدولي، نرى أسباب اختياره؛ فهو شخصية دون شك متعددة المنجز له محاولاته الدؤوبة كناقد، مفكر ومترجم فاحص لأسئلته والاشتباك مع أسئلة وآراء أخرى ربما كانت مغايرة أو حتى على الضد معه. يظهر ذلك منعكسًا في خوضه مجالات مختلفة من مقاربة للنتاج الشعري والبيئة والسينما والرواية حتى أدب الجائحة وغير ذلك، حاملًا ميزة مهمة كونه مترجمًا يواكب الآخر في الدراسات الطازجة، منزويًا في مكتباته، مطلعًا، مزيحًا المكرس، الثابت، متجهًا ومترصدًا الجديد، ومحاولًا تقديم أطروحاته، فيما يدنو يعاين ويخاطر، كما نرى مثال ذلك كتابه «المكون اليهودي في الحضارة الغربية» الذي حلل ذلك المكون ومرجعيته وانفتاحه وتناميه كأقلية وتأثيره الكبير في المكون الغربي، متناولًا أسماء كانت إشكالية حتى في مجتمعاتها اليهودية، ومتعاونًا مع أسماء لها ثقلها منها عبدالوهاب المسيري مستخلصًا رأيه الخاص.





