
بواسطة أحمد فرحات - شاعر وكاتب لبناني | يناير 1, 2022 | بورتريه
أسست لحداثة لونية، وشعرية، وسردية خاصة بها، وكانت فيها كلها لا تشبه إلا نفسها، وظلت تعطي بزخم إبداعي تصاعدي متجاوز حتى آخر رمق من حياتها غير هيابة بالسن الذي بلغته، وماتت عليه، وهو سن الـ96 عامًا.
نعم، عاشت الفنانة والشاعرة والروائية اللبنانية الأميركية الراحلة إيتيل عدنان (1925– 2021م غابت عن دنيانا في 14 نوفمبر الفائت) شبابًا إبداعيًّا مديدًا تفتحت مراياه الفريدة على نحو ألهم كثيرًا من الفنانين التشكيليين، ليس على المستوى العربي فقط، وإنما العالمي أيضًا؛ إذ قال فيها الناقد والمؤرخ الفني الألماني هانز أورليخ أوبريست: «إن هذه الفنانة اللبنانية أسهمت في حركة الفن التشكيلي الأوربي والغربي الحديث على نحو ريادي لاحق أو مستأنف لأعمال جيل المؤسسين الرموز؛ من أمثال الفنانين: الروسي فاسيلي كاندينسكي، والإيطالي أومبرتو بوتشيني، والأميركي جاكسون بولوك، والإسباني خوان ميرو،… وغيرهم، خصوصًا رفدها الاتجاه الفني التجريدي الغربي الذي نشأ في بدايات القرن العشرين بتلك الملوانة المتوسطية المشعة والمتفائلة، وإعطاء اللوحة اللاتصويرية على امتداد نموذجها العالمي نكهة لونية مثالية جديدة، مُنطلقها الخيالات الخصبة المهومة لا المرئيات أو التجسيدات المباشرة على اختلافها».
ومن يطالع لوحات إيتيل عدنان على مدار تجربتها المخضرمة الطويلة، يجد أنها لم ترسم يومًا لوحة تجسيدية أو تصويرية واحدة (اللهم إلا بعض نماذج مبعثرة لم تكترث لها في سياق مسارها الفني المركزي العام)، بل ظلت «تنطق» بالتجريد اللوني الغنائي المختلط بحواسها إلى أواخر أيام حياتها؛ وظلت تعتقد في الوقت نفسه، على غرار التشكيلي الروسي سيرغي بولياكوف، «أن الفن التجريدي هو فن موجه للبصيرة الدفينة وليس للبصر العابر؛ لذلك فالتجريد فن قادر على جمع حساسية إنسان الشرق والغرب في آنٍ واحدٍ». وعلى العموم اتسمت لوحات إيتيل عدنان التجريدية بالهدوء المفتوح والسكينة اللونية المبهجة، وابتكار أنوار شموس أخرى على هامش متن أنوار الشمس الاعتيادية: منها الشموس الخضر والزرق والحمر وذات اللون الفضي حتى شموس أخرى بلا ألوان. وكانت فنانتنا الراحلة تنطلق أيضًا، وبثقة عارمة، من «تعليمة» راسخة في ذاكرتها قالها ذات يوم الفنان السويسري الكبير بول كلي (1879– 1940م) ومفادها «أن ليس على الرسام أن يرسم ما يراه، بل ما سوف يراه».
وبصفتي كنت مدمنًا على حضور ومشاهدة أغلبية معارضها في بيروت، وبعض معارضها التي تسنّى لي مشاهدتها في باريس ولندن ونيويورك ولوس أنجليس، فإنني أستطيع القول: إن ظاهرة إيتيل عدنان الفنية التشكيلية تتشابه، على وجه الإجمال، في الشخصية اللونية العامة التي تقدمها، وتختلف في التأملات والانفعالات عبرها. إنها تقدم تجريدًا لونيًّا يفلسف عالمها الداخلي الحار، والضاجّ بحركة الأحاسيس المتقاطعة، وتقلبات خطوط الحدس الآمرة، فضلًا عن ثورة المعنى التي تظل تعلنها كهوية التزام لديها، وهي تحرير إنسانها العربي المقهور من كل أنواع الظلم والجهل والفقر والدفع به نحو نهوض عقلاني جديد ينبغي أن يكون فجره حتميًّا وقارًّا.
هكذا تشتبك الألوان بالأفكار لدى إيتيل عدنان على أرض اللوحة الواحدة، مهما كبرت مساحتها أو صغرت؛ ويطغى إحساسها كفنانة على اللون نفسه من خلال تحكمها بتدرج علاماته وشراهة توزيعها على القماشة أمامها. ولا غرو فكل لوحة من لوحاتها تمثل وطنًا لها ولإنسانها الذي يظل مسكونًا بضميرها إلى ما لا نهاية. نعم، هي فنانة تفيض برؤى الإنسان العربي الحر من خلال التجريد الفني، وأسطرة هذا التجريد، وتقصي رموزه التي تسطع فيما وراء اللون وإشاراته، ووراء الرغبة باحتداماتها المتخيلة.
تمسك إيتيل عدنان الفرشاة بيد فائقة البراعة في التعبير عن الإحساس بالاستعارة اللونية بغية رسم الملامح التكوينية للاتجاهات أو الكتل المتداخلة التي تريد تشكيلها على مساحة الكانفاس أمامها، ثم تحويلها إلى مقام بصري متكامل يتوخى، في المحصلة، مخاطبة الجميع واستقطاب الجميع، كلٌّ بحسب وعيه بالثقافة البصرية أو تعاطيه مع البلاغة الرمزية التي يقدمها ذلكم المقام البصري المجرد لديها.

وهكذا كانت لوحات إيتيل عدنان التجريدية من أهم الإنجازات الفنية التشكيلية في العالم العربي في رأي الفنان التشكيلي السوري الكبير فاتح المدرس، الذي أردف يقول لي عندما زرته في مرسمه الشهير بالقرب من «نادي الشرق» في العاصمة السورية عام 1991م: «إيتيل عدنان أيقونة الفن التجريدي العربي، ومعه أيضًا، ومن دون مبالغة أغلب تجارب الفن التجريدي الحديث في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط… ولوحاتها، على الدوام تشي بهويتها الجذرية السورية واليونانية (الفنانة مولودة في بيروت من أم يونانية مسيحية وأب سوري مسلم كان ضابطًا عثمانيًّا في حامية بيروت آنذاك) ثم اللبنانية والأميركية.. واستطرادًا العالمية التي صارت تصدر عنها جميعًا بفن إنساني الطابع والتوجه. وما يلفتني فيها بعد أنها كانت شاعرة كبيرة، بل كان الشعر تجربتها الأولى قبل الرسم».
كل شيء من حول إيتيل عدنان كان يسهم في تطوير تجربتها الفنية التجريدية والفكرة اللونية التي ينطق بها هذا التجريد. ومن هنا تأتي هذه البصمة الخاصة التي كانت وستظل تميز أعمالها مقارنة بأعمال كثير من نظرائها، عربيًّا وعالميًّا.
مقطع القول، أعمالها الفنية تدلل عليها بمجرد حضورها، إن في معارض جماعية أو فردية أو حتى وهي متوزعة على جدران البيوت الخاصة وبعض المتاحف العالمية. ويستطيع، من فوره، أي ناقد تشكيلي خبير بمفاتيح التجريد وأدواته ومفرداته التقاطها والتعبير عن روح الإبداع والابتكار فيها، ومثله أيضًا ذاك المشاهد المثقف والمتذوق للفن التجريدي، والمتابع لانفجار حركته المتمادية منذ مطالع القرن العشرين امتدادًا إلى يومنا هذا. ومن هنا نرى أن جمهور إيتيل عدنان التشكيلي هو جمهور عالمي واحد تقريبًا، وإن بهُويات مختلفة ومتباينة، ثقافيًّا وأيديولوجيًّا.
لقاءات مشتركة
أكثر من مرة التقيت إيتيل عدنان في بيروت وباريس وفي منزلها في مدينة سوساليتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وكانت لي جولات حوارية ودردشات مستفيضة معها حول عالمها الفني والشعري والروائي، فضلًا عما كان يجول في رأسها من محمولات فكرية وسياسية وفلسفية وثقافية أخرى، من مثل حبها لشعر الهنود الحمر في أميركا الشمالية، وفي ولاية بارا في جنوب البرازيل، فضلًا عن افتتانها بآثار حضارات جماعات المايا والأنكا والأزتيك في أميركا الوسطى والجنوبية وما خلفته هذه الجماعات من آداب وأناشيد شعرية وأساطير نُسج حولها كثير من القصص والروايات التي خلبت لب فنانتنا، وتأثرت بها في العديد من نصوصها الشعرية، وكذلك في بعض لوحاتها الفنية التجريدية.
كما أبدت إيتيل عدنان تضامنًا قويًّا ومباشرًا مع من تبقى من سلالات تلك الحضارات القديمة التي دمرها الغزاة الإسبان وشردوا أقوامها في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. كما قضوا على معارفهم المتقدمة في طرز البناء والكتابة وبعض علوم الكيمياء والرياضيات والفلك والفنون ذات الطابع التجريدي والمعتقدي الغامض. أتذكر أنها قرأت لي أكثر من نص شعري أزتيكي بالإنجليزية، منها هذا النص الذي يقول ما ترجمته بالعربية:
«حدائق معلقة في الفضاء البعيد/ بدأت تهبط بنعومة نحو الأرض/ انتبه لها أيها الإنسان الملتبس بنفسه/ وحاذر أن تشعل نارًا تزعجها/ وتخرب عليها احتفالاتها بالهبوط السعيد/ أيها الإنسان الملتبس بنفسه/ اغتنم فرصة أن تأتي إليك هذه الحدائق/ لتشملك بعالمها الرحيب دون أن تدري/ وتخفي عنك كل المسافات والحدود/ وتزيل عبء كل الانتظارات التي تعذبك بلا جدوى/ إنها حدائق آتية إليك بأسرارها الملونة/ ولها مهمة مقدسة واحدة/ أن تختفي فيك وتختفي فيها/ وتكف عن أن تكون أنت… أنت/ وهي… هي».
وبالعودة إلى عالم إيتيل عدنان الفني التجريدي، كنت سألت فنانتنا الكبيرة عن كيفية تعبيرها عن قضايا سياسية مباشرة تخص بلادها ومجتمعاتها العربية المأزومة بخطاب فني تجريدي لا يستوعبه الأغلب الأعم من الذين يفترض أنه موجه إليهم، فأجابت بما خلاصته أن الفن شيء والسياسة شيء آخر، وليس من الضروري البتة أن يعكس الفن شعارًا سياسيًّا فجًّا وعالي الصرخة حتى ترضى عنه السياسة، ومن يمثلها. إن لغة الفن والإبداع ليست تابعة لأحد، إلا لذاتها وتطورها هي في قلب عالمها. «وصدقني إذا ما قلت لك: إن لوحاتي التجريدية التي عكس بعضها موقفًا مضادًّا من الحرب الأهلية اللبنانية، وبعضها الآخر عكس نصرة القضية الفلسطينية، كانت مفهومة من مجموعة من نقاد الفن الكبار ومعهم جمهور نخبوي لا يستهان به، شكلوا جميعًا، في الداخل العربي وخارجه، خميرة لها تأثيرها الطاغي على الجمهور العام، وحتى أحيانًا على القرار السياسي وصناعه الحاسمين، ليس في دول الغرب فقط وإنما في العديد من دولنا العربية».
مصادرها التشكيلية
قادني الحديث مع الفنانة إيتيل عدنان بعدُ إلى البحث في مصادرها التشكيلية هي، وخصوصًا مَنْ تأثرت بهم من فنانين عالميين كبار، أمثال الروسي فاسيلي كاندينسكي (1866– 1944م) مؤسس الفن التجريدي الحديث، فأجابت بأن أعماله الفنية كانت عامل تشجيع لها على المضي قدمًا في فضاء تأسيس صوت فني تجريدي خاص بها؛ «لأن هذا الفن بالتحديد يفرض عليك أن تكون فنانًا مستقلًّا فيه أو لا تكون. والتجريد في المناسبة فن صعب للغاية كما قال كاندينسكي نفسه، وكذلك غيره من فنانين غربيين مؤسسين، وعليه فالتحدي يكون مضاعفًا هنا لإثبات الذات الفنية وتكوين هويتها المتفردة، ودائمًا على قاعدة بناء الظواهر والعلامات على سطح اللوحة من دون تمثيلها وشخصنتها. من جهة أخرى، يتطلب فن التجريد وعيًا خاصًّا باللون الواحد ووظائفه إزاء الألوان الأخرى كي تأتي النتيجة العامة للملوانة وكتلها على الكانفاس، متوافقة مع الأفكار التي تدور في رأس الفنان نفسه، ومن ثم لاحقًا في رأس مشاهد العمل.
استطردت إيتيل عدنان تقول: إنه لفتتها مقولة مهمة جدًّا لكاندينسكي تكرست لاحقًا كعرفٍ يجدر الالتفات إليه، وخلاصته أن على من يقرر الخوض في تجربة اللوحة التجريدية أن يكون شاعرًا وشاعرًا حقيقيًّا… يقول: «من بين جميع الفنون، اللوحة التجريدية هي الأصعب، حيث إنها تتطلب أن تعرف كيف ترسم جيدًا، وأن تمتلك حساسية شديدة للتكوين والألوان، وأن تكون شاعرًا حقيقيًّا، وهذا الأمر الأخير ضروري للغاية».
 لا شك أن إيتيل عدنان تفاعلت مع هذه المقولة الأثيرة لكاندينسكي واستوعبتها في الصميم، ولكن بعدما كانت قد خاضت في فن التجريد سنوات طويلة قبل قراءتها لها حسبما أفادتني هي بذلك. وعليه هي بدأت بالرسم كتجربة إبداعية ثانية بمعزل عن هذه المقولة، وذلك بعد خوضها تجربة الكتابة الشعرية كتجربة أولى، ولا تزال في عز خوضها لها حتى الآن، ولم تتنازل، بالتالي، عن القصيدة البتة لمصلحة اللوحة.
لا شك أن إيتيل عدنان تفاعلت مع هذه المقولة الأثيرة لكاندينسكي واستوعبتها في الصميم، ولكن بعدما كانت قد خاضت في فن التجريد سنوات طويلة قبل قراءتها لها حسبما أفادتني هي بذلك. وعليه هي بدأت بالرسم كتجربة إبداعية ثانية بمعزل عن هذه المقولة، وذلك بعد خوضها تجربة الكتابة الشعرية كتجربة أولى، ولا تزال في عز خوضها لها حتى الآن، ولم تتنازل، بالتالي، عن القصيدة البتة لمصلحة اللوحة.
ولكن كاندينسكي مؤسس الفن التجريدي في العالم لم يكن شاعرًا سيدتي إيتيل، فكيف تعللين ما قاله في هذا المجال؟ سألتها فأجابت: «صحيح أن كاندينسكي لم يكن شاعرًا، ولكنه كان مشبعًا بالشعرية والأساطير والميثولوجيات القديمة، وكان يردها جميعًا إلى الشعر الذي يدفع بالإنسان إلى البعد الأسمى والأصفى. وهو كفنان لوحة تجريدية يشترك مع الشاعر في استقراء الصمت والإيغال العميق فيه، ومثل هذا الإيغال العميق يدفعه بدوره إلى نوع من التصوف بالألوان وحركتها وامتداداتها وتحويل الوعي بالأفكار لديه إلى الوعي بالألوان والتعبير بها. ومن هنا هو كتجريدي متطرف صار يرى في الجمال صورة الموت، وأن المستقبل ليس هو أبدًا إلا بريق ما كان يجب أن يتم سابقًا».
وماذا تقولين في تجربة التشكيلي السويسري الريادي بول كلي؟ الناقد التشكيلي اللبناني نزيه خاطر كان يرى أوجه شبه كثيرة بين تجريدياتك وتجريدياته.. بِمَ تعلقين؟
أجابت: أنا أعشق أعمال بول كلي الفنية كلها، ولا سيما تلك التي حققها بعد انتقاله إلى تونس ليستمتع بشمسها ويوظف ضوء الشمس في محتوى الألوان التي صار يتضمنها متن لوحته الجديدة. ثم أنا ناقشت نزيه خاطر شخصيًّا فيما كتبه حول مسألة التشابه بين لوحاتي ولوحات الفنان الكبير بول كلي التي مررت أنت على ذكرها في سؤالك، وقلتُ له الكلام الذي سأعيده عليك الآن. أنا أعتقد أن بول كلي عندما ترك برودة أوربا وضبابها الكثيف وجاء إلى أضواء شمس تونس والمتوسط برمته، تغيرت لوحته هو وصارت تشبه لوحاتنا نحن أهل المتوسط، سواء كنا من جيله الفني أم من الجيل الفني اللاحق عليه. هكذا فمعادلة التشابه هنا ينبغي التدقيق فيها وإعادة النظر جذريًّا فيها، وبخاصة أنها تطرح بصيغة المعلم والأستاذ، إن ضمنًا أو علنًا أحيانًا».
قلت لها: أنا ما قصدت استفزازًا، أو أي رائحة استفزاز لكِ في سؤالي السابق، ولا أعتقد أيضًا أن الناقد نزيه خاطر كان يقصد التقليل من شأن تجربتك أمام تجربة الفنان السويسري الرائد بول كلي. أقول ذلك عن يقين كلي؛ لأننا -نزيه خاطر وأنا- سبق وناقشنا أمر التشابه هذا، ليس بالمعنى السلبي أو التكراري للكلمة، وإنما بمعناها الإيجابي الدقيق الذي يفصل بين مناخ التجربتين الفارقتين فعلًا، وبخاصة أن الفنان بول كلي كان قد أعلن أن تحركه في اتجاه تونس كان أصلًا بغرض إحداث تغيير في شخصه وفي ملوانته على السواء.
المسار الشعري
كان الفن التجريدي معادلًا موضوعيًّا للتعبير الشعري عند إيتيل عدنان؛ فهي تكتب الشعر كما ترسم… والعكس صحيح؛ هكذا بالإحساس نفسه، والدوافع المخزونة نفسها، ولكن دائمًا في إطار شغف التنافس أو الصراع بين اللون والكلمة، والذي يحدده غالبًا المزاج لديها. وشعرها عمومًا يميل إلى سحر الانتهاك الذي يصعق طمأنينتنا ولكن لا يقتل الأمل فينا. وأجمل ترجمات لأشعارها هي التي نقلها عن الفرنسية الشاعر التونسي خالد النجار، وتلك التي نقلها عن الإنجليزية الشاعر العراقي سركون بولص.
يتميز شعر إيتيل عدنان بأنه نتاج نفسه ومناخاته المفاجئة، فهو لا ينتمي إلى تيار شعري بحاله، ولا إلى مناخات قصيدة النثر التي كثر الكلام عليها في العقود الأربعة الماضية، ولا يستطيع النقد أن يحصر شعرها في خانة معينة حتى لدراسته دراسة أكاديمية منسقة. وهو في بعض مناحيه شعر في غاية البساطة، وفي الوقت نفسه في غاية التعقيد، لكنه سلس دائمًا، ويتألف أحيانًا من «أناشيد» مرقمة إلى قصائد قصيرة أو مقطوعات مختزلة بعينها، ويترك للقارئ الانخراط فيه على طريقته، حتى يتشبع بالحياة حينًا وبالعدم حينًا آخر. غير أن الحكم النقدي الوحيد الذي تخرج منه في إطار تصنيف هذا الشعر، هو أنه الشعر الأكثر حداثة وتجاوزًا، وهو الشعر الذي بلا آباء أو مرجعيات.

وفيما يأتي نماذج منه بترجمة من خالد النجار:
«أنا امرأة/ أأكون الأرض الأم؟ / أنا نصف الكون/ ألا أصير أبدًا كائنًا متكاملًا؟ / أنا الصمت الذي يحيطني/ أنا الحديقة الخاوية/ أسرع زوالًا من غيمة/ أنا نقطة». «أتطلع إلى نيزك/ هو صورة للموت/ ضوء يمحي نفسه/ بعيدًا عن منابته». «الزمن احترق/ لأجل ذلك ظللنا في نعومة الغيوم/ مشدودين إلى السفر الليلي».
جدير بالذكر أن الشاعرة إيتيل عدنان كتبت معظم أعمالها الشعرية بالفرنسية في الربع الأول من حياتها، وقد التقت الشاعر اللبناني الفرنكوفوني الكبير جورج شحادة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حيث بشر وقتها «بولادة شاعرة جديدة ذات دوي مفاجئ وصامت؛ يهبط هكذا في السير المعكوس للمعنى، لكنه يؤديه أكثر مما ينبغي، ودائمًا على صورة بهاء مجهول، أو برق يلمع من النصل الصافي».
أما المربع الثاني من حياتها، فكتبت فيه أشعارًا كثيرة باللغة الإنجليزية استمرت إلى أيام قليلة قبل وفاتها، حررت معها كثيرًا من النصوص الشعرية الأميركية والبريطانية «المغلفة بالمحافظة الصنمية» على حد تعبير الشاعر الأميركي المعروف غريغوري كورسو.
غير أن الشاعرة إيتيل عدنان، في المقابل، لم تنسَ لحظة واحدة أنها شاعرة عربية، وعربية حتى الجمام، لكن باللغتين الفرنسية والإنجليزية. إنه إذًا الاغتراب أو المنفى اللغوي القسري على غرار شعراء مغاربة كبار أصروا على ألّا تُنتَزع منهم هويتهم وأرواحهم اللؤلئِيّة المنتمية إلى مكانها وزمانها، ودائمًا عبر معادلة ذهبية تقول بأن الأدب والشعر يشكلان معًا فنًّا مصفى ومعافى، هو فن أن تكون إنسانًا.

بواسطة أحمد فرحات - شاعر وكاتب لبناني | مايو 1, 2020 | حوار
لعلّ الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث (1914– 1998م) هو الأهم بين شعراء الحداثة/ الرموز في أميركا اللاتينية؛ وقد فرض نفسه على النقد الأوربي والغربي عامة، بوصفه رائدًا من روّاد التجديد الشعري على مستوى عالمي، فضلًا عن أنه المتقن الدائم للإستراتيجية الرمزية للنصّ الشعري المتخفّف من النسائج الغامقة للسيميائيّات؛ ثم إنّ الصورة الشعرية لديه، على غرائبيّتها وسورياليّتها الخصوصيّة أحيانًا، تظلّ تفضي إلى وضوح شعري معجز، وتُمدّد وضوحها المعجز هذا في ذاكرة متلقّيه وقارئيه بعمق، وبخاصة من خلال مطالعتهم ديوانه الشهير: «حجر الشمس».
وعالميّة هذا الشاعر، لم تنطلق في أولويتها، فقط من محليته المكسيكيّة أو الأميركية/ اللاتينية بوجه عام (على غرار نظرائه من شعراء وروائيي ذلك الجزء من العالم الناطق بالإسبانية)، وإنما انطلقت من خلال اندغامه المباشر بالأسئلة الإبداعية الشعرية الأوربية والغربية عامة؛ لأنّ أوكتافيو باث يعد نفسه منتميًا، تاريخيًّا ولغويًّا وثقافيًّا إلى الغرب نفسه، وليس «إلى هذا العالم الثالث الغامض، فنحن قطب من أقطاب الغرب، لكنه قطب منحرف.. فقير وخائب»، على حد تعبيره.
صحيح أنه كتب شعرًا ونقدًا وفكرًا سياسيًّا في موضوعات ومشاهد بحت مكسيكية وبوليفارية عامة، تمسّ وسط القارة الأميركية وجنوبها. وصحيح أنه قاوم الدكتاتوريات العسكرية وغير العسكرية على أنواعها هناك أيضًا. وكانت استقالته من منصبه كسفير لبلده المكسيك في الهند عام 1968م احتجاجًا على المذبحة التي ارتكبتها سلطات بلاده بحق تظاهرة طلابية راح ضحيتها أكثر من 300 طالب في العاصمة المكسيكية، واحدة من أبرز المقاومات العميقة والمؤثرة في هذا الإطار.. صحيح كلّ هذا، لكن شاعرنا كان ينطلق دومًا من هاجس انتمائي سياسي غربي، يناهض عبره الخيار السياسي اليساري، مثلًا، لنظيره الشاعر التشيلي الكبير بابلو نيرودا، ويصفه بأنه «أحبّ الأعداء إلى قلبي» وبأنه «ستاليني متطرّف». وكذلك لسائر الشعراء والكتّاب اليساريين الآخرين في وسط القارة الأميركية اللاتينيّة وجنوبها من أمثال: غابريللا ميسترال وميغيل أستورياس وخوليو كولتازار وغابرييل غارسيا ماركيز، وخوسيه إيميليو باشيكو، وأرنستو كاردينال،… إلخ.
وكان باث قد أفصح في أكثر من مناسبة، حتى في هذا اللقاء الحواري الذي جرى بيني وبينه في باريس سنة 1989م (بواسطة ودفع من الصديقة والناشطة الثقافية الفرنسية من أصل أرجنتيني ليونور غونزاليس، والحوار أعدّ من ضمن سلسلة حوارات مع رموز شعرية وأدبية من أميركا اللاتينية وإسبانيا، ستنشر كلها لاحقًا في كتاب بنسختين عربية وإسبانية) بأنه ليبرالي الموقف السياسي، ومن ثم فهو يناهض مواقف الشعراء والأدباء المنزلقين في التيار الأيديولوجي الماركسي، ولكنه، في المقابل، لا يكنّ عداءً شخصيًّا لأحد بينهم على خلفيّة ما يعتقده كمبدع، وبأنه يعرف، في النتيجة، كيف يفصل بين إبداعيّتهم وبين خيارهم السياسي.
وأوكتافيو باث الذي فاز بجائزة نوبل في عام 1990م، بعد ترشّحه مرارًا لنيلها، ووصول اسمه في أكثر من دورة إلى مرتبة الثلاثة الأوائل على لائحة التصفية النهائية للأسماء، كان في إحداها واردًا اسم الشاعر العربي الكبير أدونيس (كما أخطرني هو شخصيًّا بذلك)، هو في المقابل موضع احترام إبداعي رفيع من الذين يناقضون مواقفه السياسية الليبرالية، ويعدُّونه شاعرًا مميّزًا ومجدّدًا في الفضاء الشعري الأميركي اللاتيني والعالمي، وعلى رأس هؤلاء الشاعران الكبيران: التشيلي بابلو نيرودا، والإسباني رافائيل ألبيرتي.
عقيدته الشعرية
استقى أوكتافيو باث معادلاته الشعرية أو «عقيدته الشعرية» من منظور العدسة الثقافية الأوربيّة، خصوصًا في قراءتها المعمّقة للموروث البشري القديم ممثلًا بالميثولوجيات والملاحم والأساطير والمعتقدات الغابرة. وكل من يطالع كتابه المهم جدًّا: «أطفال الطين»، يكتشف هذه المسلّمة.. يكتشف مثلًا أن مصادر الشعر الحديث لديه، هي الأساطير والأديان القديمة، وخصوصًا كما بدأت تنحتها ذاكرة فريدريش هولدرلن وجيرار دي نرفال، ثم ذاكرة ويليام بتلر ييتس وراينر ماريا ريلكه، من دون أن ينسى، طبعًا، صاحب «الأرض الخراب» ت. إس. إليوت.. فهؤلاء جميعًا وغيرهم، صاروا روّادًا لمن لحقهم من شعراء، عملوا، وبتجاوز مدهش، على اختلاط الواقع بالفانتازيا اختلاطًا عضويًّا.
ومن وجهة نظر أوكتافيو باث، كانت عقائد البشرية الأولى هي القصائد. وسواء كنّا نتعامل مع أحجيات سحرية، ابتهالات، أساطير أم صلوات، فإن الخيال الشعري هو هناك منذ البداية.. إلى أن يقول: إن إحدى الوظائف الرئيسة للشعر، هي أن يظهر الجانب الآخر، عجائب الحياة اليوميّة، ليس اللاواقعية الشعرية، وإنما واقعيّة العالم غير العادية. كما يرى أنّ الشاعر منح الأفكار الدينية القديمة شكلًا قابلًا للإدراك، وحوّلها إلى صور وأحياها؛ فنظريات نشوء الكون والأنساب، هي قصائد تتألق بحضورها وغيابها في آن؛ والشاعر هو جغرافي الفردوس والجحيم، ومؤرخهما معًا: دانتي، مثلًا، وصف جغرافيا العالم الآخر وسكّانه، وملتون روى لنا القصة الحقيقية للسقوط.
من جانب آخر، ينظر أوكتافيو باث إلى العالم من حوله بعين بودليرية، وقد عجن رؤية هذه العين لتصير رؤيته قائلًا: ليس العالم مجموعة من الأشياء، وإنما من العلامات؛ وما نسمّيه أشياء، هو في الحقيقة كلمات. الجبل كلمة، النهر كلمة أخرى، المشهد الطبيعي جملة. ومختلف هذه الجمل في تغيّر مستمر: التواشج الكوني يعني التحوّل الدائم. والنص الذي هو العالم، ليس واحدًا، بل كثير. كل صفحة هي ترجمة لصفحة أخرى، وتحوّل لها، ترتبط هي نفسها بعلاقة مع الأخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية. ويخلص أوكتافيو باث في «أطفال الطين» (أفضل كتاب لديه يستعرض فيه مفهومه للشعر والشعرية) إلى أنّ العالم هو استعارة، يفقد معها حقيقته ليصبح أداة تشبيه. وفي قلب هذا التناظر الكبير يكمن الفراغ.. وستندفع داخل هذا الفراغ، حقيقة العالم ومعنى اللغة معًا، ويختفيان. لكن الشاعر مالارميه، وليس بودلير، هو الذي سيتجرّأ ويحدّق في هذا الفراغ، ويحوّل هذا التأمل إلى جوهر للشعر.

هنا تفاصيل الحوار مع الشاعر أوكتافيو باث:
● سيد أوكتافيو.. هل أنت «مالارميه» أميركا اللاتينية؟
■ أتحفّظ على هذا التوصيف طبعًا؛ لأن الشاعر الجدّي، كل شاعر جدّي، عندما يعجب باجتراحات من سبقه من شعراء كبار، فلأجل تجربته هو في المقام الأول وخصوصيّة هذه التجربة المتدفّقة، وسياديّتها لاحقًا. وعندما أتأمل لغز تجربتي وأجنحة تحوّلاتها في دائرتها، وفي دوائر الآخرين، فإنني أراها أيضًا مخدومة من تجاذبات مصادر وعناصر عدّة، تشتقها هي بنفسها فيما بعد من خلال تفاعلاتها مع هذه المصادر والعناصر، أي مع مشهدية الواقع، مرئيًّا كان أم غير مرئي. فالشاعر إذًا، هو حاصل نفسه في تجليات كل ما حوله، وكل ما يعتريه منها. وهكذا تخرج القصيدة منه فريدة ومتعددة المعاني وذات أبعاد تناظرية تعكس المقدس وغير المقدس فيه.
● وما معنى إشادتك بالشاعر الفرنسي مالارميه، مجترح «قصيدة البياض» في أكثر من دراسة أو مقالة او تصريح لك؟.. ثم إن طبيعة كثير من قصائدك نجدها متخفّفة من أثقال البلاغة على أنواعها، يخترقها الصمت أو البياض كجزء من الكلام، ما يؤكد نزوعك
«المالارميّ» هذا؟
■ أنا من الذين يؤكّدون تجربتي الشاعرين بودلير ومالارميه في الدفع بانفجار تجارب الحداثة الشعرية على مستوى أوربا والعالم. إنهما شاعران كبيران ومؤسّسان للشعر المرن، والقاطع، والذكي والمتضمن عتادًا جديدًا من الرموز والإشارات. غير أن الإشادة بهما أو غيرهما من شعراء كبار، لا تعني، في المقابل، السير على منوالهما؛ لأن في ذلك «إساءة» لهما قبل «الإساءة» إلى من يروم تجربة جديدة تضيف إلى الإبداع الشعري في العالم إبداعًا مغايرًا، يؤكّده ويغنيه.
لكن هذا لا يعني، على مستوى آخر، تجاهلًا لتجارب أساتذتنا العظام في الشعر، وعلى رأسهم بودلير ورامبو ومالارميه في فرنسا؛ وخوسيه مارتي وروبن داريو (بوابتا حداثة الشعر في أميركا اللاتينية) وميغيل دي أونامونو، وبيدرو ساليناس وخوان رامون خيمينيث وغيرهم.. وغيرهم في العالم الناطق بالإسبانية؛ فهؤلاء جميعًا تحوّلوا إلى عصارة شعرية فينا. إنّ لهم تأثيرهم وسحرهم فائق الخصوصية، على الأقل لي. لكن هذا كلّه، أكرّر، لا يعني أن عليّ أن أسلك خطوط رؤيتهم باتّباعيّة شعرية ونقدية ذاتية… إلخ.
وليس يخفى أن مسألة ما يتركه الآخرون فيك من أثر، هي أيضًا مسألة شائكة ومعقدة، وينبغي الحذر منها باستمرار، خصوصًا عندما نتكلّم على عوالم الشعراء/ العلامات في التاريخ الشعري والنقدي العالمي، فالشاعر بطبيعة الحال، هو جديلة متناقضات، وهو حصيلة أنوثة اللغة وعذوبتها وتضاريس تحوّلاتها.. ودائمًا عندما يستقل شاعر بصوته الشعري الفريد والمغاير عن الآخرين، ممن سبقوا وممن لحقوا على السواء، يظهر تمامًا مثل نهر خرج عن مجراه فجأة.
● ومع ذلك لم تعلّق بما فيه الكفاية على انعكاس تجربة مالارميه عليك، تراني أشدّد على «المسألة المالارمية» هذه، لأنك «أنواريّ» في قصيدتك والبياض ينبض فيها كالصاعقة الداخليّة المفارقة؟
■ ناقدنا المكسيكي إدوارد ميلان، هو أول من تحدّث عن «الحال الأنوارية» في شعري، أي عن وظيفة الضوء في خلايا الكلمات التي أجترِحُها، وباتت تشكّل الأغلب الأعمّ من بِنَى قصائدي. ولقد مسّ كلامه هذا، وبحدود ما، نقطة السحر المالارميّة الساكنة في اللاوعي الشعري عندي. فأنا ممن يرومون جعل اللغة ألفاظًا لؤلئية مقتصدة، تُكوّن بدورها نصّي الشعريّ، وخصوصًا القصير أو المكثف منه، الذي هو، دائمًا، نتاج الرياضيات الروحية والعقلية التي لا حدّ لمساحاتها التفاعليّة فيّ، حيث ينتقل هذا النص، بُعيد ذلك، من فراغ جائع إلى فراغ جائع آخر ليلدغه، ويحوّل القصيدة بالتالي إلى ضوء يرتجف بين الموت والرجاء. وهذه الحال بنتيجتها، شبّهها الناقد ميلان بما يسمّى «الاحتضار الأبيض» عند مالارميه.
● يقال: إن الموت، هو قمّة الجمال عند مالارميه… «هو ما لا أبلغه وأنا أموت، وأنا أفقد شخصي وأصبح ما قد يكون أنا، من دوني»، كما يعبّر بذلك مخترقًا عمق الطمأنينة فيه وفي الآخر.. ما تعليقك؟
■ كما تعرف، فإنّ الشاعر مالارميه ينتمي إلى تيار الرمزية، أو بالأحرى هو أحد روّاده الكبار، ولكن ببراعة ذات حماسة «فطرية» غير متحذلقة… براعة تبني على الصمت، أو على المسار السيميّائي التأويلي للصمت (أو البياض)، الذي يستهدف في النتيجة نقاء الماهيّة القابع فيه: الموت، حتى لو هبوطًا في السير المعكوس نحوه، أو وهو متجه آليًّا في«الدرب الصحيح» إليه. وعندما يقال: إنّ قمة الجمال عند مالارميه هي الموت، فهذا من منظوري يؤشر إلى أن الشاعر يتيح المهاد أمام البشر كي يتحرروا من «الحياة أولًا»؛ لأن الشعر هو التحرر من كل شيء، بما في ذلك الشعر نفسه.
● بعيدًا من الميتافيزيقا وعقدتها المستحكمة فينا، ماذا تقصد بكلامك أعلاه؟ هل تقصد أن مالارميه يؤشر إلى مكامن الخصب في الروح البدئي، الذي يؤهّله على ما يبدو لتحدّي كل شيء، بما في ذلك الموت نفسه؟
■ أقصد ان الشاعر في مالارميه يبقى دومًا تحت طائلة التناقض الذي يترسّم خطاه فيه، بوعي منه أو من دون وعي. هو إذن شاعر دراما الفكرة لا مفكّرها غالبًا. تراه يهبط إلى الأعماق التحتية لتنكشح له الأضواء كلها. وعندما يتأتّى له ذلك، تنتفي الرؤية لديه لتستحيل «شأنًا» آخر، هو في واقعه عقم مموه؛ لذلك كان مالارميه سيّد التجريب بلا هوادة. يبني على إيحاء البياض، كما يبني على سواد الكلام، الآفل بدوره نحو المحو الكبير: الموت.
فلسفة الصفاء الخالص
● الصمت أو البياض، هل هو جزء لا يتجزأ من الكلام أو التعبير ببعديه: البطيء أو الصارخ؟
■ بالتأكيد، إن مالارميه في المحصّلة، قدّم شعر «المعرفة الفلسفية»؛ وقد أراد بعمله هذا أن يحدث فتحًا في باب الإدراك عينه، هذا الإدراك الباحث بدوره عن فلسفة الفن الخالص أو الصفاء الخالص، الذي ظلّ معه مالارميه يزاول كتابة الشعر من مرتكز فلسفي يقوم على موقف من الحياة والوجود. وانا مع القائلين بأن صاحب «النرد» كتب بتعابير تبشر بما كتبه آخر الفلاسفة الكبار: هايدغر، وخصوصًا عندما قال (أي هايدغر): إن المستقبل، ليس أبدًا إلا بريق ما كان يجب أن يتمّ سابقًا أو قريبًا، من الأصل.
وأهم ما في مالارميه بعد، أنه كان يعيش حياة متطابقة مع شعره، أو مع وعيه المرهق بالظلال الداخلية.
● يقال: إنّ مالارميه مهّد لظهور الدادائية والسوريالية.. أنت ماذا تقول؟
■ نعم، مهّد مالارميه للدادائية والسوريالية، عبر «إرادة» شعرية كانت تغمره وتملؤه على هواها هي، وليست على هواه. وكانت دومًا هذه «الإرادة» مثل «بهاء مجهول» التقطه الآخرون فيه من خلف رؤوسهم. وهو في مجمل أعماله الشعرية، كان ينادي المستقبل بصرخات مديدة، حتى لو كانت متقطّعة. كان يكشف عن هوية شعرية تشتبك مع لهفتها، لتتعجّل ضيافة العدم كما هو. نعم، كان مالارميه، وانطلاقًا من غموض الحاضر، يخوض صراعًا ذاتيًّا على امتلاك المستقبل، ولم يكن يقف بينه وبين مقصده هذا أيّ حاجز لغوي أو عقديّ. حدثني مرة صديقي أندريه بروتون عن أن مالارميه علّمه، من خلال قراءته لشعره، أن الشعر ضرورة داخلية حرّة قبل أن يكون أي ضرورة أخرى ملحّة. ومن هذا «الاعتراف البروتوني»، الذي سمعته وكنت شاهدًا عليه، أستنتج، وربما يستنتج الكثيرون معي، أن الشاعر مالارميه، كان بوابة الدادائية والسوريالية. ويكفي حتى الآن – أيها الصديق المحاور – أن شعر مالارميه، هو مثل الزمن الذي لا يسقط في الزمن.
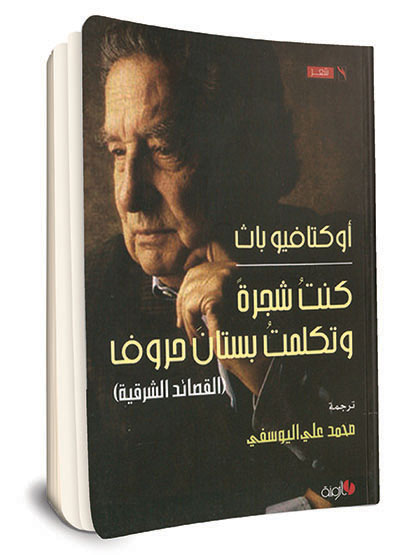 ● كيف انجذبت يا سيد باث إلى السوريالية وجعلتها هكذا تدخل تفاصيل بنى الكثير من قصائدك وعلاماتها، على الرغم من أنها حركة منحسرة؟
● كيف انجذبت يا سيد باث إلى السوريالية وجعلتها هكذا تدخل تفاصيل بنى الكثير من قصائدك وعلاماتها، على الرغم من أنها حركة منحسرة؟
■ السورياليون قاموا بأعظم ثورة أدبيّة في القرن العشرين. لقد أثبتوا، كما صرّحت مرارًا وتكرارًا، أن الشعر هو طريقة في قراءة الأعماق، مشحونة بالمعنى والقيمة للحرية المسنونة، كما تتمظهر في قصائدهم المقتلِعة لكل شيء، حتى لنموذجها. وأكاد أجزم بأن السوريالية هي التي ابتكرت «مسألة الشاعر» في القرن العشرين، وهي التي أعطته هذه السلطة القوية التي تمحق كل ما قبلها، وما جاورها، بشكل أو بآخر.
نعم، استفدت من السورياليّة، ولكنني لم أدخل يومًا في «يوميات» و«طرائق» و«سلوكات» شعرائها؛ فهي التي حرّرتني كشاعر فاض عقله باليأس والقنوط المزمنين، فضلًا عن أنها شَفَتني من مرض الجدران أو القواعد الوهميّة اليومية والوجودية التي تقف قبالتي كفرد. وحين كنت أقرأ للسورياليين الأوائل (وما زلت أقرأ لهم بحماسة، ولن أتوقف يومًا عن قراءة نصوصهم)، كنت أصرف النظر عن إعطاء أي معنى إستراتيجي لحياتي عبر هذه الحياة، إذ إنّ حياتي الشخصية كانت، وما زالت، من خلال ديناميت الشحن السوريالي، تفرّغ حمولاتها بابتسامات لا تفارق ألوان سخرياتها، وهي تتجه إلى القبض على معادلات الممكن – المستحيل.
هكذا إذًا، عندما يزجّك العالم في مسرح «خرابه الأبدي»، فما عليك إلا بالسوريالية كدواء تقاوم عبره كل شيء، وتنتصر -وترتاح- على كل شيء، وتختفي منك حتى غصّة الإفصاح.
● يقول أحد مترجمي أشعارك إلى العربية، وهو اللبناني هنري فريد صعب أنك تظل ابن السوريالية الراضعة لروح الهنود الحمر المقدسة، سكان المكسيك القدماء من جماعة المايا والأزتيك.. فبمَ تعلق؟
■ أعتقد أن استنتاجه في محله، ويبدو أنه صاحب حاسّة شعرية ملتهبة بالشعر والتاريخ القديم معًا. نعم، أيها الصديق العربي المُحاور، لا يمكن لشاعر مثلي أن يغفل تراثه المكسيكي الغني والعظيم جدًّا، حتى لو تقصّد ذلك، فأجدادي قوم المايا والآزتيك متغلغلون فيّ بالفعل، مذ تفتّح وعيي على العالم حتى اللحظة. إنهم سكنوا، وما زالوا يسكنون، أقاصي اللاوعي فيّ.. لقد تحدثوا عن شكل آخر للزمن وبلوروا جوهرًا لهم فيه، وعلموني ذلك أحسن تعليم.
وعلى الرغم من اندفاعي المستمر نحو التجديد الشعري، فإنني ما تخليت يومًا عن إغواءات حكايا أشعار أجدادي، وأساطيرهم، وسحر أسرارهم، ودقة أبعاد حسابات علومهم. إنهم أجدادي إذًا، وانا أتنفسهم كالهواء وأشربهم كالندى الصباحي كل يوم.
● وعلى صعيد مجريات الكتابة ومضامينها الشعرية؛ أي إضافة منحتها لك السوريالية؟
■ على صعيد الكتابة الشعرية، منحتني السوريالية -وقد تستغرب ذلك- شجاعة تدوير الإنتاج لخلاصات تاريخ جنون الغرائز، التي بلورتها فوضى أرواح أجدادي المكسيكيين في ذاكرتي، تلك المهندسة بمنطق نفسها كأرواح ناطقة، وعبر لغة شعرية صارت تلبّي بيسر، الإغواء الذهني، الذي لا يخبو فيّ تجاه هؤلاء الأجداد.
بفضل السوريالية، نعم، تحوّلت لغتي الشعرية إلى مسكن متدفق ومحصّن ضد مختلف الغائيّات الكامنة والمستنفرة فيّ على السواء. كما أن السوريالية أبعدتني عن أي دويّ خطابيّ خادع، ورفعت في داخلي هجمة دقة الحواس إلى أعلى الدرجات. وبفضلها أيضًا، صارت لغتي في القصيدة أكثر اقتصادًا وأبعد مدى متراميًا على فراغات العالم.
● هل تحدثنا عن اختلاطك بالسورياليين في باريس، خصوصًا أنك أقمت سنوات طويلة في هذه العاصمة التي قدمت للثقافة في العالم الشيء الكثير، إبداعًا ونقدًا؟
■ لم أكن مواظبًا على اجتماعات السورياليين في باريس، ببساطة لأنني لست منتميًا إلى حركتهم وسياق حراكهم الشعري والتنظيري، وإن كان لديّ علاقات ثقافية وطيدة ببعضهم، ولا سيما الشاعر والمنظّر و«الممنهج» العام للحركة السوريالية: أندريه بروتون. وقد رأيته كخلاصة، شخصًا عصبيًّا وهادئًا في الوقت نفسه.. كان يجهر بالثورة السوريالية ويتقنّع استبطانًا بها أيضًا. سألته مرة: كيف يوازن بين حريته المطلقة كشاعر، من داخل ومن خارج، وبين انتظامه في المسؤولية عن الحركة السوريالية التي تتطلب شخصية منظمة ومدبّرة في الإجمال.. أجابني: إنه لا يدري أحيانًا كيف تسير الأمور معه، ومع من حوله من شعراء: «كنا، مثلًا، نطرح أمورًا تتجاوز الفهم والإفهام، نطرحها على سبيل التوضيح، لكن التوضيح غالبًا ما يأتي لاحقًا، ومن دون أي إشكال أو احتجاج».. هكذا كان جوابه وصمت فجأة.
● هل تعرفت إلى سورياليين غير أندريه بروتون؟
■ نعم التقيت بالعديد من السورياليين، وكان بعضهم بارعًا في الكلام بغير كلام، مثل بنجامان بيريه وجوليان غراك وماكس إرنست. وكنّا نخوض في لجج كلام حول الشعر والأدب والفن دونما نظام أوانتظام، ومن خلال صور ومفاهيم قابلة للإدراك والتأويل الدائمين. وكانت الأخيلة الشكيّة هي الحاكمة في النتيجة. وغالبًا ما كنت أحس معهم أن الوهم هو العالم الممكن، وهو الواقع الفعلي والحقيقي، وأن الثورة في هذا العالم قائمة و«دائمة»، لا لشيء إلا لأن الثورة -حتى بنتائجها- هي فكرة وصورة في المقام الأول والأخير.
● حدثني ناقد ومسرحي لبناني كبير اسمه عصام محفوظ، وضع كتابًا مهمًّا عن السورياليين العرب تحت عنوان: «السوريالية وتفاعلاتها العربية».. حدثني عن أنك التقيت الشاعر والمسرحي الفرنسي الكبير جورج شحادة (من أصل لبناني وهو صديق حميم لمحفوظ)، فهل نملك أن تحدثنا عن هذا اللقاء بينكما؟
■ نعم التقيت الشاعر والمسرحي جورج شحادة، وهو شخصية إبداعية مثيرة لي. كنت أحسه نتاج ثقافة غربية– شرقية (عربية على وجه الخصوص) لا تتخلى البتة عن هذه المعادلة التي تؤلفه، وذلك على الرغم من انتمائها العضوي للثقافة الغربية وشجرة الإبداع الغربي في عصبها السوريالي؛ إذ عرف شحادة كيف يكون شاعرًا سورياليًّا على هواه، وكذلك في مسرحه الشعري المميز؛ فلقد قرأت له بشغف مسرحيته الشعرية: «مهاجر بريسبان» وصنّفته من فوري في مصاف الكبار: يونيسكو، بيكيت، آداموف وغيرهم؛ فقد كان مثلهم يستحم بالمعاني استحمامًا، خصوصًا في إهابها الشعري، وفي ما قبل العقل أو وراءه. كان شحادة مبدعًا يؤثر الصمت والكلام المهموس على ما عداه. كان باختصار سحابة خفيفة تغطّي الأشياء، ثم تبدأ بهدمها لأجل التجريب بها وجعلها، في النتيجة، تنهمر كالنعيم انهمارًا.
أشباح نيرودا الشعرية
● قلت مرة: إنك تأثرت ببابلو نيرودا، واستمعت إلى نصائحه النقدية، حتى السياسية المتعلقة بمناهضة الدكتاتورية، ثم انقلبت عليه؛ هل نملك أن تحدثنا عن هذا الشاعر الذي وصفه مرة غابرييل غارسيا ماركيز بـ«أعظم شاعر في القرن العشرين»؟
■ ومن منّا كشعراء في أميركا الناطقة بالإسبانية وخارجها، لم تجتحه ظاهرة بابلو نيرودا الشعرية؟!. عشنا جميعًا، تقريبًا، أشباحه الشعرية، وبُهِرنا بها. وفيما يتعلق بي شخصيًّا، لم أشذّ أنا عن شبكة هذا الانخطاف الشعري به، لكنني كنت ولم أزل على خلاف مع خياراته السياسية، التي دمغت الكثير من جوهر قصائده وأبنيتها. وهذا لا يعني أنني لم أشاركه المواقف المناهضة للدكتاتوريات في قارّتنا، وخارج هذه القارة، بل كنت ولا أزال على حماستي ضد كل ألوان الاستبداد السياسي والعسكري وقمع الحريات، لكنني لم أذهب، على غرار بابلو نيرودا، إلى الأيديولوجيا لتحدّني، وتمنهج أفكاري، وتسيّرني إبداعيًّا كما تشاء هي، لا كما أشاء أنا. وكنت أتمنى على نيرودا ألا يكون مخطوفًا بالأيديولوجيا الماركسية، أو بغيرها، وإلا كان بالتأكيد أعطانا نتاجًا شعريًا أعمق وأغنى بكثير مما أعطانا.
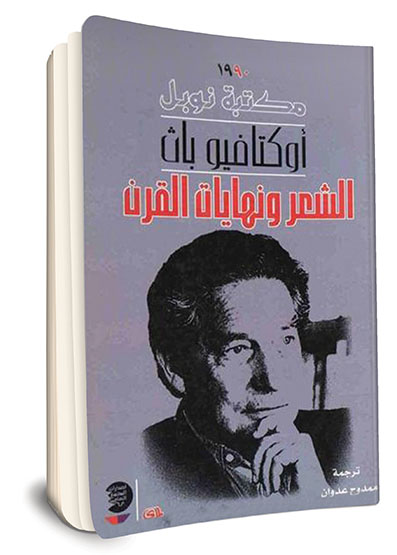 ● مهلًا يا سيّد باث مهلًا، بابلو نيرودا وفي الكثرة الكاثرة من قصائده، لم يكن أسيرًا لأيديولوجيته الماركسية، ولم تشكّل له هذه الأيديولوجيا أي كابح يحول دون تحليقه شعريًّا في مناخات حرة بذاتها ولذاتها..
● مهلًا يا سيّد باث مهلًا، بابلو نيرودا وفي الكثرة الكاثرة من قصائده، لم يكن أسيرًا لأيديولوجيته الماركسية، ولم تشكّل له هذه الأيديولوجيا أي كابح يحول دون تحليقه شعريًّا في مناخات حرة بذاتها ولذاتها..
■ أنا أتكلم على مناخ خاص يتعلق بالشاعر نيرودا نفسه، الذي اكتشفته فيه شخصيًّا، وفي نصوص شعرية كثيرة له أيضًا، ولم أقل: ليس لديه نصوص بمناخات شعرية حرّة ومتميزة، تفد إليها المعاني وترتحل، تتقدم وتغيب، تعلو وتهبط على أرض مشاعية شعرية «محايدة»، لكنك لو دققت فيها بالتحليل والنقد، لاكتشفت أيضًا أنك في قلب خطاب شعري مؤدلج واحد، وإن بتعددية مناخات.
● وهل على الشاعر أن يكون بلا موقف فكري، أنت الشاعر الذي يشدّد على القول باستحالة الفصل بين التفكير والإبداع؟
■ وهل قرأت «النشيد الشامل» لنيرودا؟ أنا قرأته، ولو كنت محلّ نيرودا، لما غامرت بنشر كتاب ضخم، أو على الأصح متضخّم، كهذا. فهو قادني، أنا المختص بالقراءة الأدبية والشعرية والنقدية، إلى شيء كثير من الملالة والمناخات التي لا طائل من تكرار ألوانها. باختصار، مارس بابلو نيرودا كعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيلي شعر الدعاية السياسية على حساب شعر المغامرة الشعرية، وإعادة تأليف الذات الإبداعية كمعادلة مادية وحسية للوجود من خلال الشعر واستشفافاته في كل أمر.
● طبعا قرأت «النشيد الشامل» بمقاطعه الـ15 لنيرودا ووجدت فيه، كما وجد فيه كثيرون، عملًا شعريًّا ملحميًّا بامتياز؛ لكونه يتألف من عناصر مختلطة بالأفكار التاريخية والأسطورية والمادية والميتافيزيقية، فضلًا عن سرديات الحب والعشق والتأمل الشخصي في الطفولة والطبيعة والكون.. ويتضمن «النشيد الشامل» قصائد بارعة في سحرها الشعري الخالص، على غرار «مرتفعات ماتشو بينشو» و«زهور البونيتاكي» مثالًا لا حصرًا.
■ ولكن نيرودا في «نشيده الشامل» يتحدّث أيضًا بلغة سياسية صريحة عن عالم العمّال ونضالاته لأجلهم وحبه السياسي لـ«إسبانيا الشهيدة».. وفي كل الأحوال لا مانع لديّ من اختلاف القراءات وتباينها.. (يبتسم أوكتافيو باث، ثم يتابع قائلًا): لا إكراه في الشعر، ولا في السياسة أيضًا، وإن كنت أعرف أنك لست على نهج نيرودا سياسيًّا.. (ويعطي إشارة منه محبّبة ولطيفة تقضي بضرورة تجاوز النقاش في مسألة نيرودا).
نجومية لا تزال تتألق
● ما الذي تعنيه لك تجربة شاعر و«سياسي» كبير مثل فريدريكو غارسيا لوركا، تمكنت الدكتاتورية الفرنكوية من التخلص منه، بينما طارت شهرته في العالم أجمع كشاعر ومسرحي عظيم؟
■ لوركا جزء لا يتجزأ من الإبداع العالمي العظيم باللغة الإسبانية. هو بلا شك شاعر كبير، وبكل المعاني المؤسّسة لإبداعية الشاعر الكبير، ورمزيته. ويلفتني في نتاجه الإبداعي المتنوع، ديوانه «شاعر في نيويورك» الذي تعود كتابة قصائده إلى عام 1929م عندما سافر لوركا إلى نيويورك، وقضى هناك خمس سنوات اصطدم فيها بالعالم الجديد أو بالحداثة الرأسمالية المفرطة، فانقلب أسلوبه الشعري، من غنائي موشّح بالرومانسية إلى أسلوب سوريالي له طعم الدراما والتوتر الكياني. وقد ازداد شعره الجديد تطورًا وقوة حضور، عندما قرأ للشاعر الأميركي والت ويتمان وتأثر به، وخصوصًا ديوانه «أوراق العشب».
كما تفاعل لوركا في تلك المرحلة مع أشعار ت. س. إيليوت، وكذلك مع النتاج الشعري الإسباني الحديث والمتنوع لـ«حركة جيل 27» وشعرائها الكبار أمثال: داماسو ألونسو وبيثنتي ألكسندري وخيراردو غونغورا وأنطونيو ماتشادو وخوان رامون خيمينيث… وغيرهم، ممن صاغوا الرؤية الشعرية الانقلابية في بنية القصيدة المكتوبة بالإسبانية. ومن فرط تطور تجربته الشعرية وسحر فرادة أجوائها وصورها الجذابة النادرة، تفوّق الشاعر لوركا على الكثير من رادة الشعر باللغة الإسبانية نفسها، وحقّق نجومية لا تزال تتألق حتى اللحظة «بإرادتها الإبداعية» واتساقها مع نفسها.
● وكيف تنظر إلى تجربة خورخي لويس بورخيس السردية والشعرية والنقدية وتأثيرها في الأجيال الشعرية والأدبية الراهنة في العالم الناطق بالإسبانية؟
■ بورخيس حالة فريدة مركّبة، شخصًا وإبداعًا. لديه نظام خاص من القلق جعل أدبه لا يخضع إلى تصنيف نهائي. فهو شاعر على هواه، وقاص على هواه، وصاحب مهارات كتابية تراكمية جاهزة للتبيؤ ضمن ما يمكن أن يُسمى: وحدة الأدب. تراه يتطور على طبيعته في المكان والزمان والشطح بالأخيلة والصور والأفكار والرؤى والتراكيب الأسطورية. ومن هنا هو فرض نفسه وسحره الخصوصي على الآخرين، من غير أن يترك ورثة له، لا في الأدب المكتوب باللغة الإسبانية، ولا في الآداب العالمية المركزية الأخرى؛ إذ إن بورخيس تحوّل إلى ظاهرة أدبية عالمية.
● كيف تكتب قصيدتك أنت يا سيد أوكتافيو؟ هل لديك طقوس معينة ممهدة لكتابتها؟
■ منذ زمن طويل وأنا أكتب قصيدتي، بدافعٍ غامض لا أدري ما هو بالضبط، وكيف يدفعني؟ ولماذا؟ على ما يبدو، فإن الشعر يكمن ويتخفّى ويفاجئ وينفجر في كنز لغة الشاعر في ما بعد، وهو لا يُنال مباشرة، إنما بالتمرحل والتقصّي.. ثم إنني لا أعرف حتى الآن، كيف ستكون عليه قصيدتي (وأنا أكتبها)، اللهم إلا بعدما أنجزها وأقرؤها مكتوبة، فالقصيدة دائمًا، هي مصادفة واحتمال حدوث… أكثر من ذلك، ليس هناك شيء اسمه قصيدة من تلقاء ذاتها، بل هناك قصيدة فيك أو فيّ أو في الآخر، ودائمًا الشاعر يتغشّاها فيه أولًا، فلا تكاد تقيم هذه القصيدة فيه حتى ترتحل.
● كيف تفهم علاقة القصيدة بالزمن والتاريخ؟
■ القصيدة هي نقطة حدث في الزمن، وكذلك، بمعنى مشابه، هي حالة معينة في التاريخ. هكذا أفهمها أو أمتصّ نسغها بعد أن تتشكّل بقامتها متفاوتة الحجم عندي أو عند غيري من الشعراء. وسرّ قوة القصيدة ودواميتها من وجهة نظري، هو في بقائها مثل شعاع له هتافه الخصوصي المتجدّد، والجاذب بسحره للجيل القرائي الراهن، كما للأجيال القرائية اللاحقة كافة.
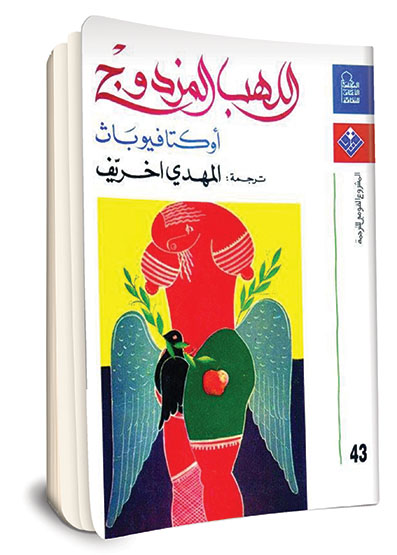 ● يقال: إنّ الشعر هو المعرفة الأخرى.. فما هو مفهومك للمعرفة في الشعر؟
● يقال: إنّ الشعر هو المعرفة الأخرى.. فما هو مفهومك للمعرفة في الشعر؟
■ بما أن القصيدة، هي النصّ الذي يهتك كل الأقنعة والأطر الثقافية والمعرفية المبذولة وغيرالمبذولة، وبما أن النصّ هو نتاج للواقع ممزوجًا باللغة الاستثنائية الحاملة له، فإن صانعه يصرّ، بما يدفع به من مضمون فكري أو فلسفي أو أدبي أو معرفي علمي مشاكس، على عدم المخادعة والتزيّي والإيهام، حتى لو حمل النصّ، أو صاحبه، أوجهًا منها. هكذا فالنص الشعري، وبجدارة، يتحوّل بمداليله البرقية الخاطفة إلى المعرفة المتقصيّة وراء المعرفة، التي غالبًا ما تنبو وتتعالى، حتى على التمييز والتصنيف… والرسوخ بذاته.
● لماذا برأيك يطرح الشاعر نفسه كأب كوني للبشرية جمعاء… حتى للكون نفسه؟
■ ولمَ لا يطرح نفسه كذلك؟ ما المانع طالما أن لديه كنز الأسئلة المفتوح على ذلك، ومن خلال هوية الشعر، الأقوى والأرسخ من أي هوية فلسفية أو معرفية أخرى؟
● أي أسئلة معرفية شعرية كبرى هذه التي تتحدث عنها؟
■ الأسئلة البيضاء والزرقاء والصفراء، التي تلتهب بها القصائد.. أسئلة معموديّة النار البيضاء، التي لا يراها غير الشعراء الأدلّاء والنبوئيين، وقد طرحها هيرودوت (المؤرخ الشاعر في نظري) غير المسيحي، طبعًا، منذ خمسة وعشرين قرنًا، لكنه لم يشعلها، بل ترك التيه فيها يتحدث عن نفسه، ولكن بمظهر زلزالي تراجيدي، وآن الأوان للشعراء في هذا الزمن، والذي سيليه، أن يقدموا «أسئلة المعرفة» على شكل إجابات شفّافة، مرئية، أو متخفية، أو حتى، وهي ما زالت تسيل في بطن نفسها، منتظرة اكتشاف الشاعر لها، وإطلاقها على نفسه وعلى الملأ في آن… أجل على الشعراء ألا يكونوا سجناء أي شيء بعد الآن.
● أرى لديك ميلًا جارفًا نحو الصوفية، خصوصًا في تجربتك الشعرية الأخيرة… هل هذه نهايات الأشياء فيك، التي يفرضها التقدم في السن، أم لدواعٍ أخرى غامضة، ولا رادّ لسلطانها؟
■ قاربت التصوّف أيها الصديق العربي، ليس من باب الوادي الجنائزي التقليدي إياه وإنما من بوابة أخرى نقيضة له تمامًا… من بوابة من يعيد افتراس الضوء بالضوء لأجل التألق بغيابي، كما أنا متألق بحضوري الآن، وعلى حساب كل المشاعر المكبوتة والمستكرهة التي عبرتني ذات يوم.
ملاحظة لا بد منها:
كان يفترض بهذا الحوار الذي ننشره للمرة الأولى في «الفيصل» أن يكون منشورًا في كتاب أُعِدّ للنشر بالتعاون مع إحدى دور النشر اللبنانية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ويتضمن جملة دراسات نقدية تحليلية وحوارات أدبية كنت أجريتها شخصيًّا في باريس (خصيصَى للكتاب طبعًا وليس لأي صحيفة أو مجلة) مع شعراء وكتّاب كبار من أميركا اللاتينية أمثال: أوكتافيو باث، وخورخي لويس بورخيس، وخوليو كولتازار وغيرهم.
ولما لم تتمكّن الدار من نشر الكتاب الموعود؛ بسبب إقفالها وهجرة أصحابها من لبنان نهائيًّا إلى الخارج، وتخليها عن مهنة النشر والتوزيع، عادت فتنازلت لي مؤخرًا، وبعد سنوات طويلة، عن حقوقها في نشر مضامين الكتاب من دون أي موانع قانونية. ولأن «الفيصل» منبر ثقافي جدّي، متميّز ومرموق، فقد خصصته بهذا الحوار الاستثنائي والتاريخي مع الشاعر المكسيكي الكبير أوكتافيو باث (نوبل للآداب 1990م)، وهو ينشر الآن للمرة الأولى عربيًّا وعالميًّا.


 لا شك أن إيتيل عدنان تفاعلت مع هذه المقولة الأثيرة لكاندينسكي واستوعبتها في الصميم، ولكن بعدما كانت قد خاضت في فن التجريد سنوات طويلة قبل قراءتها لها حسبما أفادتني هي بذلك. وعليه هي بدأت بالرسم كتجربة إبداعية ثانية بمعزل عن هذه المقولة، وذلك بعد خوضها تجربة الكتابة الشعرية كتجربة أولى، ولا تزال في عز خوضها لها حتى الآن، ولم تتنازل، بالتالي، عن القصيدة البتة لمصلحة اللوحة.
لا شك أن إيتيل عدنان تفاعلت مع هذه المقولة الأثيرة لكاندينسكي واستوعبتها في الصميم، ولكن بعدما كانت قد خاضت في فن التجريد سنوات طويلة قبل قراءتها لها حسبما أفادتني هي بذلك. وعليه هي بدأت بالرسم كتجربة إبداعية ثانية بمعزل عن هذه المقولة، وذلك بعد خوضها تجربة الكتابة الشعرية كتجربة أولى، ولا تزال في عز خوضها لها حتى الآن، ولم تتنازل، بالتالي، عن القصيدة البتة لمصلحة اللوحة.



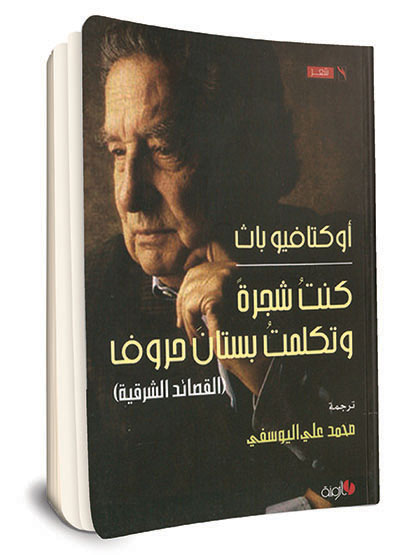 ● كيف انجذبت يا سيد باث إلى السوريالية وجعلتها هكذا تدخل تفاصيل بنى الكثير من قصائدك وعلاماتها، على الرغم من أنها حركة منحسرة؟
● كيف انجذبت يا سيد باث إلى السوريالية وجعلتها هكذا تدخل تفاصيل بنى الكثير من قصائدك وعلاماتها، على الرغم من أنها حركة منحسرة؟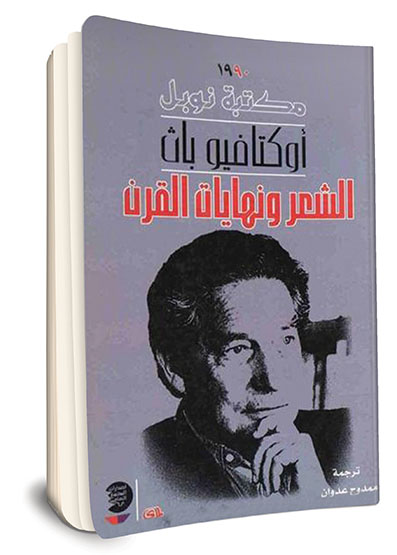 ● مهلًا يا سيّد باث مهلًا، بابلو نيرودا وفي الكثرة الكاثرة من قصائده، لم يكن أسيرًا لأيديولوجيته الماركسية، ولم تشكّل له هذه الأيديولوجيا أي كابح يحول دون تحليقه شعريًّا في مناخات حرة بذاتها ولذاتها..
● مهلًا يا سيّد باث مهلًا، بابلو نيرودا وفي الكثرة الكاثرة من قصائده، لم يكن أسيرًا لأيديولوجيته الماركسية، ولم تشكّل له هذه الأيديولوجيا أي كابح يحول دون تحليقه شعريًّا في مناخات حرة بذاتها ولذاتها..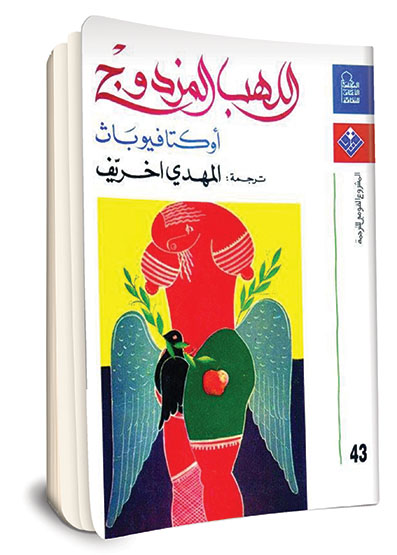 ● يقال: إنّ الشعر هو المعرفة الأخرى.. فما هو مفهومك للمعرفة في الشعر؟
● يقال: إنّ الشعر هو المعرفة الأخرى.. فما هو مفهومك للمعرفة في الشعر؟